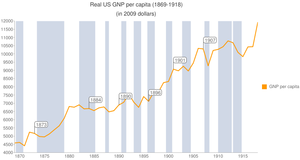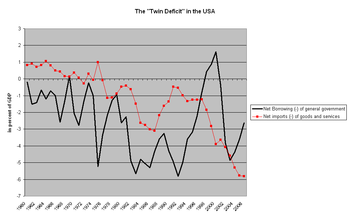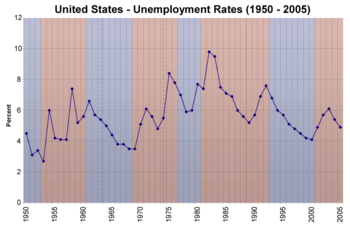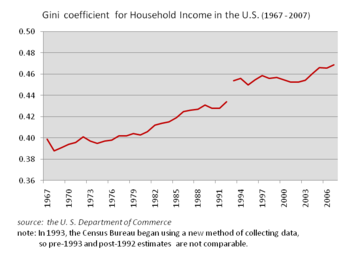التاريخ الاقتصادي للولايات المتحدة 1860-الحاضر
الجزآن الأول والثاني:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجزء الثالث: العملاق القادم
مقدمة: مرحلة انتقالية: الحرب الأهلية
كانت الحرب الأهلية الأمريكية كبرى الحروب التي شهدها العالم الغربي في القرن الفاصل بين معركة واترلو - التي وقعت في 18 يونيو 1815 - والحرب العالمية الأولى في 1 أغسطس 1914. لقد انتقلت القوات – التي انتشرت في مساحة تعادل نصف القارة – بالسكك الحديدية وتلقت أوامرها بالتلغراف ، أما الناس فاستلقوا الأخبار من الصحف التي كانت توزع على نطاق واسع ، كما كانت هذه الحرب أيضا أول الصراعات الكبرى التي تندلع في عصر الثورة الصناعية.
كانت الخسائر البشرية غير مسبوقة ، ففي يوم واحد – 17 سبتمبر 1862 – بلغت الخسائر في صفوف جيش الاتحاد في معركة أنتيتام 2108 قتلى و9549 جريحا. لقد تجاوزت هذه الخسائر البشرية تلك التي لحقت بجيش الولايات المتحدة في حرب المكسيك كلها، والتي دامت سنتين. وتجاوز العدد الكلي للقتلى العسكريين على كلا الجانبين المتحاربين – وفق الرقم الرسمي 495.333 – نحو 3 في المائة من عدد السكان الذكور في الولايات المتحدة في العام 1860 ، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف النسبة المئوية لخسائرنا في الحرب العالمية الثانية.
ولأن الحرب الأهلية كانت أشبه كثيرا بالصراعات العظيمة التي وقعت في القرن العشرين ، مقارنة بسابقاتها كالحروب النابليونية ، فقد واجه كلا الطرفين ضغوطا على خزانة الدولة واقتصادها لم تواجهها أي أمة أخرى على مر التاريخ. إن حقيقة أن الشمال – باقتصاده الأكبر حجما ، وبنظامه الضريبي الحكومي القائم آنذاك – كان قادرا ، على نحو أفضل – على مواجهة تلك الضغوط ، لم تؤد سوى دور محدود في صياغة النتيجة النهائية للحرب.
وبسبب الكساد الذي بدأ في العام 1857 بلغ الدين القومي 64.844 مليون دولار ووصلت الخزانة إلى شفير الإفلاس. وفي ديسمبر من ذلك العام ، في وقت بدأت فيه ولايات أقاصي الجنوب الانضمام إلى الاتحاد الأمريكي تباعا ، لم يبق ما يكفي من المال لسداد التزاماتها المالية.
وعين ابراهام لنكولن سايمون بي تشيس وزيرا للخزانة. وقد علم تشيس – وهو رجل عظيم الذكاء ، لا ينقصه سوى حس الدعابة ، وهو عضو في مجلس الشيوخ من أوهايو وحاكمها الأسبق – أنه أمام مشكلات لم يعرف لها مثيلا من قبل. وعندما اندلعت الحرب في 15 ابريل 1861 كانت الحكومة الفدرالية تنفق نحو 172 ألف دولار يوميا عشية إندلاع أولى المعارك "معركة بول رن Bull Run". وكانت وزارة الدفاع وحدها تنفق مليون دولار يوميا. ومع نهاية العام ، ارتفاع إنفاق وزارة الدفاع إلى 1.5 مليون دولار في اليوم.
كيف سيتسنى للحكومة تمويل تلك النفقات؟ إن أمام الحكومات ثلاث طرائق فقط لتأمين الأموال اللازمة لسداد التزاماتها المالية. إذ أن بيدها القدرة على فرض الضرائب والاقتراض وإصدار النقد. وقد لجأت الحكومات الفدرالية والكونفدرالية إلى هذه الوسائل جميعا. لقد كان للمزيج الجامع لهذه الوسائل الثلاث التي استخدمت في الشمال والجنوب أثر حاسم.
ومنذ انحلال المصرف الثاني للولايات المتحدة The Second Bank of The United States ، مولت الحكومة الفدرالية معظم حالات العجز المالي التي واجهتها – وأغلبها كان قصير الأجل – من المصارف . ومنذ ذلك الحين ستحور المصارف سندات الحكومة في خزائنها (احتياطياتها) أو تبيعها إلى عملائها الكبار. ولأنه لم يكن ثمة مصرف مركزي في الولايات المتحدة ، فقد دعمت الحكومة كل وسائل اقتراض المال أو تحويله من منطقة إلى أخرى داخل البلاد.
لقد ارتفعت قيمة الدين بحلول 1 يوليو 1861 – وذلك قبل ثلاثة أسابيع من معركة بول ران الأولى – إلى 91 مليون دولار. وعقب ذلك مباشرة ، عندما بينما المعركة أن الحرب قد تتحول إلى حرب طويلة الأجل ، أمن تشيس 50 مليون دولار من مصرفي وول ستريت لاسترداد السندات الفدرالية قبل حلول أجلها وقد باتت تعرف باسم "سبعة فاصلة ثلاثين" ، لأن معدل الفائدة عليها إنما كان 7.30% في المائة. (لقد اختير هذا المعدل كما يبدو لأن الغاية كانت أن تعطى السندات سنتين يوميا عن كل مائة دولار مستثمرة).
وكان مبلغ خمسين مليونا التزاما ثقيلا على وول ستريت آنذاك ، وقدر تشيس أن الدين القومي سيبلغ في العام التالي 517 مليون دولار ، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ الأمريكي ، وأدرك الوزير أن المتطلبات المالية للحرب الحديثة لا يمكن توفيرها بالوسائل التقليدية.ولحسن طالغ تشيس (والبلاد أيضا) أنه كان على معرفة بمصرفي فيلادلفي شاب اسمه جاي كوك Jay Cook ، وكان والده عضوا في الكونجرس على أوهايو ، وقد عين جاي كوك وكيلا للحكومة الفدرالية لبيع إصدار جديد من السندات عرف باسم سندات ال"خمسة – عشرين" Five-twenties (وذلك لأنها كانت قابلة للاسترداد في فترة لا تقل عن خمس سنين ولا تتجاوز عشرين ، بمعدل فائدة 6 في المائة ذهبا).
لقد غض كوك الطرف وإلتجأ مباشرة إلى جمهور العامة. ونشر إعلانات مكثفة في الصحف ووزع المنشورات الإعلانية. وقد سعي إلى أن تصدر الخزانة سندات بفئات صغيرة أدناها 50 دولار للسند ، وسمح للمكتتبين عليها سداد قمية اكتتاباتهم على أقساط. وهكذا حاول عامدا إشراك المواطن العادي في شراء الأوراق المالية الحكومية. ووفقا لوصف عضو مجلس الشيوخ جون شيرمان من أوهايو (وهو الشقيق الأكبر للجنرال وليام تيوميش شيرمان) فإن كوك جعل مزايا هذه الاستثمارات "على مرأى الناس في كل بيت من ماين إلى كاليفورنيا ". وهذكا ابتكر كوك حملات بيع السندات Bond Drive وقد باتت عنصرا أساسيا في كل حرب كبرى منذ ذلك الحين.
وكان لذلك أثر عميق في نظرة الأمريكيين إلى موجوداتهم الاستثمارية. ففي ستينيات القرن التاسع عشر لم يكن إلا لقلة من السكان حسابات مصرفية ، ولم يكن مالكو الأوراق المالية – بكل صدورها – يتعدون 1 في المائة من السكان. لقد أبقت معظم العائلات فوائضها النقدية تحت الحشايا. ومع نهاية الحرب كان كوك قد باع سندات إلى نحو 5 في المائة من سكان الولايات الموالية للاتحاد ، فتحول أولئك إلى طلائع الرأسماللين في هذه البلاد. ومن ناحية أخرى على القدر ذاته من الأهمية ، تحرر رأس المال العاطل المخبأ تحت الحشايا ووجه إلى استخدامات منتجة. وقد حقق كوك في حملة بيع السندات نجاحا كبيرا ، بحيث تمكنت الحكومة في مايو من عام 1864 من تأمين المال الكافي لتلبية نفقات وزارة البحرية والدفاع ، أي ما يصل إلى مليوني دولار في اليوم آنذاك.
لقد استطاعات المناطق الشمالية – والفضل لكوك في المقام الأول – أن تؤجل كثيرا من تكاليف الحرب إلى المستقبل ، حيث أمنت ثلثي إيراداتها في سنوات الحرب من بيع السندات. أما ولايات الجنوب (الكونفدرالية) –يث الطبقة الوسطة قليلة العدد ، وكذلك المصارف الكبرى – فلم يتسن لها تأمين أكثر من 40% من أما ولايات الجنوب (الكونفدرالية) –يث الطبقة الوسطة قليلة العدد ، وكذلك المصارف الكبرى – فلم يتسن لها تأمين أكثر من 40% من إيراداتها من خلال الاقتراض. وزاد حال مناطق الجنوب سوءا إفتقار اقتصاد الجنوب – كما عرف عنه – إلى السيولة. وهكذا لم يتيسر تحويل ثروة الجنوب إلى نقد وإنفاقه في شراء المعدات الحربية. وعلى الرغم من أن موجودات الجنوب كانت تشكل 30 في المائة من الموجودات الكلية في الولايات المتحدة عشية إندلاع الحرب ، فإن نسبة النقد المتداول فيها لم تتعد 12 في المائة. كما أن نسبة موجودات مصارفها لم تتعد 21 في المائة من مجموع الموجودات. وإن كلم "معسر الأرض Land Poor" لم تشع في الاستخدام إلا أيام إعادة الإعمار ، لكنها كانت تعبر تماما عن وضع اقتصاد الجنوب في العام 1861.
وقد سببت مبيعات السندات في الشمال إرتفاعا مذهلا في حجم الدين القومي. فقد كان يعادل 93 سنتا للفرد الواحد في العام 1857 ، قبل أن يعصف الكساد بالبلاد. وبعد ثماني سنوات وصلت حصة الفرد من الدين القومي إلى 75 دولار. ولن يبلغ ذلك المستوى المرتفع ثانية حتى الحرب العالمية الأولى ، ففي فترة سيحقق الاقتصاد فهيا نموا في الحجم . وقد سبب ذلك زيادة عظيمة في الأموال المتدفقة سنويا في قنوات الحكومة الفدرالية. وقبل الحرب الأهلية ، لم تنفق الولايات المتحدة سنويات أكثر من 74.2 مليون دولار (وذلك في العام 1858) . ومنذ الحرب الأهلية لم تنفق أقل من 236.9 مليون دولار (في العام 1878) . وقد أنفقت في العام 1865 وحده 1.297 مليار دولار ، وهي أول مرة في التاريخ تصل فيها ميزانية دولة من الدول إلى مليار دولار.
لقد كان النظام الضريبي الذي يقوم كلية على التعريفات الجمركية غير كاف – كما هو واضح – للتصدي لحالات الطوارئ. تماما كما كانت الطريقة التقليدية في إقتراض الأموال.وفي أغسطس 1864 قاد عضو الكونجرس سامون تشيس حملة (سيعتبرها بعد عشر سنوات – عندما يتبوأ منصب كبير القضاة – مخالفة للدستور) لفرض أول ضريبة دخل في الولايات المتحدة. وقد فرضت على إثرتها ضريبة على كل الدخول "سواء كانت مكتسبة من العقارات أو الإيجارات أو الفوائد أو الأرباح أو الرواتب أو أي تجارة أو عمل أو مهنة داخل حدود الولايات المتحدة أو خارجها ، أو من أي مصدر أيا كان".
وقد نص النظام الضريبي الجديد على فرض ضريبة بنسبة 3 في المائة على الدخول التي تزيد على 800 دولار (وهو آنذاك دخل الطبقة الوسطة) وترتفع إلى 5 في المائة على الدخول التي تتجاوز 10 آلاف دولار ، وهو دخل كان يكفي ليحيا المرء حياة مترفة آنذاك . وفي العام 1864 تضاعف ضرائب الدخول التي تزيد على 10 آلاف دولار ، فبلغت 10 في المائة. كانت الضرائب تصيب كل شيء تقريبا ، إذ فرضت ضرائب الطوابع على المستندات والرخص القانونية ، وضرائب الرفاهية (ضرائب تفرض على سلع اختيارية غير أساسية مثل التبغ والكحول والمشروبات وما شباه) ، على معظم السلع . فلبغت ضريبة المشروبات الكحولية ، 250 دولار للجالون مع أن سعرها قبل الضريبة لم يتجاوز 20 سنتا. كما فرضت الضريبة على المتحصلات الإجمالية للسكك الحديد والعبارات والمراكب البخارية والجسور التي تضخع لرسوم العبور. وفرضت الضرائب على الإعلانات . كما زيدت التعريفات الجمركية بمعدلات عالية. ووصلت إيرادات الحكومة الفدرالية من الضرائب إلى 21 في المائة من إجمالي إيراداتها. ومع ذلك ، وعلى الرغم من أن مستوى الضرائب كان أعلى كثيرا مما عرفه الأمريكيون في تاريخهم ، فإن مستوى التهرب الضريبي كان في الواقع منخفضا حتى في زمن الصراعات الكبرى القادمة. لقد بدا أن الناس كانوا مستعدين ، ومن دون تحفظ ، لدفع مستويات عالية جدا من الضرائب في زمن الحرب أو في حالات الطوارئ الحرجة التي تشهدها البلاد. لقد استطاع الجنوب – حيث انخفضت فيه مستويات التنمية وكان يفتقر إلى السيولة – تأمين نحو 6 في المائة من إيراداته عبر الضرائب.
وبالتالي كان لزاما على الولايات الانفصالية (الجنوبية) الاعتماد على المصدر الثالث لتأمين أكثر من نصف إيراداتها لمقابلة نفقات: إصدار النقد. وفي مايو 1861 كانت الحكومة الفدرالية تصدر كمبيالات خزينة قابلة للاستراداد ذهبا وفضة حتى بعد عامين من توقيع إتفاقية السلام التي أسست للإستقلال. ومع نهاية الحرب كان الجنوب قد أصدر أكثر من مليار ونصف مليار دولار من النقد الورقي. ولم تكن الحكومة في ريتشدوند هي الوحيدة في الجنوب التي تلجأ إلى مطابع النقد لتغطية نفقاتها. إذ اصدرت الحكومات المحلية في المند والولاياات أيضا كمبيالات الخزينة ، ولأن الجنوب لم تكن لديه مصانع ورق ومطابع متطورة كانت حالات التزوير متيسرة.
إن عواقب إصدار كميات كبيرة مما يطلق عليه الاقتصاديون النقود القانونية – النقود التي تستمد صفتها النقدية من حقيقة أن الحكومة تعتبرها نقدا بقوة القانون – كانت مسألة حتمية وكانت شائعة في ذلك الحين كما هي اليوم. ذلك أن ما يمكن أن يحدث هو تفعيل قانون جريشام. فالنقود الجيدة – كالذهب والفضة في هذه الحالة – تختفي تحت الحشايا حينما يدخرها الناس وينفقون النقود التي لا يرون فيها كثير قيمة أو لا يثقون بها كمخزن للقمية.
ثاني الحوادث كان انفلات التضخم من عقاله . فمع التدفق الهائل للنقود الصادرة عن دور الإصدار إلى اقتصاد الجنوب ، ارتفعت معدلات التضخم سريعا ، فتجاوزت 700 في المائة في السنتين الأوليين من الحرب فقط.ومع استمرار الحرب زاد التضخم حدة وبدأ اقتصاد الجنوب يخرج على السيطرة في حين فقدت العملة قيمتها كلية.
وعم الاكتناز ونقص المواد والأسواق السوداء بصورة كبيرة مع تراجع دعم المجهود الحربي وهبوط مستويات المعيشة بصورة حادة. إن فيلم "ذهب مع الريح" Gone with the Wind لا يقدم مادة تاريخية جيدة في العديد من معالجته ، لكن مشهد كبير الخدم الزنجي ممسكا البليطة بيده ، راكضا وراء ديك مهزول تحت المطر المنسكب ، محدثا نفسه بأن هذا الديك سيكون عشاء عيد الميلاد (الكريسماس) لمستخدميه البيض ، يجسد وقائع حياة مئات الآلاف من الأسر الجنوبية في آخر السنوات المدقعة من الحرب.
وقد لجأ الشمال أيضا إلى مطابع النقود ، ففي ديسمبر 1861 أجبرت مصارف البلد على إيقاف السداد بالذهب ولافضة وسارت الحكومة الفدرالية على هذا المنوال أيضا بعد مدة ليست بالطويلة. وأطرح البلد معيار الذهاب ، وساد الرعب وول ستريت ، فعلق لنكولن مفجوعا: "لقد زال قعر الحوض ، ماذا أنا فاعل الآن؟".
وكان ما فعله أن أمر بإصدار النقد الورقي. وبدأت الخزانة – بتفويض من الكونجرس – إصدار الأوراق النقدية الخضراء (الدولار) ، وقد سميت كذلك لأنها كانت تطبع بحبر أخضر على ظهرها (وقد وضع ساسمون تشيس – وعينه على دخول البيت الأبيض – صورته على فئة الدولار آملا في ذيوع شهرته). وفي العام 1865 بلغ ما أصدره البلد من الأوراق النقدية الخضراء 450 مليون دولار. كان هذا مبلغ عظيم بمعيار تلك الأيام ، ولكنه لم يرق إلا إلى 11 في المائة تقريبا من الإنفاق الفدرالي في تلك السنوات.وبينما ارتفعت حدة التضخم كنتجية حتمية لذلك ، فإنه ظل عند مستوى يمكن تداركه : 75 في المائة أو ما قارب.
وفي حين كانت الحكومة الفدرالية تعتمد على مطابع النقد الدولي لتمويل جزء من تكاليف الحرب ، أفاد الكونجرس من الحالة في إصلاح النظام المصرفي الأمريكي وحال الاختلال الحاد في عرض النقد الورقي. وفي العام 1863 اعتمد الكونجرس نظاما للمصارف المرخصة على المستوى القومي (عدل النظام جوهريا في العام 1864) . كان على هذه المصارف أن تحقق حدا أدنى قدره 50 ألف دولار من رأس المال ، وهو مبلغ كبير نسبيا بمعيار ذلك الزمن ، على أن تستثمر 30 ألف دولار منها في الأوراق المالية الصادرة عن خزانة الولايات المتجدة. هذه المصارف كان مسموحا لها بإصدار الأوراق النقدية المصرفية (البنكنوت) على أن توضع تصاميمها وكتاباتها تحت إشراف الحكومة الفدرالية ، وأن تكون تلك الأوراق النقدية مدعومة 100 في المائة بسندات الخزينة.
كان ثمة اعتقاد أن المصارف المرخصة على نطاق الولاية ستحصل على رخص بمزاولة العمل على النطاق الوطني. لكن قلة منها حصلت على هذه الرخص. لذلك أجاز الكونجرس في العام 1865 ، بأغلبية ضئيلة ، مشروع قانون يفرض ضريبة قدرها 10 في المائة على القيمة الاسمية للأوراق النقدية المصرفية (البنكنوت) الصادرة عن المصارف المرخصة على مستوى الولاية. وكان لهذا أثر في سعي مصارف الولاية للحصول على رخصة مزاولة العمل على المستوى الوطني (لم يبق هناك إلا 200 مصرف يعمل على مستوى الولاية في العام 1866) مما أنهى في نهاية المطاف الأنشطة المصرفية غير المنظمة (المخالفة) وساعد على التخلص من النقد المتداول الذي قوامه آلاف الإصدارات المختلفة. وعندما وضعت الحرب الأهلية أوزارها لم يكن ثمة إلا شكلان من النقد الورقي قيد التداول: الأوراق المصرفية الوطنية التي تدعمها احتياطيات المصارف ، والأوراق النقدية الخضراء.
وعلى الرغم من أن الحكومة الفدرالية لم تتردد في سداد إلتزاماتها المالية بالأوراق الخضراء وفي الطلب إلى الناس قبولها من خلال فرضها كنقود قانونية ، فإن الحكومة الفدرالية نفسها لم تقبل ذلك في سداد الضرائب. إذ كان ينبغي دفع الضرائب ذهبا ، وظلت التجارة الخارجية تقوم على أساس الذهب حصرا.
كان ذلك مؤشرا ، ولا ريب ، على الحاجة إلى إيجاد طريقة لتحويل الأوراق الخضراء (الدولار) إلى ذهب. ومع أن الحكومة الفدرالية اشترطت تداول الأوراق الخضراء بقيمتها الاسمية مع الذهب ، فإذن ذلك يم يستقم مع الواقع الاقتصادي ، وقوبل هذا القانون بالتجاهل. وبدأت بورصة نيويورك – ومعها مجلس البورصة – في تداول الذهب. ولكن سعر الذهب – ولا غرابة في ذلك – كان ينزع بقيمته المقيسة بالدولار إلى التذبذب عكسا مع النتائج العسكرية التي كان يحرزجها جيش الاتحاد ، وحظرت البورصة التداول في العالم التالي على أساس منافاته للمصلحة القومية.
وأسس آنذاك سماسرة الحساب الخاص curb brokers الذين كانوا يتداولون الأسهم في برود ستريت Broad street موضعا أطلقوا عليه اسم جيلبين Gilpin نيوزروم ، أو غرفة جيلبين الاخبارية (ولا أحد يعلم تماما من كان جيلبين هذا) ليتداولوا الذهب هناك. كان يسمح بالتداول فهيا لقاء رسم اشتراك سنوي قدره 25 دولارا. ولجأ ثقات التجار الذين احتاجوا إلى الذهب لأغراض التجارة أو لتوقي تقلبات سعر الأوراق النقدية الخضراء إلى جيبلين، تماما كما فعل مئات من "المضاربين لغرض المضاربة" أملا في تحقيق الثروة من تقلبات نتائج الحرب الدائرة لتقرير مصير بلادهم. ولم يكن هؤلاء المضاربون يحظون بقبولواسع فأطلق عليهم اسم "ميسرة الجنرال لي في وول ستريت". وعبر إبراهام لنكولن على الملأ عن رغبته في أن "تقطع رؤوسهم البغيضة جميعا".
كان الاسم الذي أطلق عليهم سيان بالنسبة إلى هؤلاء المضاربين إذ كان همهم الأكبر تلك الثروات العظيمة التي يمكن أن يكسبها سعيد الحظ أو صاحب البصيرة الثاقبة. وقد وقعوا في مطبات ومشكلات جمة لإثبات بصريتهم تلك ، فوظفوا وكلاء لهم على معرفة بكلا الطرفين المتحاربين لإطلاعهم على آخر المستجدات. لقد كنوا في حقيقة الأمر أكثر من واشنطن إطلاعا على آخر المستجدات وعلمت وول ستريت بما آلت إليه معركة جيتسبرج قبل أنت تنتهي إلى علم الرئيس لنكولن.
وفي 17 ينيو 1864 حاول الكونجرس إقتلاع شأفة المضاربة من خلال اعتبار تداول الذهب مخالفا للقانون إذا لم يجد عبر مكاتب السمامسرة. لقد أدى هذا القانون – بالإضافة إلى إغلاق جيلبين ، وتحويل تداول الذهب نحو برود ستريت حيث لم تتسن الرقابة عليه إطلاقا – إلى زيادة الهامش السعري بين الذهب والأوراق النقدية الخضراء. وقد بلغ الهامش ذروته قبل معركة جيتسبرج حينما كان شراء 100 دولار ذهبي يتطلب 287 دولار ورقيا. وعلق القانون بعد أسبوعين فقط وأعيد إفتتاح جيلبين من جديد.
وفي خريف ذلك العام أسست بورصة نيويورك للذهب على أيدي مجموعة من أعضاء مؤسسة وول ستريت ومنهم شابان غضا العود هما جيه بي مورجان J.P.Morgan وليفي بي مورتون Levi P. Morton (فيما بعد حاكم نيويورك ونائب الرئيس بنجامين هارسيون). وقد ضمت قاعة التداول مزولة على شكل ساعة كبيرة بذراع واحدة تشير إلى سهر الذهب الجاري. على الرغم من أنها اعتمدت معايير أشد صرامة وطبقت القوانين النافذة على نحو أفضل من جيلبين (الذي أغلق بعد مدة قصيرة) كان بورصة نيويورك لا تزال موضعها لا يناسب أصحاب القلوب الضعيفة.
وحققت وول ستريت بصورة عامة ازدهارا غير مسبوق في سنوات الحرب الأخلية. ومع أن إندلاع الحرب أطلق موجة من الهلع والخوف كما هو شأن أي حرب عظيمة تندلع من دون مقدمات فقد اتضح سريعا أن أعمال وول ستريت – أي تداول الأوراق المالية – ستشهد نموا عظيما. ومع الزيادة الهائلة في الدين القومي بأربعين ضعفا شهدت تداولات السندات إرتفاعا كبيرا جدا بالمقابل. كما تبين أيضا أن كثيرا من الاموال التي كانت تنفقها الحكومة ستذهب إلى شركات من قبيل مصانع الحدي ومسابك الأسلحة النارية والسكك الحديدية وشركات البرق والهاتف ومصنع النسيج والأحذية. وستستثمر أرباح تلك الشركات في وول ستريت التي ستوفر لها أيضا حاجتها من رأس المال.
ولم يمر وقت طويل حتى بدأ أكبر نهوض في حجم أعمال وول ستريت في التاريخ ، فارتقت سريعا إلى ثانية أكبر سوق للأوراق المالية على وجه المعمورة ، لا تسبقها إلى سوق لندن.وحصدت ثروات في السنوات القليلة التالية . ففي العام 1864 حقق جي بي مورجان – ولم يتجاوز حينها السابعة والعشرين من العمر – دخلا قبل الضريبه قدره 53287 دولارا ، أو ما يعادل خمسين ضعف ما يكسبه العامل الماهر في عام واحد. وكان السماسرة مشغولين على مدار الساعة ما أدى إلى ابتكار ما عرف بنضد الغداء لتوفير وجبة سريعة لهم قد لا تتوافر لهم إن هم عادوا إلى بيوتهم. وبالتأكيد لم تكن الوجبات السريعة هي الأقل شأنا بين ما ورثه البلد من حربه الأهلية.
ودأب مجلس بورصة نيويورك – الذي غير اسمه إلى بورصة نيويورك في العام 1863 – على عقد جلستي تداول في اليوم ، لكن ذلك يم يكن كافيا لتلبية حاجة الأعمال الجديدة التي تدفقت على وول ستريت. وهكذا افتتح بورصات جديدة لتلبية فائض الأعمال، في وقت شهدت فيه أعمال التداول لحساب السماسرة الخاص زيادات هائلة. وعادت بورصة المناجم إلى نشاطها بعد إنهيارها في أعقاب موجة الذهر التي عصفت في العام 1857 – وذلك للتداول في أسهم كتلك الصادرة عن شركة "وولاه وولاه جلتش جولد مايننيج" Woolah Woolah Gluch Gold Mining. وفي العام 1865 افتتح مجلس النفط للتداول في أسهم الشركات الجديدة التي تنقب في حقول نفط بنسلفاينا. لقد انطلبت أهم البورصات الجديدة – في طابق سفلي كان يعرف باسم كول هول Coal Hole.وصار حجم التداول فهيا على الفور يتجاوز حجم التداول في بورصة نيويورك ، وفي العام 1864 أعيدت هيكلتها تحت اسم مجلس السماسرة المفتوح Open board of brokers – ولم يلجأ المجلس إلى أسلوب جلسات المزاد القديمة ، بل إنتهج أسلوب المزاد الدائم. فكان كل سهم يتداول في ركن معين من قاعة التداول حيث خصص لها مركز (سمي كذلك تشبها بمركز عمود الإنادرة في برود ستريت حيث تداول السماسرة curb brokers الأوراق المالية لحسابهم الخاص كل على حدة).
لقد تجاوز حجم التداول السنوي في وول ستريت – بحلول العام 1865 – ستة مليارات دولار.وكتب جيمس ميدبيري في العام 1870 في مؤلفه ثمانمائة دولار وألف دولار يوميا من العمولات"... "ودخل الناس جميعا هذا المجال. وحاصرت المكاتب حشود العملاء ... ولم تشهد نيويورك إطلاق مثل هذا المؤشر الكبير على ازدهار الاقتصاد . كانت المركبات مصفوفة في أرتال في شارد برودواي" وحتى باعة أرقى القبعات النسائية والخياطون وتجار الجواهر حصدوا مكاسب وفيرة في خضن هذا الازدهار. كان مهرجانات الشارع الخامس في يوم الأحد ومهرجانات الحديثة المركزية (سنترال بارك) في كل أيام الأسبوع مدهشة ورائعة وغير مألوفة! فلم يسبق أن كان ثمة هذا الانتشار الكبير لموائد العشاء والاستقبالات والحفلات الراقصة تلك. وقد أذهت متاجر انونيما Anonyma بروعة أثوابها وغنى إكسسواراتها وزيناتها. ولم يعد معرض الأناقة Vanity fair حلما بعيد المنال".
وخلال الحرب الأهلية ارتفع وقع التصنيع في الاقتصاد الأمريكي – وكان جاريا على قدم وساق – إلى مستويات عظيمة جدا. إن الطلب غير المسبوق مما بات أكبر جيوش العالم وثاني أكبر الاساطيل البحرية في العالم بعد البحرية البريطانية قد أذكى كثيرا بطبيعته فورة في الإنتاج. وهذا ما آلت إليه أيضا التعريفات الجمركية التي رفعت إلى مستويات غير مسبوقة للمساعدة على تمويل الحرب. وبالنتيجة استطاعات الصناعة الأمريكية – وكانت لا تزال أقل كفاءة من نظيرتها البريطانية – اقتناص الأسواق. وتناقص حجم الواردات بمعدلات حادة . وفي العام 1860 قدرت الواردات الأمريكية بقيمة 354 مليون دولار. وبعد عامين بلغت 189 مليون دولار فقط على الرغم من النمو الاقتصادي السريع.
وعوضت الصناعات الأمريكية العجز في الواردات تماما. وفي العام 1859 كان عدد الشركات الصناعية 140.433 شركة في الولايات المتحدة. وارتفع هذا العدد بعد عشر سنوات إلى 252.148 شركة. كما ارتفع الانتاج المحلي من خطوط السكك الحديد – وهو مقياس ملائم للقوة الصناعية في القرن التاسع عشر – من 205 آلاف طن في العام 1860 إلى 356 ألف طن بعد خمس سنوات (وقد بلغ الانتاج 620 ألف طن في العام 1870). لكن الحرب ساعدت أيضا على تحفيز الصناعات الأقل شأنا في الاقتصاد الأمريكي. لقد لاقت العملية التي حصل على براءة إختراعها جيل بوردين Gial Borden لتعليب الحليب المكثف ، في العام 1856 ، زيادة كبيرة في الطلب. وقد ساعد هذا على رواج صناعة تعليب الغذاء برمتها.
وقد أدى نقص اليد العاملة بسبب التحاق كثير من الرجال بالجيس – مع ذلك – إلى المزيد من الابتكارات الميكانيكية التي فاقت الحد المألوف ، والتي حرضتها هجرة الأيدي العالمة الاوروبية ، حيث تجاوز عدد المهاجرين ثمانمائة ألف شخص في سنوات الحرب.
وشهد الجنوب أيضا نموا في الصناعة – بسبب الحرب – لكنه جاء من قاعدة صناعية محدودة ، وفي ظل قيود ومعوقات كثيرة. كان مصنع الحديد المشغل بكامل طاقته الإنتاجية في الجنوب هو ورشات حديد تريدجار Tredgar Iron Works قرب ريتشموند ، وقد ساعد هذا المصنع كثيرا على زيادة الإنتاج. كان يشغل 700 عامل في العام 1861 و2500 مع حلول يناير 1863. لكنه لم ينتج أكثر من ثلث العرض من تماسيح الحديد اللازمة للوصل به إلى طاقته الإنتاجية الكاملة ، مع أن ألاباما كانت منتجا رئيسيا لفلز الحديد.
ومع ذلك ، فقد أنشئت مسبكة لصناعة المدافع في ماكون بجورجيا إلى جانب عدد من مسابك البرونز هنا وهناك. وقد بنت ولايات الجنوب الانفصالية (الكونفدرالية) أكبر مصانع البارود في أمريكا الشمالية – ويقع في أوجوستا بجورجريا. واستطاع الجنوب إمداد قواته بالمؤن والعتاد من دون انقطاع. وحقق لنفسه كفاءة خاصة في صناعة الأسلحة الصغيرة. وقد كتب جوشيا جورجاس – الذي راس مكتب القانون الكونفدرالي – في مذكراته للعام 1863 ، وهو يملأه شعور بالفخر والإعتزاز: " وحيث إننا لم نكن قبل سنوات ثلاث نصنع البنادق أو المسدسات أو السيوف الضالعة – ولا الطلقات أو القذائف – ولا حتى رطلا واحدا من البارود – فإنن اليوم نصنع كل ذلك بكميات تلبي حاجة جيوشنا الجرارة". وعندما استسلم الجنرال لي في أبوماتوكس وكانت قواته قد استنفدت طعامها ، وأوشكت على مجاعة ، فقد ظل بحوزتها نحو خمس وسبعين طلقة من الذهيرة لكل مقاتل وعدد كاف من قذائف المدفعية.
ووضعت بحرية الجنوب خططا لبناء 150 سفينة . وبالطبع لم تحقق ما خططت له . لكن بناء نحو 50 سفينة – ومنها 21 مدرعة – لم يكن بالإنجاز اليسير في ظل الظروف السائدة آنذاك. ولم يكن أثرها ضئيلا في ما تمخضت عنه الحرب وفي مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
وجابت مراكب القرصنة الكونفدرالية – وبعضها مصنوع في بريطانيا – مثل المركب الأسطوري سي إس إس ألاباما CSS Alabama – البحار للسطو على سفن الاتحاد. وهكذا سارع ملاك السفن الأمريكان إلى إنزال أعلام مراكبهم ورفعوا العلم البريطاني للحيلولة دون اختطافها . لكن ثيرا من هذه المراكب لم يعد من رحلته.
لقد كانت الولايات المتحدة قوة بحرية عظمة منذ أول عهد الاستيطان ، ولم يتفوق عليها في معظم تلك الفترة إلا بريطانيا نفسها. لكن الحرب الأهلية عجبت بوقوع انخفاض طويل الأجل في حركة الشحن المارة عبر المياه الأمريكية. ولم يتعاف الأسطول التجاري من أثر ذلك. وفي العام 1860 ومن أصل 8.275 مليون من الشحنات التي عبرت الموانئ الأمريكية ذلك العام ، كان 5.921 مليون طن – أو أكثر من 71 في المائة – عائدة إلى أمريكيين. ومع حلول العام 1890 كان 22 في المائة من هذه الشحنات تعود إلى أمريكان. أم أكبر ضحايا الحرب الأهلية فكانت أول الصناعات الأمريكية الكبرى.
إذ على الرغم من عجائب التطور الصناعي التي حققها الجنوب في خلال الحرب ، فقد دمرت هذه الحرب في نهاية المطاف كل صناعاته معها كثير مما تبقى من اقتصاده. وفقدت السندات والنقود الورقية التي صدرت عن الولايات الكونفدرالية (الجنوبية) وحكومات الولايات قيمتها، وتلاشت معها الأموال السائلة في المنطقة. لقد تقوضت زراعة الجنوب – وكانت روح اقتصاده ودعاماته الأساسية – عندما هجر الكثير من اليد العاملة المستعبدة الحقول حالما أمكن لها ذلك. وقد فسد محصول القطن في المخازن لتعذر تصديره بسبب الحظر الذي فرضه الشمال (على الرغم من أن الكثير هرب سرا إلى الخارج لتوفير المادة الأولية لمصانع نيوإنجلاند).
ومع نهاية الحرب وظاهرة الرق ، كان لابد من اعتماد نظام جديد للزراعة في مناطق الجنوب. فقد امتلك الذين كانوا في عداد العبيد سابقا زمام السيطرة على قوة عملهم لكنهم أعوزتهم الأرض والمعدات والخبرة في التعامل مع الاقتصاد الحر. وحافظ ملاك العبيد السابقون على الكثير من أملاكهم في صورة الموجودات الرأسمالية اللازمة لإنتاج المحاصيل – كالأراضي ومحالج القطن لكنهم افتقروا إلى المال اللازم لسداد أجور عمال المزارع.
وجرب عدد من الأنظمة ، لكن لم يمض وقت طويل حتى ظهر نظام للمغارسة Charecropping كاني دفع بموجبه للعمال حصة من المحصول نفسه ، وذلك في أقاصي الجنوب (ولم يكن هذا النظام معروفا في كل أنحاء البلاد الأخرى تقريبا) ، لكن سيهيمن على زراعة الجنوب حتى الحرب العالمية الثانية. لكنها لم تستثن الأشكال الأخرى من الأنظمة الزراعية ، ولم تقتصر المغارسة على العمال الزنوج . فقد عمل كثير من أسر البيض الفقيرة في المغارسة ، وكانت 25 في المائة من عائلات السود العاملة في الزراعة تملك الأرض التي عملت بها العام 1880 ، وهذا يعد إنجازا بارزا ، خصوصا أنه لم تنقض أكثر من خمسة عشر سنة على إبطال الرق آنذاك.
لكن الجنوب حافظ على السمات الأساسية لما يدعى اليوم ببلدان العالم الثالث: ملكية وسائل الإنتاج من قبل نخبة صغيرة تتمتع بالإمتيازات ، والفقر المدقع والعمل مضمني لأغلبية السكان ، واقتصاد يقوم على الزراعة والصناعة الاستخراجية بدل التصنيع والخدمات. الأسوأ من ذلك ، أن العنصرية البغيضة – على الرغم من أن إلغاء الرقيق كان أكبر إنجازات الحرب الأهلية – التي جسدتها ظاهرة الرق التي لم تنحسر. ومع نهاية إعادة الإعمار ، أعادالبيض الجنوبيون التأكيد على السيطرة السياسية. وأصبح السود بمعظمهم مهمشين طوال قرن من الزمن تقريبا. لقد نفرت العلاقات الوطيدة – ولكن غير المستقرة – بين الأعراق المستقرة في الجنوب المستحدثين من غير الجنوبيين من الإنتقال إلى المنطقة للإفادة من المزيات التنافسية المتوافرة مثل إنخفاض تكاليف المعيشة ورخص الأيدي العاملة. وفي هذه الأثناء ، كانت دائما ذروة هجرة من أبناء الجنوب الموهوبين والطامحين إلى الشمال بحثا عن الفرص العديدة المتاحة هناك. وبعد ثمانين سنة من فشله الذريع في تحقيق الإستقلال سيظل الجنوب بلدا من بلدان العالم الثالث داخل بلد سيرتقي إلى مرتبة أكثر اقتصادات العالم الأول وأكثرها ديناميكية في العالم.
ومن المفارقة الفاصلة التي تجسدت في الحرب الأهلية ، بكل تكاليفها أرواحا وأموالا هي التي ولدت هذه النزعة الديناميكية الجديدة. إن اتساع نطاق الصراع أطلق شعورا من الفخر العظيم والعميق في ما نجحت الحرب في إنقاذه ، أي الاتحاد الأمريكي. فقد حولت الحرب الأهلية الولايات المتحدة (وهي عبارة صيغت لغويا – قبل الحرب في صيغ الجمع) من مجموعة من الولايات المترابطة إلى أمة تحمل اسما بصيغة المفرد. إن شعار الأمة القديمة "الكثرة تتحد في الفرد" قد تحقق على أرض الواقع ، ولكن بتكلفة بلغت نصف مليون قتيل. ومن بين الدول العظمة اليوم ، يبقى اليابان وحدها – وهي المتجانسة إثنيا ليس إلا – العدد الأقل من القوى المغردة خارج السرب centrifugal قيد النشاط في كيانها السياسي.
لقد استشعر سامون بي تشيس الموقف الجديد مبكرا في العام 1863 ، فكتب في ذلك العام: "لقد بدأنا من دون رأسمال ، وإذا كان علينا أن نخسر القسم الأكبر منه قبل أن تضع هذه الحرب أوزارها ، فإن العمل labor سيعيده كرة أخرى ، وبزخم لم نعهده بيننا من قبل".
إن حقيقة إن الحرب قد مولت بموارد محلية وبمبالغ طائلبة ، قد أثبتت للمواطل درجة القوة والثراء التي وصلت إليها الأمة. وقد ذكر عضو الكونجرس جدلوف إس أورث أمام حشد من الحضور في لافاييت إنديانا في العام 1864 أن أمريكا "هي اليوم أقوى الأمم على ظهر الكوكب. وقد كان هذه الحرب السبيل إلى شخذ الموارد والقدرات إلى درجة لم يجل بخاطركم من قبل أنها ملك أيمانكم".
وقد علم الشعب أن ذلك بات ملك يمينه. ومع نهاية الحرب الأهلية – عندما تتقلص القوات العسكرية سريعا ولا تبقى منها إلا أعداد ضئيلة – فإن الشعب في العقود الثلاثة المقبلة سيسخر تلك الموارد والقدرات ليذهل العالم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الفصل الحادي عشر:الرأسمالية الضارية
في نصف القرن ما بين نهاية الحرب الأهلية وبداية الحرب العالمية الأولى في أوروبا ، طرأت تغيرات أشد وقعا على الاقتصاد الأمريكي الذي تسارعت معدلات نموه وزاد تنوعا لم يحققه في الفترات الخمسينية من تاريخ البلاد.
وفي العام 1865 كان البلد لا يزال يهيمن عليه الطابع الزراعي ، على الرغم من أنه اكتسب مقومات القوة الصناعية الكبرى قبل ذلك التاريخ . ولم يدرج آنذاك أي مشروع صناعي في بورصة نيويورك. وفي مطلع القرن العشرين – أي بعد جيل كامل – كان لدى الولايات المتحدة أكبر اقتصاد صناعي على وجه الأرض ، اقتصاد قائم على شركات عملاقة لم تدر في خلد أحد العام 1865 ، لقد اصبح البلد – وهو مستورد لرأس المال منذ نشوئه – قوة مالية عالمية أيضا – تضاهي بريطانيا العظمى.
لقد ارتفع الإنتاج الزراعي أيضا بمستويات مرتفعة – مع أنه لم يعد يحتل مكان المركز في الاقتصاد الأمريكي – وذلك مع تدفق المزارعين ومربي الماشية إلى السهول العظيمة Great Plains عن طريق السكك الحديد التي مدت عبر هذه السهول في تلك السنوات. ومع حلول العام 1890 أعلن مكتب الإحصاء أن منطقة التخوم- وهي سمة ميزت الواقع الجغرافي السياسي للولايات المتحدة – لم يعد لها وجود. كانت لا تزال ثمة أراضي كثيرة غير مأخولة ، لكنها رقع متناثرة ولم يبق ثمة خط واضح عبر القارة يفصل بين نهاية المدينة وبداية البرية التي كانت ذات يوم بلا حدود . لقد أصبحت الولايات المتحدة حينذاك أمة قارية في واقعها الجغرافي السياسية ومن المنظور الجغرافي البحت.
إن الحاجة إلى إيجاد قواعد ومؤسسات جديدة تساعد على حفز هذا الاقتصاد الجديد وازدهاره – ولضمان توزيع ثماره ونتائجع بالعدل بين كل قطاعات المجتمع – ستهيمن على السياسة الداخلية الأمريكية على امتداد القرن المقبل ، تماما كما هيمن الحفاظ على الاتحاد ومسألة العبودية على السياسية الداخلية في فترة ما قبل الحرب. إن كثيرا من الوسائل التي اعمتدت للسيطرة على الاقتصاد الجديد في تلك الفترة ستأتي من خلال العمل الحكومي والتشريعي ، وخصوصا في العقود الأخيرة ، لكن كثيرا منها سينبثق – في الواقع – من القطاع الخاص مع سعي أرباب المحاماة والصيرفة والسماسرة وعمال السكك الحديد ورؤساء الاتحادات العمالية والصناعيين إلى تعزيز مصالحهم الشخصية على الأجل الطويل ، التي كانت – ولا ريب – غير متطابقة بعضها مع بعض.
كان المفكرون منخرطين في الجدل الدائر حول السياسة الاقتصادية وقواعد اللعبة في أواخر القرن التاسع عشر. ولم يكن لهؤلاء من قبل أي دور يتجاوز النظرية الاقتصادية المجدرة. وقد سعوا أحيانا إلى الحديث بلسان المجتمع بدلا من المصالح الشخصية لفئة بعينها. لكنهم تحدثوا – وبالطبع لا مهرب من ذلك – بلسان مصالحهم الخاصة مع أنه كان يغلب عليهم سيماء غير المدرك لهذه المصالح. وبقي البعض من أمثال كارل ماركس وهنري جورج أصحاب نظرية (منظرين) ، لكنهم نالوا شعبية كبيرة (لقد كان هنري جورج – مع ذلك ، وكان يضلح بدور الاصلاحي – قاب قوسين من انتخابه عمدة لنيويورك في العام 1886 ، وانتهى في مركز متقدم على المرشح الجمهوري ثيودور روزفلت). وآخرون من أمثال تشارلز فرانسيس آدامز وشقيقه هنري كانوا أساسا في فئة الكتاب والصحافيين. ولم يكن لكثير من هؤلاء المفكرين – مع ذلك – إلا معرفة ضحلة بالعالم الاقتصادي الحقيقي الذي كانوا يسعون إلى التأثير فيه.
بموجز القول ، كان ذلك صورة نموذجية عن العملية الديموقراطية العشوائية ولكن – وكما هي حال الصيرورات الديموقراطية – ظهر أثرها على الاجل الطويل . إذ لم يسبق لأي مجتمع في التاريخ أن وجد نفسه في حاجة ماسة إلى السيطرة على اقتصاد مؤسس على قاعدة صناعية عالية الديناميكية في أمة تعتبر من الناحية الدستورية جمهورية اتحادية ذات صلاحيات محدودة. وقد عرف الولايات المتحدة كيف تفعل ذلك بالاستفادة – من دون إدراك منها – من الأفكار العظيمة للآباء المؤسسن ، فالإنسان ليس كالملائكة ، فثمة مصالح شخصية تقوده وتحركه. ويمكن الافادة من المصلحة الشخصية في تحقيق المصلحة العامة عبر نظام مترابط من تقسيم السلطات. إن الاقتصاد الأمريكي – مع أنه كان ينهك في فترات الكساد الشديد أحيانا – سيحثث ازدهارا هائلة – على الأجل الطويل – في السنوات المائة والأربعين التالية ، وذلك تحديدا لأن الأمة الأمريكية خرجت بنظام "مراجعة وموازنة" عالي الفاعلية لتنظيم الاقتصاد في العقود التي تلت الحرب الأهلية.
وبعد الحرب مباشرة ، لم يغلب شيء على السياسة الأمريكي – وبالتالي على الاقتصاد الأمريكي – بقدر الفساد. فلم تكن ثمة شرطة ساهرة على تطبيق النظام ، وكانت الرأسمالية بحالتها الضارية قد كشرت عن أنيابها ren in tooth and claw. وكانت أحيانا مصدر بهجة وتسلية على الأقل بالنسبة إلى أولئك الذين لم يكونوا منخرطين فيها على نحو مباشر ، لكنها لم تكن أسلوبا ناجعا لإدارة الاقتصاد. فالرأسمالية إن لم تصحبها ضوابط وجهات رقايبية تفقد استقرارها بطبيعتها ، إذ يعطي الأفراد مصالحهم الشخصية قصيرة الأجل أولوية على مصالح النظام العام. وتكون النتيجة حالة من الفوضى والاضطراب أو البلوتوقراطية Plutocracy (حكومة الأثرياء). وكما بين هربرت هوفر فإن: "مشكلة الرأسمالية هي الرأسماليون أنفسهم ، إذ لا حدود لجشعهم".
ولم يتجسد هذا الفساد في منطقة ما بقدر ما كان في نيويورك. خصوصا في وول ستريت. فقبل الحرب الأهلية كانت السوق المالية صغيرة إلى درجة ألغت الحاجة إلى الضوابط الرسمية، فالأطراف المختلفة كان يراقب بعضها بعضا. وفي زمن لم يعرف الخديعة والاحتيال الصريحيين العلنيين إلا بأدنى صورهما ، كانت أطراق اللعبة في معظمها من المحترفين الذين أدركوا تماما ما هم مقدمين عليه. لكن الحال تغيرت مع سيل الأوراق المالية الصادرة نتيجة الحرب والزيادة التي نشأت عن ذلك في عدد المتداولين بها.
لكن لم تكن ثمة آلية لممارسة الرقابة ، ولم يكن هناك اعتقاد بأن للحكومة الفدرالية أي دول في تنظيم عمل الأسواق آنذاك ، وأصبحت حكومات الولايات والمدن مراتع للفساد. لقد كتب جورج تمبلتون سترونج – في العام 1857 – في مذكراته وقد ملأه القنوط : "فلتبارك السماء على كل نعمائها ، لقد علق المجلس التشريعي لنيويورك". وبعد ذلك بسنوات قليلة كتب هوراس جريلي في "نيويورك تربييون" أنه كان متعذرا "أن ينعقد أي جهاز آخر مهما بلغت درجة إهماله – وليس فقط فاسدا ، بل صفيق ، في قاعتنا التشريعية في السنوات العشر المقبلة".
وكان جريلي مخطئا. ففي العام 1867 أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون قضى بمشروعية الرشوة. ووفقا لنص القانون فإنه: "لا يجوز تجريم الرشوة بموجب هذا القانون بناء على شهادة الطرف المعتدى عليه ، ما لم يؤيد هذا الدليل في أركانه المادية بدليل آخر". وقد عني ذلك – في ذاك العصر ما قبل الإلكتروني – أنه ما دام الموظف قد قبض الرشوة سرا ونقدا فلا سبيل إلى إدانته".
ولم تكن محاكم الولايات في حال أفضل من المجلس التشريعي. فقد كان انتخاب القضاة في ولاية نيويورك يتم منذ أربيعنيات القرن التاسع عشر ، عندما تبنت الولايات دستورا طغت عليه أفكار جاسكون. وهذا ما جعلهم يعتمدون في عملهم على الأجهزة السياسية ، تماما كحالهم اليوم.وكانت النتائج متوقعة. وكتب جورج تمبلتون ستورنج – وهو محام ناجح جدا – في مذكراته: "إن المحكمة العليا هي بالوعتنا الكبرى ، أما المحامون فهم جرذانها". وفي العام 1868 كتبت المجلة الإنجليزية الشعبية مجلة فريزر Fraser's Magazine، أن "ثمة عامة في نيويورك بين المتقاضين (أطراف الدعوى) – لا تجدها في أي مدينة أخرى – وهي أنهم كانوا يأملون توكيل القضاة كما كانو يوكلون المحامين". ولم يكن ذلك ينطبق في أي مكان آخر بقدر ما كان ينطبق على ما أصبح يعرف في وول ستريت بحروب إري Erie ، أي الصراع على خط حديد إري.
لقد كان لخط حديد إري تاريخ حافل بالتناقضات بالمقارنة مع سابقاته من خطوط السكك الحديد الأمريكي. فقد رخص بموجب صفقة سياسية ، وكانت الغاية منه أساس أن يكون طريقا رئيسية عظيمة. ولتأمين الدعم السياسية لمشروع قنال إري من "الطبقة الجنوبية" للأقاليم التي تقع على طول الحدود مع بنسلفانيا ، فقد وعدوا "بمعبرط خاص بهم. وكان خط السكة الحديد الذي رخص في العام 1832 هو ذلك المعبر. وقد عملت القوى السياسية على الناي بخط إري عن بوفاللو ، وهي التخم الغربي الطبيعي للخط ، حيث إنه كان ينافس عمل القنال ، لمروره من نيوجيرسي منتهيا عند نهر هدسون قادما من مدينة نيويورك فقط ، فقد كان هذا التخم الشرقي الطبيعي لهذا الخط. وعوضا عن ذلك ، فقد كانت النتيجة أطول خط سكك حديد ف يالعالم ، يمر عبر مدينة صعيرة هي دنكيرك في نيويورك على شاطئ بحيرة إري وصولا إلى مدينة صغيرة أيضا هي پيرمونت، نيويورك على نهر هدسون شمالي حدود ولاية نيوجرزي، بطول 451 ميلا.
لقد إنتهى خط السكك الحديد إلى الإفلاس خلال مرحلة إنشائه التي استمرت سبع عشرة سنة, وكان وقت انتهائه ذا هيكل رأسمالي متطور قوامه الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل. كانت تلك الأوراق المالية خيارا مضاربيا مفضلا في وول ستريت ، خصوصا بالنسبة إلى مضارب اسمه دانييل درو ، الذي كان أيضا بين فترة وأخرى أمينا لخزانة سكة حديد إري وعضوا في مجلس إدراتها.
كان درو من أبرز أعلام وول ستريت في تاريخها. لقد استهل حياته المهنية – وهو غير المتعلم ، الذي كان مخلصا لعمله فطنا فيه – تاجرا للماشية ، ببيعها في سوق الماشية في نيويورك. وتحول على الفور إلى التداول في وول ستريت والعمل في المراكب البخارية. وفي ستينيات القرن التاسع عشر أصاب ثراءا كبيرا قد ذات مرة – على الأقل وفق تقديراته الخاصة – بستة عشر مليون دولار. وأسس ما بات يعرف اليوم بجامعة درو ، وأنفق على تشييد عدد من الكنائس. لكنه عندما كان لا يذكر الله كان يبذل بحماسة لا تنقطع كل حيلة ممكنة في وول ستريت – وبعضها إبتكره بنفسه – لتجريد المضاربين المتهورين من أموالهم. ولم يحب درو – الذي كان يكنى "زعيم المضاربة " – أكثر من المضاربة في الأوراق المالية الصادرة على خط سكة حديد إري.
لقد كان هذا الخط على الرغم من مشكلاته المادية المزمنة – انتهي إلى الإفلاس للمرة الثانية في العام 1859 – مشروعات هائلا ، عمل فيه ذلك العام أربعة آلاف وأربعمائة عامل وآلاف المركبات ، وحقق عوائد بملايين الدولارات. وكانت إمكانتاه الاقتصادية كبيرة. وبفضل مقعده في المجلس كان درو قادرا على الوصول إلى معلومات خاصة أفاد منها من دون وازع من ضمير ، كما فعل أشياعه من كبار المضاربين . وكانت النتيجة كما ترويها قصيدة غنائية ترددت في بورصة نيويورك:
قال دانييل إلى أعلى – وارتفع إري إلى الأعلى ..
قال دانييل إلى أسفل – ونزل إري إلى الأسفل ..
وقال دانييل فليتذبذب – فترنح إري في كلا الإتجاهين ..
طالما كان عمل السكك الحديد عملا رابحا : لأن تكاليفه الثابتة مرتفعة جدا ، وهي تظل قائمة إن تحسنت ظروف العمل أو ساءت . ولهذا السبب فإن الحصة السوقية تعد أمرا حاسما لربحية خطوط السكك الحديد في جو تسوده المنافسة ، حيث إن كل راكب أو طن إضافي يزيد الدخل من دون أن ترتب عليه نفقات تذكر. وبسبب الحاجة إلى تحقيق حصة سوقية ، فقد كانت الحروب السعرية شائعة بين خطوط السكك الحديد المتنافسة في القرن التاسع عشر (وهي شائعة اليوم في الخطوط الجوية للأسباب ذاتها تماما).
لكن ثمة حدودا طبيعية لهذه الحروب السعرية ، حيث تتحول تخفيضات الأسعار من دون مستوى معين إلى ما يشبه "الانتخار الاقتصادي" . ومع ذلك فلم يكن مجلس إدارة خط إري مهتما كثيرا بهذا المسائل الهامشية الاستراتيجية كالرحبية أو القدرة على الاستمرار والنمو. إذ كان مهتما كثيرا بالأرباح التجارية القصيرة الأجل التي تحقق في وول ستريت ، وهذا ما جعل خط إري الورقة الرابحة في قطاع السكك الحديد في نيويورك (ودعت تشارلز فرانسيس إلى تسميته "المرأة الفاسقة في وول ستريت"). وأراد كورنيليوس فاندربيلت – وهو شخصية ذات نفوذ متصاعد في تلك السوق – أن يفعل شيئا ما حيالها.
لقد ترك فاندربيلت عمله لدى توماس جيبونز في العام 1829 ، وبدأ عمله الخاص في مجال المراكب البخارية . وأضحى بعد فترة وجيزة أكبر ملاك السفن في أمريكا ، وفي العام 1837 كانت صحيفة جورنال أوف كوميرس أول من استخدم اللقب الفخري الذي دخل فيه التاريخ: عميد البحار (الكومودور). كان أسلوب عمل الكومودور هو البساطة بعينها: 1- إدارة المؤسسة بأعلى قدر من الكفاءة وأقل مستوى ممكن من التكايف. 2- المنافسة السعرية الضارية لتدمير المنافس أو إخراجه من السوق أو رشوته للخروج من المنافسة. 3- الإلتزام بما يبرمه من اتفاقيات وعقود. لقد كتب عنه ماثيو هيل سميث – وهو محام وكاهن إبرشي – في العام 1870 أن "كلام الكومودور موثوق كعقوده ، عندما يصدرعنه بملء إرادته. كما أنه حريص في المقابل على تنفيذ أي وعد يصدر عنه".
كان فاندربلت راغبا في قبول مبلغ نا يثنيه عن المنافسة في أحد خطوط السكك الحديد ، لأن المراكب البخارية – على عكس السكك الحديد – يمكن أن تشغل حيثما وجد الماء الكافي لتعوم فيه. فإن حصل على المال الذي يحمله على مغادرة نهر هدسون مثلا فإن ذلك يسهل كثيرا المنافسة على طريق لونج آيلاند ساوند أو طريق نيويورك – فيلادلفيا. لكن البعض لم يذلك ذلك ، كانت "نيويورك تايمز" في صفحتها الافتتاحية في خمسينيات القرن التاسع عشر أول من استخدم الصورة – إن لم تكن الكلمة أيضا – التي يظهر فيها النبلاء اللصوص في القرون الوسطى ، وذلك في نقد تكتيكيات فانلدربيلت. ويعرف عن النبلاء اللصوص أنهم عاشوا على ضفاف نهر الراين ، وفرضوا على العابرين إلى قلاعهم رسم عبور يضمن لهم المرور بسلام. (وسواء كان هؤلاء حقيقة واقعة أو كانوا من نسج خيال القرن التاسع عشر ، فهذه مسألة أخرى).
لقد كان فرض رسوم العبور لقاء تسهيل حركة العابرين – بالطبع – إبتزازا واضحا ، لأن ذلك لا يقوم اساسا على تبادل الثروة. لكن فاندربيلت لم يكن يصنع شيئا من هذا القبيل. ففي العام 1859 عرضت صحيفة "هاربرر ويكلي" – وهي أقل اهتماما بالاحداث الاقتصادية من "التايمز" – تفسيرا لذلك. فقد كتبت "كان ذلك هو النزعة السائدة ، أن ينظر إلى تلك المنافسات على أنها محاولات من جانبه لإبتزاز المشاريع الناجحة. فليس عدلا أن يقرر المرء دوافع جاره في اتخاذ عمل ما ، إذا كان العمل في حد ذاته مشروعا وقانونيا. ولابد من الحكم على العمل بنائجه. وقد كانت النتائج إنشاء فاندربيلت خطوط سكك حديد منافسة التخفيض الدائم لأجول النقل. وكانت الأسعار كلما مد "خط حديد منافس" تتراجع على الفور ، وبعض النظر عن نتيجة المنافسة ، سواء انتهت بإخراج المنافسين – كما كانت الحال دائما – أو الخضوع لهم. فإن الأسعار ما كانت تعاد إلى سابق عهدها. إن هذه النعمة العظيمة – ألا وهي السفر الرخيص – إنما يدين بها الناس والمجتمع في المقام الأول إلى كورنيليوس فاندربيلت". وستعتنق "التايمز" نفسها وجهة النظر هذه عن الكومودور.
إن عبارة "النبلاء اللصوص" إنما جاءت في الأصل لتعني الأشخاص – الذين كان فاندربيلت في طليعتهم – الذين اقاموا إمبراطوريات عظيمة في حقول الصناعة والنقل في الاقتصاد الأمريكي أواخر القرن التاسع عشر. صحيح أن هؤلاء الرجال كانوا عتاة مخادعين منساقين وراء تعظيم الذات (وفي المقابل كان ثمة رجال شرفاء أيضا حرصوا ، وقد غلب عليهم الشك ، على أن يبقوا رهنا للقوانين حتى إن كانت قاصرة" ، إذ لم يحصل أي منهم على الثروة من الآخرين لقاء جهد بذله. وقد أنشأوا كلهم مشاريع عملاقة كانت مصدرا للثروة . ومع ذلك كله ، فإن تلك العبارة "النبلاء اللصوص" مقدر لها أنت تبقى قيد الاستعمال والتداول.
وشرع فاندربيلت في مطلع ستينيات القرن التاسع عشر في التحول إلى السكك الحديد ، وهي تقنية طالما حمل مقتا لها على الدوام ، إذا أوشك على الموت في واحدة من أولى حوادث السكك الحديد في هذه البلاد. لقد إشترى حصة مسيطرة في خط حديد نيويورك وهارلم وسكة حديد نهر هدسون. وكان خطي السكك الحديد الوحيدين الموصلين مباشرة إلى جزيرة مانهاتن. وعندما تعرضت حصصه في هذه الخطين إلى هجمات المضاربين في وول ستريت في العام 1863 ومنهم دانييل درو نفسه ، أثبت فاندربيلت على الفور أنه السيد المطلق في لعبة وول ستريت ، فأحرج المضاربين في هارليم مرتين ، والمضاربين في هدسون مرة واحدة في عضون أسابيع فقط ، وجنى الملايين وحقق لنفسه سمعة ما نالها رجل قبله في وول ستريت منذ ذلك الحين. وقد تحدث عنه أحد الصحافيين البريطانيين في تلك الأيام قائلا: "أسد جايتوليان بين ضباع الصحراء وثعالبها".
ودعي فاندربيلت في العام 1867 إلى قبول منصب رئيس شركة خط نيويورك سنترال فسعى على الفور إلى دمجه في خط سكة حديد نهر هدسون الذي يملكه ، وكانت النتيجة ولادة خط جديد يمتد على طول الطريق بين مدينة نيويورك وبوفالو ، وينافس بصورة مباشرة خط سكة حديد إري. ولم يشك فاندربيلت إطلاقا في قدرته على كسب المنافسة. لكنه أراد أن يشغل خط إري على أساس تجاري بحيث يسر لكلا الخطين تحقيق الربح بناء على اتفاق بتقاسم الركاب (ولم يكن في هذا ما ينافي القانون آنذاك ، مع أنه يعد اليوم إندماجا معيقا للتجارة).
ولقد كان مصمما على إخراج درو من المجلس في انتخابات الثامن من أكتوبر 1867 والسعي إلى انتخاب مؤيديه بدلا منه.ومضى درو – وهو صديق ومنافس قديم منذ عهد المراكب البخارية – إلى لقاء الكونودور ، وتعهد بأن يضبط نفسه وبأن يعمل أيضا لتحقيق مصالح فاندربيلت . وأبدى فاندربيلت ليونة بعد ذلك ، ولم يحفظ درو منصبه في المجلس فقط ولكنه عين أيضا أمين خزانة لخط إري من جديد ، وهو منصب لم يشغله منذن منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر. كما انتخب لعضوية المجلس اثنان من الوافدين الجدد على وول ستريت : جاي جولد وجيم مينسك.
وسرعان ما أخلف درو وعوده لفندربيلت بأن شكل مجموعة مضاربة بغية دفع سعر سهم خط إري إلى الارتفاع . وحين طلب فاندربيلت إلى المجلس الموافقة على تقاسم ركاب مدينة نيويورك بين خط إري وخط نيويورك سنترال وخط بنسلفانيا ، رفض مجلس إري ولم يوافق عليه إلا فرانك ورك ، رجل الكومودور في المجلس.
واعترض فاندربلت على ذلك وقرر أن يرد. وإذا كان غير قادر على التأثير في المجلس لحمل أعضائه على التصرف بروح رجل الأعمال ، فإنه سيلجأ إلى ما سماه تشارلز فرانسيس آدامز "القوة الضاربة لملايينه" لشراء حصة مسيطرة في خط إري. كان عدد الأسهم العادية الصادرة رسميا 251.050 سهما. لكن درو وضع يده على 28 ألف سهم غير مطروح في التداول ، كان يحوزها ضمانا على أحد القروض ، كما كان ممكنا أيضا تحويل بعض صادرات سندات خط إري إلى أسهم عادية. وكان درو – يوصفه أمين خزانة – في مركز مثالي يخوله إصدار المزيد من السندات القابلة للتحويل ، وتحويلها وفق ومقتضيات الضرورة للحيلولة دون أن يكسف فاندربيلت السيطرة بشراء معظم الأسهم العادية.
ومضى فاندربيلت إلى القاضي جورج جي برنارد الذي نعته أحد معاصريه بالقول "محارب شجاع قل مثيله بين معارف فاندربيلت الخلص" . وأصدر برنارد على الفور أمرا قضائيا يحظر على دامييل درو ، بوصفه أمين خزانة ، تحويل السندات إلى أسهم ، وأن يكف شخصيا عن بيع الأسهم بحوزته. واعتقد الكومودور أن الوضع بات تحت السيطرة فأمر سماسرته بالتوجه إلى السوق وشراء أسهم خط إري المعروضة هناك.
لكن درو نجح في إقناع أحد معارفه من القضاة - واسمه جيلبرت ويقيم في بروكلين – بإصدار أمر قضائي يسمح بتحويل السندات إلى أسهم وفق الطلب. وبوصفه سمسارا ، فقد وضح اي سي ستيدمان الموقف بقوله: " بما أن برنارد حظر تحويل السندات إلى أسهم ، وحظر جيلبرت الامتناع عن هذا التحويل فلا يلومهما أن فعلا ما طاب لهما إلا موارب".
وفي غضون أيام قلائل ، أصدر خط غري سندات حولت إلى مائة ألف سهم جديد وطرحت في السوق.وتعهد جيم فيسك قائلا : "إذا لم تتعطل هذه المطبعة ، فلتنزل بي اللعنات إن لم أعط هذا النذل العجوز كل ما يبتغيه من شركة إري".
وعندما تبين لفاندربلت أن مجلس إري كان يطبع أسهما جديدة بالمعدل نفسه الذي يشتريها به سماسرته ، عاد إلى القاضي برانرد وحمله على إصدار مذكرات إعتقال. وأرسل الشريف لجلب أعضاء مجلس إري ، أما مجلس إري الذي تناهى إلى علمه نبأ هذا الإعتقال الوشيك ، فقد فر هاربا.
ووصف وليام ورثينجتون فولر – وهو سمسار ألف كتابا عن وول ستريت في العام 1870 ، كان من أكثر الكتب مبيعا – بقوله: "لاحظ شرطي في أثناء مناوبته مجموعة من الرجال المتأنقين الذي تبدو عليهم مع ذلك أمارات الروع ، محملين برزم من الأوراق المالية الخضراء ودفاتر الحسابات ورزم من الأوراق المضمومة بشرائط حمراء ، يندفعون وعليم سيما الاندفاع والاضطراب ، من مبنى خط غري . ولأنه إرتاب في الأمر ، واعتقد أن أولئك الأشخاص قد يكونون لصوصا تجرأوا على السرقة في رابعة النهار ، فقد اقترب منهم ليتبين خطأ إعتقاده. فقد كانوا أعضاء اللجنة التنفيذية لشركة إري هاربين من نقمة الكومودور محملين بغنائم آخر حملاتهم". وكذلك كانوا. فقد حشدوا سبعة ملايين من أموال الكومودور في خرج سفر وهربوا سريعا إلى نيوجيرسي حيث كانوا آمنين بعيدا عن قوانين نيويورك.
وانتقلت الأحداث بعد ذلك إلى ألباني ، حيث حاول كل طرف رشوة أعضاء المجالس التشريعية "الذين تدفقوا على ألباني كالعجول المحتشدة في سوق الماشية. وكلهم كانوا مستعدا لقبض الثمن. وعرض كل منهم سعرا يتناسب مع وزنه. وقد وصل جاي جولد – وفق صحيفة نيويورك هيرالد – إلى أباني بحقيبة ملاى بأوراق من فئة ألف دولار. وعندما ألقي القبض عليه قدم 500 ألف دولاركفالة فورية.
كما يمكن للكومودور أن يكسب سباق الرشا ، لكنه أدرك أن هذا الكسب سيكون مكلفا على الأجل الطويل ، إذ أن الرأي العام بدأ يعارض امتلاكه خط إري وخطي هدسون ونيويورك سنترال . ولو حدث ذلك لكان سبيله إلى احتكار تام تقريبا لسوق النقل في نيويورك. وقرر فاندربيلت التفاوض فارسل خطابا إلى درو أكد فيه أمرين: أن يأخذ منه السهم الذي فقد قيمته – بعد أن أعلنت البورصات الكبرى أن هذا السهم "ليس صفقة رابحة" – بسعر مقارب لقيمة الشراء الأصلية. وأني قطع دانييل درو كل صلاته بخط إري. ولإتمام هذا الاتفاق عين جاي جولد رئيسا لشركة خط إري وجيم فيسك أمينا لها.
لقد هزت صراعات إري الشعب ، واكتسبت القصة مبالغات وإضافات في الصحف أكثر مما قوبلت به قصة محاكمة الرئيس أندرو جاكسون بتهمة التقصير التي تزامنت مع تلك الأحداث. وبينما كان الشعب مستمتعا جدا بما يجري ، فقد كان معظم أعضاء المؤسسة التجارية بين نيويورك راعبين.
إن السماسرة – وهم ليسوا كالمضاربين الذين لا هم لهم سوى اقتناص فرصة الربح التالية – يكسبون دخلهم بالعمولات لقاء كل أمر تداول. لذلك فهم في حاجة بالتالي إلى التنبؤ بالسوق – بأكبر درجة ممكنة – بما يسمح لهم بالإستفادة من أكبر عدد ممكن من العملاء. إذا كانت كمية أي سهم مصدرا لتتضاعف أو تتراجع بمقدار النصف من دون إشعار فوري من الإدارة فكيف للمرء أن يصل إلى قيمة السهم؟ وضعت صحيفة "الكوميرشيال آند فاينانشيال كورنيكل" – وهي صحيفة أسبوعية ذات إنتشار واسع بين القراء – يدها على أصل المشكلة . إذ لم يكن الرأسماليون مجانبين للصواب تماما ، لأن "نص القنون قاصر جدا في رقابته على إدارة مصالح الشركا". ونشرت الكرونكل اقتراح قانون لحل المشكلة طالبت بموجبه أن تحصل إدارة الشركة على موافقة حملة الأسهم قبل إصدار الأسهم الجديدة ، بحيث لا يصدر أي سهم من دون إشعار ، وأن تتاح سجلات كل الإصدارات للإطلاع لدى كل المؤسسات المالية وبأن يحرم كل ما يخالف ذلك.
ولم يكن في ستينيات القرن التاسع عشر من سبيل لسن هذا القانون بسبب من حالة الفساد التي استشرت في تشريعات الولاية. ومع ذها فقد كان باستطاعة البورصات – التي يملكها سماسرة – أن تسن قوانينها الخاصة ، وهذا ما كان في غضون شهر واحد. ففي 30 نوفمبر 1868 أصدرمجلس السماسرة المفتوح وبورصة نيويورك مجموعة متماثلة من الضوابط التي تفرض على الشركات المدرجة تسجيل كل أوراقها المالية في غضون شهرين في سجل متاح لإطلاع العامة ، وتقديم إشعار عام مدته ثلاثون يوما عن نيتها إصدار أوراق مالية جديدة. ورفضت شركة خط حديد إري – وقد باتت لعبة في يد جاي جولد وجيم فيسك ، الامتثال لهذه الضوابط ، وكان أن رفع إسمها من قائمة الشركات المدرجة.
ولم يمض وقت طويل حتى اندمجت هاتان البورصتان تحت اسم بورصة نيويورك. وأخيرت ولدت مؤسسة في وول ستريت لها من الحجم والقوة ما يكفي لاصدار ضوابط فعالة. وأدرك جاي جولد على الفور أنا ما من خيار أمامه إلا الخضوع للضوابط إذا كان حقا راغبا في أن يرى سوقا "لائقة" للأوراق المالية الصادرة عن شركة إري ، وهكذا سجل أسهم الشركة وسنداتها في 13 سبتمبر 1869.
كانت تلك هي البداية فقط ، فقد كان جيمس كي ميدبري يدرك – في كتابه "رجال وول ستريت وأسرارها" في العام 1870 – الرهان المطروح. فكتب "إن الأمر بأيدي سماسرة البورصة ليقرروا إذا كانوا سيختارون الأرباح التافهمة التي يكسبونها من المضاربة على أخطاء الغير القاتلة ، أم سيرمون بثقلهم ونفوذهم وبإصرار أشد لمواجهة إختراقات تلك الزمر. إن الطريق الأولى تقود إلى الإنعزال. أما الثانية فستكون مقدمة لتنامي العلاقات الدولية التي ستسبغ نيويورك طابعا إمبرياليا وستجعل نيويورك بقدر ما يتطلب موقعها المحوري ويسمح "المركز المالي الأولى في العالم".
واختارت وول ستريت أن تسلك الطريق الثانية. فبدأت بورصة نيويورك تبذل غاية جهدها نفوذها في تنظيم تداول الأسهم على نحو فعال. كانت وول ستريت لا تزال مكانا لا متسع فيه للمغفلين – ولن يكون كذلك – ولكن إذا ما قورنت بوضعها قبل بعض سنوات فإن وول ستريت تحولت إلى سوق مالية حديثة تتمتع بمستوى مقبول من الضوابط. وقد بلغت القيمة السوقية الكلية للأسهم المتداولة في وول ستريت آنذاك نحو 3 مليارات دولار. لكن وول ستريت كانت تكتسب زخما سريعا. إذا ستنتهج وول ستريت ضوابط ذاتية ناجعة في السنوات التالية بعد أن تتفوق على سوق لندن وتصبح المركز المالي الأول في العالم.
ولم يتقصر الفساد الذي ساد في فترة ما بعد الحرب على رأسماليي نيويورك أو حكوماتها أو خطوط الحديد. ذلك أن أعظم مشروك للسكك الحديد في تاريخ الأمة – خط الحديد العابر للقارة الذي أنشئ بين العمين 1864-1869 – قد أطلق أكبر فضيحة مالية وسياسية شهدها القرن التاسع عشر.
لقد وضعت فكرة خط الحديد العابر للقارة بعد انضمام كارولينا إلى الاتحاد في العام 1850 ، لكن اتساع شقة الأزمة السياسية بين الشمال واجنوب حال دون بدء العمل فيه. وفي العام 1862 حينما كانت الولايات الموالية للاتحاد هي فقط الممثلة في الكونجرس ، أقر قانون خط حديد البسيفيكي الذي أسس بموجبه خط حديد يونيو باسيفيك ، وهو أول شركة ترخصها الحكومة الفدرالية منذ ترخيص المصرف الثاني للولايات المتحدة في العام 1816 ، كانت الغاية من المشروع أن يكون رمزا للاتحاد (ومن جاء اسم شركة الخطوط الحديدية – بقدر ما كان الدافع منه أن يكون مشروعات تجاريا).
كانت الشركة ستحصل – منذ إنطلاقها – على كثير من الدعم اللازم في السوق المفتوحة ، خصوصا أن المشروع كان يمتد على مسافة تتجاوز ألف ميل عبر الأراضي غير المأهولة. لقد ربطت السكك الحديد في الشرق وفي اوروبا مراكز النشاط الاقتصادي على نطاق واسع ، مما رفع مسويات ذلك النشاط. أما في الغرب فقد خلقت تلك السكك مثل تلك المراكز مع انتقال الناس والتجارة على الطرق التي سلكتها تلك السكك. كان رأس المال الأولى لشركة يونيون باسيفيك سيحدد بمائة ألف سهم بقيمة اسمية 1000 دولار للسهم الواحد ، أي 100 مليون دولار ، وهذه رسملة عالية جدا. وسيعطي خط يونيون باسيفيك وسنترال باسيفيك – الذي كان سيقام باتجاه الشرق بداء من ساكرامانتو – حق العبور بعرض مائتي قدم على الجانبين في الأراضي الخاصة. كما ستحصل السكك الحديد – عن كل ميل ينجز من الطريق – على الحق في ستة آلاف وأربعمائة فدان من الأرض تباع للمستوطنين ، تتخللها قطع من الأرض تحتفظ بها الحكومة الفدرالية.
لم يكن هذا كل شيء ، فلكل ميل أنجز من خط الحديد تحصل شركة يونيون باسيفيك على ما يتراوح بين 16 ألفا و48 ألف دولار على شكل سندات حكومية ، وهذا يتوقف على وعورة التضاريس وعلى قروض الحكومة على شكل سندات رهت عقاري من الدرجة الأولى. تسترد على فترة تتجاوز الثلاثين عاما ، لقاء تكاليف الإنشاء. وقد تبين حالا – مع ذلك أن ثمة حاجة إلى مزيد من العون. ففي العام 1864 أجاز مشروع قانون جديد للخطين الحديديين بيع سندات الرهن العقاري من الدرجة الأولى (التي تأتي من حيث أولوية السداد قبل سندات الرهن الحكومية). وتضاعفت مساحة الأراضي الممنوحة لشركتي السكك الحديد إلى 12800 فدان عن كل ميل منجز من الطريق.
وعلى الرغم من الإعانات الحكومية الهائلة ، فإن ذلك المشروع ظل مقترنا بدرجة عالية جدا من المخاطرة ، وتحركت إدارته حالا لضمان أرباحها الخاصة إن لم يكن ثمة ما يضمن أرباح المساهمين العاديين. وعليه فقد أسست شركة إنشاءات تعود ملكيتها إلى الإدارة تحمل اسما فرنسيا رنانا هو كريدي موبيلييه Credit Mobilier ، واستأجرت خدمات الشركة لمد السكك الحديد . وبالطبع فقد حملت تلك الإدارة الشركة تكاليف باهظة وحصلت أحيانا على نظير خدماتها الإدارية. ومع أن كبير المهندسين – بيتر دي Peter Dey – قد قدر أن القسم الأول الواقع غربي أوماها لا تتجاوز تكلفة إنشائه 30 ألف دولار للميل الواحد ، فقد طلب إليه توماس دورانت أن يعيد تقدير التكلفة ليجعل المبلغ المقدر 60 ألف دولار للميل الواحد ، وهو المبلغ الذي طلبته شركة كريدي موبيلييه أول الأمر.وبدلا من الاستجابة لهذا الطلب ، استقال دي مما أسماه "أفضل منصب شغلته في حياتي المهنية في هذا البلد". آخرون – بالطبع – لم ينساقوا إلى مثل هذا الرادع الأخلاقي.
وقد عمل على السكتين عشرة آلاف رجل – مهاجريون أيرلنديون وعبيد محررون وجنود مسرحون من الخدمة ومهاجريون صينيون – شقوا طريقهم عبر السهول والجبال والصحاري الغربية باتجاه نقطة التقاء في برومونتوري بوينت بأوتاه. ومدت تلك الجموع السكك الحديد بسرعة مذهلة (أربعة في الدقيقة).وكان عدد الضحايا بالمقابل مروعا. فقد كتل كثيرون في حوادث عرضية ، ومات كثير أيضا في شجارات دارت في مجالس الشرب التي كانت تعقد في المخيمات التي واكبت طليعة خط الحديد.
وحتى في ذلك الوقت ، كان مشروع خط الحديد للقارة يعد من أعظم ملاحم عصر المعجزات الهندسية . وقد نعته ويليام تيكومسين شيرمان "بعمل الجبابرة". وفكر الشاعر الغربي جواكين ميلر أن "ثمة إلهاما شعريا في اندفاع خط الحديد عبر القارة يتجاوز الإلهام الذي توحي به قصة احتراق طراودة المثيرة".
ومع أنه كان من الناحية الإنشائية من بدائع العصر ، فإن خط يونيون باسيفيك كان من الناحية المالية مشروعا مفلسا بسبب تكلفة إنشائه التي يعود الفضل فيها إلى شركة كريدي موبيلييه التي حققت أرباحا طائلة على حسابه. وفي العام 1867 دفعت كريدي موبيليه أول دفعة من الأرباح لحملة أسهمها ، بلغت 76 في المائة من قيمة استمثاراتهم. ووصلت توزيعات الأرباع فيما بعد إلى 350 في المائة. وفي ثاني جوة من توزيعات الأرباح في العام 1868 حصل كل مساهم بقيمة اسمية 10 آلاف دولار في أسهم كريدي موبيلييه على 90 ألف دولار نقدا و7500 كسندات في يونيو باسيفيك كانت تباع آنذاك بقيمتها الاسمية ، وأربعين سهما من أسهم يونيو باسيفيك بقيمة 1600 دولار ، اي ما يعادل عائدا على رأس المال قدره 181 في المائة.
ورأى أوكز إيمز – وهو من حملة أسهم كريدي موبيلييه وعضو في الكونجرس عن مساتشوستس – أن يقطع الطريق على أعضاء الكونجرس الآخرين ليضمن ألا ينخرطوا في هذا العمل فيثيرون مشكلاة هو في غنى عنها . وبالفعل قطع الطريق على كثير منهم ، إذ كان لزاما عليهم دفع ثمن الأسهم ، لكن ذلك لم يشكل بالنسبة إليهم عبئا بذكر خصوصا أنه قد سمح لهم بدفع الثمن من توزيعات أرباح الأسهم الكبيرة. ومن بين الذين حصلوا على الأسهم شويلر كولفاكس الذي سيكون أول نائب للرئيس جرانت وهنري ويلسون نائبه الثاني. وثمة آخرون من بينهم جميس جارفيلد الذي سينتخب رئيسا في العام 1880 وجيمس بلين المرشح الجمهورية للرئاسة في العام 1884.
لكنهم لم يمضوا من دون أن يتركوا أثرا وراءهم. ففي يناير 1869 كتب تشارلز فرانسيس آدامز – الذي سيصبح رئيسا لشركة يونيون باسيفيك في ثمانينات القرن التاسع عشر – في مجلة نورث أمريكا ريفيو أن كريدي موبلييه لم تكن إلا شركة تدور في فلك شركة يونيون باسيفيك. ذلك أن "أعضائها هم من الكونجرس وهم أمناء عن حملة الأسهم ، وهم مديرون ، وهم حملة أسهم ، وهم مقاولون ، ففي واشطنك يصوتون على الإعانات الحكومية ، وفي نيويورك يتلقون تلك الإعانات ، وفي السهول ينفقونها .. وفي كريدي موبليين يتقاسمونها".
كل ما ساقه آادمر مجرد تهمة لم يملك الدليل عليها . فلم يلتفت إليها أحد. ولكن – وكما يحدث عادة – يقع اللصوص في الشرك في آخر المطاف ، ذلك أن أحد حملة أسهم كريدي موبلييه الساخطين – وهو هنري إس ماك كومب – قاضى الشركة اعتقادا منه أنها خدعته . وسربت أوراق المحكمة إلى تشارلز إي دانا محرر "نيويورك سن" التي نشرت القصة في 4 سبتمبر 1872 في جملة أخبارها الرئيسة في ستة أعمة:
ملك الاحتيال – كيف شقت كريدي موبلييه طريقها بالرشا عبر الكونجرس – رشا هائلة
وأوصلت لجنة الكونجرس التي انعقدت للتحقيق في الفضيحة بطر أوكز إميز Oals Ames وعضو آخر من الكونجرس – أحد قلائل الديموقراطيين المتورطين – لكنه اكتفى بتوجيه إذار رسمي إليهما. ومع ذلك فقد عانى الجمهورييون كثيرا في انتخابات العام 1874 ،وفقدوا السيطرة على البيت الأبيض. كما أن اوليسيس جرانت – كان بريئا من أي ذنب – سيتمرغ اسمه بالفضيحة لأنه سيراس أكثر الحكومات فادات في تاريخ الولايات المتحدة.
كانت إحدة الصحف هي من نبه الرأي العام إلى فضيحة كريدي مونبليييه ، وهذا إشارة واضحة إلى القوة المتنامية لوسيلة الإعلام الجديدية في التأثير في الأحداث السياسية التي كانت تتناولها. وقد أطلق لورد ماكوالي على الصحافة إسم "السلطة الرابعة" في العام 1828 ، لكن ذلك لم يتجسد واقعا إلى حين أصبحت الصحف وسيلة إعلام جماهيري يقرؤها الملايين. فاصبحت حقا قوة حؤثرة في أروقة السياسة في بريطانيا والولايات المتحدة .
لقد ساعد إكتشاف حالة الخلل الكبير في حرب القرم على يد ويليام هوارد رسل – أو السير ويليام فيما بعد – من جريدة التايمز اللندنية على إسقاط حكومة أبيردين وفتح الطريق إلى إصلاحات شاملة في الجيش البريطاني.
وفي العام الذي سبق انتشار فضيحة كريدي موبيليه كشف نيويورك تايمز ما كان يعرف بعصبة تويد التي أنشأت قصرا عدليا متواضعا شمالي سيتي هول في نيويورك بمبلغ 12 مليون دولار ، أي ما يتجاوز 20 في المائة من تكلفة إنشاء مجلس النواب الأوسع مساحة والأكثر زخرفا في لندن في أربعينيات القرن التاسع عشر ز وضربت موجة من الإصلاح ولاية نيويورك والمدينة نفسها بطبيعة الحال. وصد رقانون جديد للرشوة كأحد التعديلات الجديدة في دستور الولاية ، حيث كانت الرشوة بمنأى عن يد التشريع والقانون.
كما أدخلت إصلاحات على السلطة القضائية ومهنة المحامات ، والفضل في ذلك يعود إلى المحامين أنفسهم في المقام الأول. لقد كت جوجر تيمبلتون ذات يوم في مذكراته: "إن تعطل آلية القانون هو مصدر رعب لملاك العقارات .. إذ لا يستبعد أي مصر أو تاجر أن يفد غليه شخص ما يطلق على نفسه اسم حارص قضائي معين بطلب أحد الخصوم. في خطوة أولى في دعوة عبثية لم تسمع بها أذن من قبل. ويدلف إلى غرفة الحسابات ، في أي لحظة ، طالبا وضع يده على كل موجوداته وتعليق كل عمله بما يجلب له الخراب والدمار .. وبذلك ما من مدينة ترغب في صيانة ثروتها وإزدهارها تقبل بمثل هذه الانتهاكات ، إن رأس مال سيفر إلى المناطق الأكثر أمنا".
كانت المشكلة الأساسية تتمثل في أن التقنية قطعت أشواطا بعيدة تقدمت بها على القانون والتشريعات ، وقد كت المحامي النيويوركي دافيد دادلي فيلد – في أحد أعطم الإنجازات الفكرية في القرن التاسع عشر – "دستور فيلد لأصول المحاكمات المدنية" ، الذي إعتمدته ولاية نيويورك في أربعينيات القرن التاسع عشر ، وعمل به في عدد من الأماكن الأخرى ، (فقد استخدمه البريطانيون مرتكزا لإصلاح قوانينهم في سبعينيات القرن التاسع عشر ، كما أنه اليوم أساس القانون المدني في الدول التي تعتمد القانون العام Common Law).
لقد كان القضاة – قبل ظهور التلغراف والسكك الحديد – في حجاجة إلى إعمال حدسهم وفكرهم كثيرا للتشريع بما يضمن صيانة الحياة والملكية. لكن مع حلول ستينيات القرن التاسع عشر أسئ إستخدام هذا الحدس كثيرا. ففي خطبة نشرب في عدد من الصحف ، أشار ويليام ماسكويل إيفارتز – وهو أحد ألمع المحامين في البلد ، وعمل مدعيا عاما في آخر أيام إدارة الرئيس أندرو جاكسون – في تعليق على بداية حياته المهنية إلى أنه "إذا ما أراد المحامي أن يخرج من غرف القضاة بأمر قضائي من جانب واحد لا يستطيع الدفاع عنه أمام الجمهور فإنه يجلب على نفسه المشاعر نفساه التي تنشأ عندما يخرج بكتاب جيب مسروق".
لقد أسس إيفارتز وغيره من المحامين الرواد جمعية محامي ولاية نيويورك في العام 1870 لمراقبة مهنة المحاماة ، والعمل على إحداث الإصلاحات اللازمة في القوانين ، كحظر تدخل القضاة في الحالات غير المعروضة عليهم ، وسار على هذا النهج أيضا المحامون في الولايات الأخرى وأنشأو اتحادات المحاماة الخاصة بهم. وفي السنة التاية ، مع انهيار عصبة تويد تبرعت جمعية المحامين بمبلغ 30 ألف دولار للمساعدة على دفع نفقات محاكمة القضاة الفاسدين – من أمثال القاضي برنارد – الذين أدينوا فعلا ، ودفع الإصلاحات الواسعة للقوانين قدما في التشريعات التي سلكت فجأة طريق الإستقامة والفضيلة.
لقد تبين أن الفضائح من قبيل تلك التي ارتبطت بقصر تويد العدلي أن كريدي موبيلييه ، وكل تلك التي جائت بعدها وصولا إلى ووتر جيت وإنرون في عصرنا الحالي كانت محركات للإصلاح . إذ لا يمكن توقع جميع أشكال الفساد التي يمكن أن تنشأ في اقتصاد حر دائم التطور وفي ظل حكومة ذات صلاحيات محدودة. وسيظل القانون قاصرا بخلف طويل عن الأفاكر سواء الصالح منها والطالح ، التي ستتولد عن الأفراد المحكومين بمصالحهم الخاصة للإفادة سريعا من الفرص الجديدة فور ظهورها. أما السبب الذي لأجله تبدو على القرن التاسع عشر ، لاسيما التسربل بالفضائح ، فهو أنه ربما كان ثمة كثير من التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية في ذلك القرن.
ومع الإصلاحات التي جلبتها الفضائح في حقبة ما بعد الحرب الأهلية مباشرة استقر الاقتصاد الأمريكي والسياسية الأمريكية في فترة أكثر احتراما لحكم القانون ، وفي وقت حافظ فيه الاقتصاد على تقدمه المتسارع. لكن كثيرا من الرجال الذين قدر لهم أن يؤدي دورا محوريا في رسم ملامح الاقتصاد الجديد – قد بلغوا سن الرشد في حقبة ساد فيها الفساد الحكومي بوقع غير مسبوق ، ولن يكونوا قادرين على النظر إلى الحكومة كأداة ناجعة للإصلاح وتنظيم الاقتصاد.
فبالنسبة إليهم كانت الحكومة جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل. لقد اعتقدوا أن من واجب رجال أمثالهم أني يضعوا الاقتصاد الأمريكي على أساس محكم ونزيه والحفاظ عليه في هذا الشكل. لكن حركة سياسية صاعدة ستحمل مسميات عدة مختلفة – اليسار والتحررية والشعبية والتقديمة وما إلى ذلك – ستكون لها وجهة نظر مغايرة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الفصل الثاني عشر: شفافية التجارة
في وقت ما كان في الاقتصاد الوطني يزداد حجما بعد الحرب الأهلية ، فوطني يزداد حجما بعد الحرب الأهلية ، فإن التشريعات والضوابط النقدية والمصرفية لم تكن على قدر هذا النمو . وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي أضحى أكبر اقتصادات العالم في تلك السنوات ، وسيأتي زمن ينافس فيه جميع اقتصادات اوروبا في الحجم ، فقد ظلت الولايات المتحدة من دون مصرف مركزي وبالتالي من دون آلية لتنظيم عرض النقد في البلاد . لقد ظل شبح كراهية توماس جيفرسون للمصارف مخيما على الاقتصاد الأمريكي ، مع أن هذا الاقتصاد بات آنذاك شبيها – بناحية أو بأخرى – بأمة من الفلاحين الأحرار كان جيفرسون قد تنبأ بظهورها.
لقد عادت بقوة في ذلك الحين المصارف المرخصة على مستوى الولاية وهي التي شارفت على الزوال كلية عندما فقدت القدرة على إصدار الأوراق النقدية المصرفية (البنكنوت). فقد استعادت تلك المصارف القدرة على خلق النقد من خلال تحرير قيد دائن في الحساب الجاري للمقترض (وهو ابتكار بريطاني في مجال الصيرفة). وعلى الرغم من أن عددها تراجع إلى ما دون 200 مصرف في نهاية الحرب الأهلية ، فإن عدد المصارف المرخصة في العام 1900 على مستوى الولاية سيصل إلى 4405 مصارف معظمها مصارف صغيرة لا تتمتع بالقوة المالية اللازمة.
لقد كان أداء النظام المصرفي الوطني الجديد جيدا في الشمال الشرقي ، حيث الاقتصاد أكثر تطورا ، وكان رأس المال السائل أكثر وفرة ، ولأن المصارف الوطنية كان محظورا عليها أن تفتح فروعا لها او تزاول عملها في ولايات أخرى ، فقد ارتفع عددها بمعدل كبير فوصل إلى 3731 مع مطلع القرن الجديد. ومع أنها كانت في الأغلب أكبر من مصارف الولاية وأكثر منها ملاءة مالية ، فإن كلا من المصارف الوطنية كان يعتمد على اقتصاده المحلي اعتمادا كاملا. إن كبرى مزايا القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي – وهي حجمه وتنوعه الكبيران – لم تقدر الاستفادة منها للقطاع المصرفي الذي كان لزاما على جميع القطاعات الأخرى التعامل معه ، وسيتبين مع مرور الزمن أن ذلك كان قصورا كارثيا.
وفي الجنوب والغرب افتقرت كثير من المناطق إلى الموارد اللازمة لتلبية متطلبات ترخيص المصارف الوطنية . ولم يكن في ولايتي المسيسبي وفلوريدا أي مصرف وطني يربط بينهما. والأسوأ من ذلك أن المصارف الوطنية كانت محظورا علهيا إقراض المال بضمان عقاري ، والأرض هي أكثر الموجودات وفرة في تلك المناطق . إن أساس عرض النقد نفسه صار مسألة سياسية كبرى في أواخر القرن التاس ععشر ، هينما قسم معيار الذهب البلاد إلى مناطق متنافرة.
ولدى إندلاع الحرب الأهلية طرحت الحكومة والمصارف معيار الذهب ، فاصدرت الحكومة ملايين الأوراق النقدية الخضراء غير القابلة للإسترداد ، وذلك لسداد التزاماتها النقدية. إن قانون المصارف الوطنية والضريبية على الأوراق النقدية الصمرفية الصادرة عن المصارف المرخصة على مستوى الولاية قد وفرا للبلاد عملة موخحدة لأول مرة في تاريخها عقب نهاية الحربز لكن مع تداول تلك الاوراق النقدية الخضراء لم تكن الولايات المتحدة في علاقاتها مع دول العالم تطبق معيار الذهب ، ذلك أن سعرها كان قابلا للتغير تجاه سعر الذهب ، وقد تغير بالفعل. وفي أواخر ستينيات القرن التاسع عشر كان شراء ما قيمته 100 دولار من الذهب يتطلب 135 دولارا من الأوراق النقدية الخضراء.
ومع ذلك فقد كانت التجارة الدولةي قائمة على معيار الضهب ، وهذا يعني أن على التجار عند الشراء من الخارج أو البيع إليه أن يشتروا الذهب لسداد قيمة التعريفات الجمركية ، وأن عليهم التوقي (أو التحوط) في سوق الذهب للحيليلوة دون تأثر أرباحهم بالتقلبات الحاصلة في سعر الأوراق النقدية الخضراء. واعتقد جاي جولد – أحد أدهى الرجال الذي عرفتهم وول ستريت في تاريخها – أنه أمام فرصة في هذه الحالة ، وفي العام 1869 قرر أن يحتكر الذهب.
وسيلة الاحتكار هذه لم تكن إلا عبر السيطرة على مجمل عرض سلعة ما – سواء أكنت أحشاء الخنازير أم أسهم إحدة شركات السكك الحديد أو الذهب – لفترة ما من الزمن. وكل من يرغب في شراء تلك السلعة في خلال تلك الفترة سيكون مضطرا إلى دفع الثمن الذي يطلبه صاحب الإحتكار أو أن يتدبر أمره من دون هذه السلعة. أما لاتجار الذين لجأوا إلى البيع على المكشوف – أي بيع ملا يملكونه توخيا لانخفاض السعلة ، تماما كما بين دانييل درو في مقولته الشهيرة :
إن علم كل من يبيع ما ليس له .. أن يشتري السغلة من جديد .. أو فليمض إلى السجن..
كانت حالات الاحتكار المقصودة شائعة في وول ستريت في ستينيات القرن التاسع عشر. وفي كل عام كانت تقع بعض الحالات الناجعة ، لكن الشروع في احتكار الذهب – جهور النظام النقدي العالمي في القرن التاسع عشر – كان تهورا ماليا لا مثيل له من قبل أو منذ ذلك الحين . فمن ناحية ، كان لدى الحكومة الفدرالية احتياطيات من الذهب بالملايين وكانت قادرة على إفشال أي محاولة احتكار متى شاءت. لكن جولد كان يعتقد أنه قادر على التعامل مع الرئيس جرانت ، ذلك الرجل الشريف الساذج.
وقد سعى إلى تعيين اللواء دانييل بترفيلد وهو من أبطال الحرب الأهلية (واتفق أن كان مؤلف البابز Taps أيضا) مساعد أمين خزانة نيويورك ، وبالتالي الرجل الذي ستصدر عنه أوامر بيع الذهب من خزائن الحكومة. ولما سئل جيمس فيسك – شريك جولد – فيما بعد إن كانت الأسلاك مراقبة للتصنت على نوايا الحكومة أجاب: "نراقب الأسلاك؟ هذا هراء! إن علينا فقط أن نصل إلى بترفيلد لنجد بغيتنا!". في هذه الأثناء ، عمل جولد جاهدا طوال صيف العام 1869 على إستمالة الرئيس جرانت كي لا يجيز بيع الذهب ، مؤكدا حاجة المزراعين الأمريكيين إلى تصدير محاصيلهم بأسعار جيدة. وفي غضون ذلك ، كان يعمل هو وحلفاءه على جمع الذهب في وول ستريت.
ولم يكن ثمة – للعجب – إلا القليل من الذهب في التداول وهي الكمية المتاحة مباشرة للسوق في لحظة زمنية معينة – أي اقل من 20 مليون دولار. كانت غرفة الذهب في وول ستريت تشهد تداولات بقيمة 70 مليون دولار في اليوم الواحد ، لكن كثيرا من تلك التداولات كان عبارة عما عرف ب"الذهب الوهمي" Phantom Gold ، أي الذهب الذي يشترى بهامش بسيط جدا من السعر الحقيقي.
ووفق شهادة أحد سماسرة وول ستريت التي يشوبها بعض المبالغة: "إذا كان لدى المرء ألف دولار ، فبإمكانة أن يمضي ويشتري ما قيمته خمسة ملايين دولار ذهبا إذا كان جادا في ذلك ". لقد كانت لدى جولد – وهو رئيس إحدى كبرى شركات السكك الحديد في البلاد – موارد كافية تماما لشراء الذهب المتداول بأضعاف كثيرة مع إنقياده وراء الشراء بالهامش وبأضعاف ما يملك.
ووصل الاحتكار ذروته في 24 سبتمبر 1869 ، الذي عرف منذ ذلك اليوم بالجمعة السوداء Black Friday ، كان هذا أول يوم في تاريخ وول ستريت – وليس الأخير – الذي تخلع عليه تسمية "الأسود". كما كان ربما أكثر الأيام إثارة في تاريخ وول ستريت على الإطلاق. كانت غرفة الذهب ذاتها في هرج ومرج بعد أن هب التجار بضراوة لحماية مصالحهم الخاصة. وفي كل أرجاء البلاد ، عطلت حركة التجارة عندما تجمع الرجال في مكاتب السماسرة والمصارف لمراقبة سعر الذهب في نيويورك يمضي إرتفاعا على شرائط أسعار السهم المتحركة وكانت أنذاك ابتكارا حديثا.
وفي الخارج – في برود ستريت – كانت الأمور أفضل حالا نسبيا . فقد نقل عن أحد شهود العيان قوله: لقد احتشد في برود ستريت بضعة آلاف من الرجال ، وفي ظرف ساعة واحدة اندفع رجال الأعمال – الذين عرفوا برزانتهم لا يرتدون معاطفهم وقد اختفت ياقات قمصانهم وكان البعض من دون قبعات – إلى الشارع ، كان نزلاء عشر مصحات عقلية قد أطلقوا من قيودهم. ومضى سعر الذهب مرتفعا بثبات وسط الصراخ والصياح والتشابك بالأيدي.
وأدرك الرئيس جرانت أخيرا ما كان يجري ، وأمرت الخزانة ببيع 4 ملايين دولار ذهبا في الحادية عشرة واثنين وأربعين دقيقة صباحا ، وقد بلغ هذا الأمر مكتب بترفيلد في غضون دقائق معدودات. وهكذا كسر الاحتكار . كان سعر الذهب محددا ب160 دولار في الحادية عشرة وأربعين دقيقة في ذلك الصباح. وفي المساء انخفض إلى 140 وظل في طور التراجع. وأوردت نيويورك هيرالد في اليوم التالي أنه "لما تبقى من ذلك اليوم كانت غرفة الذهب وجميع الممرات المؤدية إليها اشبه بمنطقة اندلعت فيها نار عظيمة أو حاقت بها كارثة مدمرة بعد أن بلغت ذروتها. وقد خيم على المشهد هدوء مفاجئ".
ولا نعلم إن كان جولد قد كسب أم خسر ذلك اليوم. لأن كثيرا من الفوضى الواقعة قد أخفيت تحت البساط ولم يكشف إلا عن القليل. لقد كانت العقود التي قومت مدفوعاتها ذهبا – وهذا شأن عقود غرفة الذهب بحكم الضرورة – غير قابلة للإنفاذ بقوة القانون لذا كان الباب مفتوحا أمام حالات الإعسار والتخلف عن سداد الالتزامات المالية من دون أن يردع ذلك أي عواقب قانونية ، وهذا ما أفضى إليه كثير من التجار. ولكن لأن احتكار الذهب كان مصدرا لهلع المشترين ، وذلك مع سعي التجار الحثيث إلى تغطية مبيعاتهم على الهامش فلم تكن ثمة عواقب طويلة الأجل على الاقتصاد عموما. ذلك أن هلع البائعين كان مئشرا في العادة إلى بدء فترات الكساد ، حيث يندفع الناس إلى التخلص من الأسهم والسندات بأي سعر وسحب نقودهم من المصارف التي لا يرون فيها أهلا للثقة والأمانة.
إن هلع البائعين يولد - بيطبيعته – ثورة مفاجئة في الطب على النقد حينما يعكف المستثمرون والامودعون على تأمين السيولة اللازمة لهم ، وبالطبع فإن النقد هو أكثر أنواع الموجودات سيولة على الإطلاق ، ولأن لم يكن ثمة مصرف مركزي مخول تنظيم عرض النقد وتفير السيولة اللازمة لحماية النظام المصرفي في أوقات شح السيولة ، فإن حالات هلع البائعيت تلك قد فاقمت كثيرا من الذبذبات الهبوطية في الدورة التجارية. لقد انهارت المؤسسات المالية ذات الملاءة المالية بالمئات هندما عجزت عن تلبية الطلب المفاجئ على النقد. وقد ذهبت تلك المؤسسات عند زوالها بمدخرات القطاع العائلي والموجودات السائلة لقطاع المشاريع.
وقد شهدت السنوات التي أعقبت الحرب الأهلية توسعا اقتصاديا هائلت ، حيث عرف عن الاقتصاد الأمريكي انتقاله إلى فترة الازدهار عقب الحروب. وتضاعفت خطوط السكك الحديد في ثماني سنوات فقط كما تضاعف إنتاج القمح أيضا. غير أنه في العام 1873 أعلن جاي كوك المصرفي الفيلاديفي الذي ابتكر حملات إصدار السندات كوسيلة للمساعدة على تمويل الحرب الأهلية وبات بذلك أشهر مصرفي في الولايات المتحدة – من دون سابق إنذار إفلاسه في سبتمبر.
وعم الهلع وول ستريت وبدأت سلسلة فشل المصارف وبيوت السمسرة – التي لم تستطع تحويل موجوداتها إلى نقد بالسرعة اللازمة – بالعشرات واضطرت بورصة نيويورك إلى تعليق عملها عشرة أيام لأنها لم تستطع الحافظ على السوق في حالة نظام ، وعصف كساد عميق في البلاد في السنوات الست التالية.
وبدأت فترات الكساد في تلك الفترة تتغلغل عميقا في الاقتصاد الأمريكي ذلك أن نسبة كبيرة جدا من السكان العاملين أصبحت تعتمد في حياتها على الرواتب المنتظمة والأسواق الوطنية. وقد كان المزارعون – الذين اتخذوا الزراعة مورد رزق لهم (العاملون لحسابهم) والذين كانوا يبيعون ما فاض على حاجتهم في السوق المحلية – قادرين على تجاوز فترات الكساد المالي بيسر نسبيا. أما العمال الصناعيون والمزارعون الذين دأبوا على الاقتراض من المصارف بضمانة المحاصيل الزراعية والبيع لشركات الحبوب الكبرى فلم يتجاوزا تلك الفترات بسلام.
لقد بدأت الشركات الصناعية والتجارية الجديدة تكتسب طابعا مؤسسيا في شكلها القانوني ، وأصبحت الشركة من الأركان الاساسية للاقتصاد الأمريكي في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بسبب الزيادة الكبيرة في حجم المشروعات آنذاك. وفي القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر كان يغلب على الاقتصاد المشاريع الفدرية والعائلة ، سواء بالملكية أو بالإدارة. وندر وجود المؤسسات التي يشغل فيها أكثر من مائة عامل. ولدى إندلاع الحرب الأهلية مع ذلك ، كان كثير من الخطوط الحديدية توظف الآلاف وكانت الشركات الصناعية تصيب نموا سريعا أيضا. لدق عمل لدى شركة باث أيرون ووركز في مين Maine – وهي أكبر أرباب العمل الصناعيين في العام 1860 – نحو 4500 عامل. ولأن خطوط السكك الحديد كانت مشروعات ذات كثافة رأسمالية مرتفعة ، فإنها كانت تعتبر من الناحية التنظيمية شركات عملاقة ومع توسع الخطوط الحديد وانتشارها عبر البلاد ، زاد حجم مورديها وعملاء الشحن لديها وتحولوا أيضا إلى شركات كبرى.
وفي أول عهد الاستقلال كان الحصول على رخصة الشركة الكبيرة يتطلب صدور مرسوم خاص من قبل المجلس التشريعي للولاياة ، هذا بالإضافة إلى الجذب السياسية الذي يكتنف ذلك. ولكن مع مطلع القرن التاسع عشر شرعت الولايات في إقرار أنظمة تأسيسية عامة تتيح للشركات من خلالها الحصول على رخصة العمل تلقائيا عن توافر شروط معينة ، وبدأت السلطة التشريعية تتنازل عن صلاحياتها في تأسيس الشركات ليس بسبب من إيثارها وغيريتها ، بل لأنها لتم تعد قادرة على معالجة الطلب المتزايد على رخص الشركات.
وفي الفترة الاستطيانية برمتها كانت ثمة سبع شركات فقط تأسست في المستعمرات البريطانية في شمال أمريكا. لكن في السنوات الأربع الأخيرة من القرن التاسع عشر تأسست 335 شركة في الولايات المتحدة حديثة العهد. وبين العام 1800 و1860 شهدت ولاية بنسلفانيا وحدها تأسيس أكثر من ألفي شركة.
وفي العام 1811 أصبحت ولاية نيويورك اول ولاية تقر نظاما تأسيسيا عاما ، لكنه كان مقتصرا على الشركات المختصة في تصنيع سلع خاصة كالمراسي والمنتجات الكتانية. واشتملت أشكال المشاريع المؤهلة للحصول على صفة "شركة" على كل أنواع مشاريع النقل والتصنيع والخدمات المالية.
لقد كان للشكل المؤسسي كثير من الأفضليات التي ميزته عن المشاركات. إذ أن المشاركات كانت تنتهي تلقائيات بمجرد وفاة أحد الشركاء ، لكن الشركات (المؤسسات) قادرة على الاستمرار إلى مالا نهاية على الرغم من أول أولى تلك الشركات لم تستمر إلى بضع سنوات. وفي المشاركة يحق لأي شريك إبرام العقود لتصبح ملزمة لكل الشركاء الآخرين. أما الشركة فيحق لها تعيين إدارة تعنى بتسيير شؤونها. ويبقى الجانب الأهم قدرة الشركة بحكم شخصيتها الاعتبارية على رفع الدعاوي القضائية وقد تكون هي نفسها عرضة لتلك الدعاوى أيضا ، وشراء الموجودات وتملكها.وهذا هو السبب الذي حمل كبير القضاة جون مارشال على نعت الشركة ب"الشخصية الاعتبارية" إذ أنها كيان "غير منظور وغير ملموس ولا وجود له إلا في نظر القانون".
ويحق للشركات أيضا الإندماج. وقد كان كثير من خطوط السكك الحديد الأوائل مشاريع محلية سعت إلى التخلص من اختناقات النقل. وكان يمولها أشخاص يعيشيون على مقربة منها ، ويشترون أسهمها ويعينيون إدارتها ويراقبون ما يجري فيها. لكن هذه الخطوط الحديد الصعيرة اندمجت على الفور في مشاريع كبيرة سعيا وراء الكفاءة واقتصاديات الحجم. لقد تاسس خط نيويورك سنترال – الذي امتد بين بوفالو وألباني – بموازاة قنال إري – في العام 1853 من اندماج تسعة خطوط محلية.
ومع زيادة حجم خطوط السكك الحديد أصبحت تلك الشركات أكثر بعدا من حملة أسهمها الذين ازدادوا عددا أيضا. وكان كثير من حملة أسهم خطوط السكك الحديد الجديدة الأكبر حجما أكثر اهتماما بالأرباح المضاربية في وول ستريت من شؤون الشركة لمصالحها الخاصة – تماما كما فعلت إدارة يونيون باسيفيك – بدلا من أن تسيرها لمصلحة حملة الأسهم. إن إيجاد طرائق لتمكين إدارة المؤسسة من العمل كأمين على المؤسسة كما هي الحالة التي آلت إليه فعلا سيقع أساس على القطاع الخاص في تلك الفترة.
ولما شارف القرن التاسع عشر على نهايته اكتسبت إحدة المشكلات الملازمة لعمل الشركات طابعا أكثر حدة، إنها المحاسبة. فقد ازداد حجم المشاريع وارتفع درجة تعقيدها وبدأ المحاسبون بابتكار المزيد من الأدوات اللازمة لتسجيل المعاملات المالية وتمكين الإدارة من معرفة وجوه إنفاق المال أو تبديده بصورة دقيقة. وقد كانت مشاريع المؤسسات العملاقة في العصر الذهبي قادرة على الظهور والاستمرار بفضل تلك الأدوات المحاسبية الجديدة. وهذا التطور الذي عرفته المحاسبة آنذاك لا يزال مستمرا إلى يومنا هذا. إذ يعد التدفق النقدي اليوم من أهم المؤشرات على أوضاح الشركات. لكن تعبير "تدفق نقدي" لم يظهر إلا في العام 1954.
ومع ازدياد الشقة بين الإدارة والمالكين ، بدأت الهوة في الاتساع بين حاجة كل طرف إلى المحاسبة. لقد أراد حملة الأسهم معلومات آنية تساعدهم على تقويم ما بحوزتهم من أسهم ومقارنة نتائج عمل شركتهم مع أداء الشركات المنافسة للوقوف على مدى إتقان الإدارة عملها. أما الإدارة – بطبيعتها – فقد سعت أما الإدارة – بطبيعتها – فقد سعت إلى أن تظهر الدفاتر المحاسبية للشركة – وبالتالي هي نفسها – في أفضل صورة ممكنة. وقد كان شائعا في القرن التاسع عشر أن يطرح أرباب الإدارة الصدق والنزاهة جانبا وأن يلجأوا إلى الإحتيال والخداع . وليس ذلك مستبعدا اليوم.
إن كثيرا من الشركات التي كانت أسهمها في التداول العام لم تنشر أرقاما بنتائج عملها على الإطلاق. وعندما طلبت بورصة نيويورك إلى شركات ديلوير ولااكونا وويسترن ريل رود أن تقدم معلومات عن أوضاعها المالية جاءها الرد بأن تلتفت إلى شأنها الخاص ولا تتدخل. وقد أخطرت البورصة بكلمات جافة مقتضبة أن "السكك الحديد لا تقدم أي تقارير .. ولا تنشر أي قوائم مالية".
وحتى عندما كانت شركة السكك الحديد تصدر تقريرا فكان من المرجح – وفق تعبير أحد معاصري تلك الفترة – "وثيقة عاطلة تماما عن المعلومات .. وكان حامل السهم يقلع عنها قبل أن يتورط". لقد طلب إلى خط حديد إري – ولأن بعض إصدارات سنداته الكثيرة كانت صادرة بضمان ولاية نيويورك – أن ترفع تقريرها السنوي إلى ولاية ألباني. لكنها كانت ستصوغ ذلك التقرير في قالب زاه كما شائت. ولم يتردد مديرو إري – وكان من أكثر خطوط السكك الحديد سوءا في الإدارة على مر التاريخ – في استخدام أساليب المحاسبة المتقنة لإخفاء تلاعبهم واحتيالهم. وكت هوراس جيريلي في العام 1870 متكهما في صحيفة "نيويورك تريبيون" أنه إذا كان التقرير السنوي الجديد لشركة إري صادفا فإن "ألاسكا ستكون ذات مناخ استوائي وستنمو الفراولة فيها".
ووضعت الصحيفة الأسبوعية "كوميرشيال آند فاينانشيال" كرونيل يدها على أصل المشكلة وتصورت حلا لها. إذ ذكرت أن "من شروط النجاح في ظل أعمال الاحتيال هذه اللجوء إلى السرية. يجب أن تتاح للعامة فرص الاطلاع على كل ما يعرفه أي مدير عن قيمة أسهمه الخاصة وفرصها المستقبلية ، وهكذا تنتهي حرفة "الإداري المضارب" Speculative Director من دون رجعة. كما لابد من إعداد ونشر المجموعة الكاملة من القوائم المالية على اساس فصلي لتظهر فيها مصادر إيراداتها وقيمها. ووجه إنفاق كل دولار .. وعوائد أملاكها . . ومصروات العمل ومستلزمات العمر والإنشاءات الجديدة وأعمال الصيانة .. ومبالغ ديونها وأشكال تلك الديون .. ووجوه التصرف بأموالها جميعا".
وتبنت وول ستريت هذه الفكرة الجديدة من دون تردد. ففي نهاية المطاف كان السماسرة والصيارفة في حاجة إلى معرفة القيمة الحقيقية للشركة تماما كحملة الأسهم. لقد قاد هنري كلوزوهو سمسار واسع النفوذ في حقبة ما بعد الحرب الأهلية الجهود الرامية إلى نشر تقارير دورية واعتماد مدققي حسابات مستقلين تعهد إليهم مسألة إبداء الرأي حول دقة تلك التقارير. وشرعت مصارف وول ستريت الكبرى – التي كانت تكسب مزيدا من القوة والنفوذ – وبورصة نيويورك بالطلب من الشركات التي كانت في حاجة إلى رأس المال أو ترغب في إدراج أسهمها في البورصة أن تلبي متطلبات ما سيعرف فيما بعد ب"المبادئ المحاسبية المقبولة عموما" (مبادئ المحاسبة المتعارف عليها). وأن تعرض دفاترها المحاسبية على مدققي حسابات مستقلين لتصديقها.
ولم يكن معظم المحاسبين سوى موظفين يعملون لدى قطاع الشركات قبل الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. وحتى العام 1884 لم يكن ثمة سوى 81 محاسبا مهنيا مستقلا مسجلين في دليل معلومات المدينة (شئ من قلبيل دليل الهاتف في القرن التاسع عشر) في مدن مثل نيويورك وفيلادلفيا وشيكاغو ، وبعد خمس سنوات فقط وصل العدد إلى 322 ن كان أولئك المحاسبون قد شرعوا في تنظيم أنفسهم. وفي العام 1882 تأسس معهد المحاسبين وماسكي الدفاتر في نيويورك ، وبدأ إصدار شهادات مهنية لكل من يجتاز امتحاناته الصارمة. وفي العام 1887 تاسست الجمعية الأمريكية للمحاسبين العامين وهي الجمعية الأم التي تقوم عليها الجهاز الرئيسي المنظم لمهنة المحاسبة اليوم.
وفي العام 1896 أصدرت ولاية نيويورك تشريعا يقضي بوضع الأساس القانوني لهذه المهنة الجديدة واستخدام عبارة المحاسب القانوني CPA - وذلك بحكم المصادفة – لأول مرة كلقب يمنح لأولئك الذين حققوا الشروك القانونية للمهنة . وقد اقتبس هذا التشريع وذاك اللقب سريعا في ولايات أخرى. وعندمات نشبت الحرب العالمية الأولى كان هذا النظام قد عم الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي.
ومع ذلك لم تدخل مبادئ المحاسبة المتعارف عليها والمحاسبون المستقلون في أحد القطاعات المالية الرئيسية: القطاع الحكومي. وبالفعل وبعد مرور قرن من ذلك الزمان لم تكن معظم حكومات الولايات – وهي التي كانت تفرض على الشركات العاملة فيها الالتزام بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها – تلتزم هي نفسها بهذه المبادئ. وكانت الحكومة الفيدرالية – وهي أكبر جهاز مالي على وجه البسيطة – لا تزال تمسك دفاترها المحاسبية بالأسلوب الذي انتهجته في القرن التاسع عشر . وفي ظل غياب ما يقيم التوازن – مثل مصارف وول ستريت والبورصة – لممارسة الضغط اللازم كان القيمون على شئون الحكومة – المشرعون والحكام والرؤساء – قادرين على تقويم مصالحهم الشخصية على مصالح "حملة الأسهم".
ومع تنامي حجم الشركات الصناعية وانتشارها ازدادات حاجتها إلى رؤوس الأموال أيضا. لكن البريطانيين لم يقدموا رأس المال هذه المرة – بعد أن كانوا بلا منازع أهم الممولين في حقبة ما بعد الحرب الأهلية ، إنما قدمته وول ستريت عبر مصارفها الاستثمارية المتسارعة نموا. ولم يجسد أحد مركز القوة الجديد في وول ستريت خيرا من أبرز مصرفييها آنذاك ، جي بو مورجان.
ولقد مورجان – على خلاف كثير من أساطين المال في العصر الذهبي – لأسرة غنية من هارتفورد بكونيكتيكت في العام 1836 ، وكان جده مؤسس شركة أيتنا Aetna المتأمن عليها ضد الحريق ، وقد استمثر أمواله في السكك الحديد والمراكب البخارية والعقارات حين صارت هارتفورد من أغنى المدن – وفق حصة الفرد – في البلاد جميعا. واصبح والده جونيوس سبنسر مورجان مشاركا في شركة الصيرفة الأمريكية جوجر بيبودي ومشاريكه في لندن في خمسينيات القرن التاسع عشر . واشترى الشركة بعد تقاعد بيبودي فغير إسمها إلى جي إس مورجان ومشاريكه. وتحولت الشركة سريعا إلى أحد أهم بيوت الصيرفة الدولية.
وسافر مورجان مرات عديدة في أوروبا عندما كان طفلا ، فزار المتاحف الكبيرة التي لم يكن في الولايات المتحدة ما يضارعها آنذاك ، ونما لدية شغف عميق بالفن. لقد تحدث الفرنسية والألمانية بطلاقة ، إذ كان حسن الثقافة ، واختلف مورجان إلى جامعة جوتينبرج في ألمانيا في زمن لم يكن يذهب فيه إلا قلة من أبناء جيله من الأمريكيين إلى الكليات في سبيل تعلم أصول العمل التجاري.
وهكذا ترعرع مورجان في عالم أرحب كثيرا من ذلك الذي ترعرع فيه معظم أبناء جيله، وكان واسع الإطلاع على الصيرفة الدولية بأعلى مراتبها منذ كان طفلا. وقد اعتقد – وكان متأثرا جدا بوالده والسيدي بيبودي – أن النزاهة الشخصية ركيزة أساسية للنجاح في العمل المصرفي. وفي آخر أيامه سئل في إحدى جلسات الكونجرس : "أليس أساس منح الاتئتمان التجاري ضمانة مالية أو ملكية؟"، فأجاب: "لا يا سيدي . . إن الشخصية تأتي في المقام الأول".
"قبل المال أو الملكية؟"..
فجاء جوابه مؤكدا: "قبل المال أو الملكية أو أي شيء آخر".
"إذا انها لا تشترى بالمال. لأجل الرجل الذي لا أثق به لن يحصل مني على المال ولو كان نظير كل الضمانات التي يمكن أن توجد في العالم الغربي".
وفي سبعينيات القرن الثامن عشر حقق مورجان لنفسه موطئ قدم راسخا في وول ستريت ، وأصبح شريكا في شركة مرموقة هي دريكسل مورجان ومشاركوهم ، الكائنة عند الزاوية الجنوبية الشرقية من وول ستريت وبرود ستريت ، حيث كام مصرف مورجان قائما منذ ذلك الحين. لقد تفوق مورجان سريعا على مصرفيي وول ستريت الآخرين.
وفي العام 1787 أراد ويليام فاندربيلت تنويع استثماراته – بعد أن ورق القسم الأكبر من شركة نيويورك سنترال ريل رود ، لكن بيع جزء كبير من شركة بسمعة ومكانة نيويورك سنترال من دون التأثير سلبا في سعر السهم لم يكن بالمهمة السهلة إطلاقا.
وتصدى مورجان لهذه المهمة – مع ذلك ونجح في بيع 150 ألف سهم في لندن بسعر جيد جدا بلغ 120 دولار للسهم. وقد تدبر أن ينجز المهمة بهدوء بالغ من دون أن يشعر بها أحد. واعتبر ذلك عملا متقنا من اكتتابات الأسهم ، لا بل أنه جعل مورجان قوة كبرى في قطاع السكك الحديد في الولايات المتحدة عندما فوض إليه المساهمون الإنجليزي الجدد تمثيلهم في التصويت وفي عضوية مجلس إدارة الشركة.
واعتزم مورجان استخدام نفوذه الجديد في إرسء النظام في قطاع السكك الحديد ، الذي كان في حاجة ماسة إلى ذلك. كانت ثمة في ذلك الوقت بضعة خطوط صغيرة لا تزال تعمل بمفردها ، مع أنها لم تكن بسبب حجمها قادرة على الإفادة من اقتصادات الحجم أو استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا. ولأن معظم الخطوط الرئيسة قد تشكلت من اندماج عدد من الخطوط الصغيرة فقد كانت هياكل رأسمالية بالغة التعقيد.
كما انخرطت الخطوط الحديد في منافسة ضارية نجم عنها في بعض الأحيان إفراط في تأسيس الخطوط الجديدة كانت مصدرا للهدر وانتهى أحيانا إلى نتائج كارثية. لا بل إن خط حديد بنسلفانيا وخط حديد نيويورك سنترال العملاقين كان كل منهما في منافسة ضارية مع الآخر. كانت بنسلفانيا تمد خطا على الجانب الغربي من نهر هسدون ينافس خط شركة سنترال التي كانت خطوطها الرئسة تقع على الجانب الشرقي من النهر. كما أ، شركة سنترال بدورها كانت تمد خطا جديدا يحاذي خط شركة بنسلفاينا عبر جبال كما أ، شركة سنترال بدورها كانت تمد خطا جديدا يحاذي خط شركة بنسلفاينا عبر جبال إليجني الوقاعة في تلك الولاية.
وقد حصل مورجان على موافقة كلتا الشركتين بالتفاوض ، فدعا رئيس كل شرعة إلى محادثات على متن يخته العملاق كورسير ، وبينما كان كورسير يذرع نهر دسون صعودا وهبوطا بين نيويورك وويست بوينت حمل مورجان الطرفين على التخلي عن خطوطهما الزائدة ، (وهذا تم التخلي عن الأنفاق التي حفرت في جبال بنسلفانيا لمصلحة شركة نيويورك سنترال وأدمجت بعد سبعين عاما في نظام الطرق الرئيسية في بنسلفانيا). وارتفع شأن مورجان كثيرا بعد اتفاقية كورسير وحققت شركته بفضل ذلك كثيرا من الأعمال التجارية الجدية ذات الأرباح العالية.
وعلى الرغم من أنه كان مصرفيا وليس خبيرا في السكك الحديد ، فقد أصبح على الفور أقوى أقطاب الصناعة ، حين أعاد تنظيم خطوط في "بالتيمور وأهايو" و"تشيزبيك وأوهايو" وإري وغيرها من الخطوط الحديد الرئيسية في تلك السنوات. ومع ظهور هياكل تنظيمية وشركات سكك حديد أكثر رشادا ، صارت تلك الشركات تتمتع بمتسويات أعلى كثيرا من الكفاءة الاقتصادية. وعين مورجان شركاه في جي بي مورجان ومشاركيه في مجالس تلك الشركات ليضمن ألا تنحدر الخطوط سواءا إلى سابق عهدها. وقد خضع ثلث خطوط السكك الحديد في الولايات المتحدة لإعادة تنظيم ، وهذا كانت أيضا حال الرقابة على مصارف وول ستريت في العقدين الأخيرين من القرن. أما نتاج ذلك فكان صناعة أكثر نضجا واستقرارا.
كان توسع الخطوط الحديد الأمريكية في الفترة التي أعقبت الحرب الأهلية حدثا استثنائيا. وبفضل 30.626 ميلا من الخطوط الحديد في العام 1860 كان لدى الولايات المتحدة نظام سكك حديد هو الأكبر في العالم أجمع. ولكن هذا الرقم ارتفع في العام 1870 إلى 52.922 ميلا ، وفي العام 1880 إلى 93.262 ميلا والعام 1890 إلى 166.703 أميال ، أما في العام 1900 فبلغ هذا العدد 193.346 ميلا أي ما يتجاوز ستة أضعاف في أربعين عاما فقط. وفي وقت ارتفعت فيه قيمة السلع المصنعة سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 17 ضعفا بين العامين 1865 – 1916 فإن معيان "الحمولة – المسافة" السنوية للسكك الحديد ارتفع خمسة وثلاثين ضعفا.
وفي نهاية القرن ربطت الخطوط الحدي أواصر اقتصاد صار آنذاك وطنيا خالصا في نطاقه ، وكانت السكك الحديد تصل تقريبا إلى كل المدن الصغيرة مهما كان حجمها. أما المدن الكبرى فكانت تمر عبرها عدة خطوط. لكن شبكة الخطوط الحديد الجديدة خلقت مشكلة جديدة – مع ذلك – مشكلة لم تكن إطلاقا في الحسبان. إن حساب التوقيت كان دائما شأنا محليا يتحدد وفق وقت الظهيرة المحلي ، الذي كان مثلا في خط العرض المار بمدينة نيويورك يحدد بدقيقة تضاف إلى كل أحد عشر ميلا يقطعها المرء غربا. وعلى ذلك فإذا كان الوقت في نيويورك منتصف الظهيرة ، فإن الساعة تكون 11.55 صباحا في فيلادلفيا و 11.45 صباحا في واشنطن و11.35 صباحا في بستبرة. لقد اعتمدت ولاية إيلوني سبعا وعشرين منطقة زمنية مختلفة ، بينما بلغ عدد المناطق الزمنية في ولاية ويسنكن ثمانيا وثلاثين.
وفي وقت كان السفر فيج ينجز بسرعة الصحان ، لم تكن مسألة التوقين مسألة ذات شأن ، ولكنها باتت مشكلة ملحة عندما ظهرت السكك الحديد ، حيث كان تنظيم رحلاتها عملا مرهقا . لقد تردد الكونجرس سنوات في التصدي للمشكلة – وذلك خشية من ردود فعل السكان المحليين – ولذلك فقد عملت شركات الخطوط الحديد على إيجاد حلولها الخاصة . ففي العام 1883 أرست تلك الشركات توقيتا موحدا بقسم بموجبه البلد إلى أربع مناطق زمنية هي الشرقية والوسطى والجبلية والباسيفيكية (منطقة الهادئ) ، حيث حدد منتصف الظهيرة بساعة تفصل بين كل منطقة وأخرى. وفي 18 نوفمبر 1883 بدأت الخطوط الحديد في الولايات المتحدة العمل بهذا التوقيت الموحد. وبينما ثارت اعتراضات تدعو إلى أن يعتمد البلد التوقيت الإلهي وليس توقيت فاندربيلت ، فإن التوقيت الموحد أضحى في غضون بضع سنوات توقيتا موحدا بالفعل ، وصار من الصعب تصور العالم من دون ذلك التوقيت.
إن قدرة الخطوط الحديد على فرض شأن جوهري جدا كالتوقيت الموحد مؤشر على مدى القوة التي بلغها في أواخر القرن التاسع عشر. كان قطاع السكك الحديد أكبر قطاعات الاقتصاد من دون منازع. فلقد وظف هذا القطاع أكثر من مليون عامل في العام 1900 من أصل 76 مليون نسمة هو مجموع عدد السكان ، وكان هؤلاء يكسبون دخلا وسطيا قدره 576 دولار للعامل سنويا. ولأنها كانت تقوم أساسا على جهد الإنسان ، فإن الخطوط الحديد بطبيعتها لم تتردد في إستخدام نفوذها في السوق لتحقيق مصالحها الخاصة.
وقد طورت السكك الحديد نظاما للخطوط الرئيسية والفرعية ، وذلك بخط رئيس يصل المدن الكبرى بكثير من الخطوط الفرعية بين التجمعات السكانية الصغيرة. وقد كانت هناك منافسة حادة على هذه الخطوط الرئيسة. إذ يمكن للمرء الاختيار على الطريق بين شيكاغو ونيويورك مثلا بين خط نيويورك سنترال وخط بنسلفانيا وخط إري. أما على الخطوط الرئيسية فقد كانت شركة الخطوط الحديد تختار ما بين المنافسة الضارية على السوق أو بين إجراء تخفيضات جائرة جدا على الأسعار أو إنشاء اتحادات احتكارية (:ارتلات) لتقاسم العمل ووضع الأسعار. لكن هذه الاتحادات لم تصمد طويلا بسبب غياب آليات تنفيذ القانون.
وكانت معظم الخطوط الفرعية قائمة على احتكارات وكانت الخطوط الحدي قادرة – ومعظمها استطاع فعلا – أن تزيد أرباحها بفرض اسعار أعلى على هذه الخطوط الفرعية ، وكانت الأسعار أحيانا باهظة جدا.
لكن المسافرين كانوا – ولا عجب – مستائين من تلك الأسعار . فقد تحولت حركة الجمعيات الزراعية التعاغوينة – الجمعية التعاونية الوطنية لحماية الزراعة – التي بدأت في العام 1867 كؤسسة اجتماعية وتعليمية إلى مؤسسة تدافع عن حقوق المزارعين في وجه شركات السكك الحديد. ومع حلول العام 1875 كان ثمة عشرون ألف مزرعة تعاونية في جميع أرجاء الغرب الأوسط تضم ثمانمائية ألف عضو معظمهم يحمل كراهية شديدة لشركات السكك الحديد المحلية.
إن حركة بهذا الحجم – بالطبع – قد استقطبت اهتمام السياسييين في عواصم الولايات الذين شرعوا في تنظيم عمل السكك الحديد فشكلوا لجانا لمراقبة هذا القطاع التجاري. لكن هذه اللجان ثبت عدم ناجعتها ، ومن أسباب ذلك أن ناشظي جماعات الضغط المدافعة عن مصالح الخطوط الحديد – وهم من الناشطين البارزين جدا – اعتبروا ذلك تقييدا كبيرا لصلاحياتهم.
وكانت هذه اللجان في الأغلب مجرد غطاء سياسي للسماح لشركات السكك الحديد بأن تفعل ما يحلو لها. وفي العام 1895 كتب أحد نقاد لجنة خط حديد كاليفورنيا أن "الحقيقة الغريبة تبقى أن الجهاز الذي شكل قبل ستة عشر عاما خلت لغاية واحدة هي الرقابة الصارمة على إحدى شركات الخطوط الحديد (سنترال باسيفيك) وبيد من حديد. تبين أن ذلك الجهاز كان خلال تلك الفترة كلها المدافع عن تلك الشركة والحامي لها".
وقد تبين فورا أن الولايات – كل على حدة – غير قادرة على بذل الكثير للوصول إلى تنظيم فعال للسكك الحديد التي انتشرت آنذاك في كثير من الولايات. وعندما قضت المحكمة العليا في العام 1886 في قضية "خط حديد واباش ضد إلينوي" أن ليس للولايات سلطة على خطوط السكك الحديد التي تنقل السلع عبر حدودها تحول الصراع على تنظيم السكك الحديد – بطبيعة الحال – إلى واشنطن.
كان الكونجرس آنذاك أمام المشكلة السياسية نفسا التي واجهتها المجالس التشريعية في الولايات. إذ كانت ثمة عشرات آلاف الأصوات المؤيدة للمزارعين وصغار التجار والصناعيين ومئات آلاف الدولاات دعما للسكك الحديد.
وكان أن تمخضت "الطبخة" السياسية العاصفة – على حد تعبير أحد المؤرخين – عن "صفقة لا غلبة فيها لمصحلة طرف على آخر ..باستثناء مصلحة المشرعين بنبذ هذا الصراع من فوق عواتقهم وتوكيله إلى إحدةى اللجان والمحاكم". وكان الاقتراح الوحيد الذي حظي باهتمام جدي يقضي بتشكيل لجنة السكك الحدي الفدرالية على غرار تلك المفوضيات التي عملت على مستوى الولاية وكان مصيرها الفشل".
ولم يكن لدى خطوط السكك الحديد أي اعتراض باعتبار ا، مصالحها قد أخذت بالاعتبار كما كانت تشاء. وبالفعل فقد ذكر نائب رئيس شركة بنسلفانيا للخطوط الحديد في العام 1884 أن أغبية خطوط السكك الحديد في الولايات المتحدة ستكون مقتنعة بأن يتسنى للجنة السكك الحديد أن ترفع الأسعار فوق التعريفة الحالية بما يضمن لها تحقيق 6 في المائة كأرباح أسهم ، وأنا لا أشك – مع وجود هذه الضمانة – في أن تلك الشركات ستكون مستعدة عن طيب خاطر لتخضع لرقابة الحكومة الوطنية وإدارتها المباشرة".
إن ما كانت الخطوط الحددي تسعى إليه – بكلمة أخرى – هو تأسيس كارتل تدعمه الحكومة ويكون مخولا بالتصرف ، فيحل مكان تلك الكارتلات الخاصة التي كان مصيرها الفشل دائما.
لقد اشترط مشروع القانون الصادر أخيرا – والذي قضى بانشاء لجنة التجارة بين الولايات – أن تكون "كل الرسوم معقولة وعادلة". لكنه سكت عن تفسير المقصود بذلك. كما أنه منع فرض تعريفات مختلفة على الخطوط الرئيسية والفرعية سواء أكان ذلك للرحلات القصيرة أم الطويلة. لكن تلك اللجان كان عليها اللجوء إلى المحاكم لإنفاذ أوامرها. ولم تجد السكك الحديد كبير عناء في الالتفاف على القوانين الجديدة كلما وجدت حاجة إلى ذلك. حتى على الرغم من ان لجنة التجاة بني الولايات قد نالك الدعم اللازم في العقد التالي وارتقت سريعا إلى ما أرادته شركات الخطوط الحديد منها في المقام الأول ، أي ان تكون كارتلا تدعمه الحكومة يكون قادرا على إنفاذ أحكامه بنفسه. ولا غرابة في ذلك ، خصوصا أن معظم خبراتها الفنية كان يجب تأمينه – بالضرورة – من قطاع السكك الحديد نفسه ، وهي مشكلة عانتها كل الأجهزة الرقابية الحكومية منذ ذلك الحين.
ومع ذلك وبغض النظر عن أوجه قصورها فإن لجنة التجارة بين الولايات شكلت نقطة تحول كبيرة في تاريخ الاقتصاد الأمريكي . فلأول مرة كانت الحكومة الفدرالية تحاول تنظيم أحد قطاعات ذلك الاقتصاد.
أحداث كثيرة مع ذلك كانت تلوح في الأفق خصوصا أن المقاصد والنتائج – بالنسبة إلى لجنة التجارة بين الولايات – لم تكن في وفاق دائم . على الأقل على المدى القصير. وفي العام 1890 ، أقر الكونجرس – وكان لا يزال تحت ضغوط تنادي بكبح نفوذ السكك الحديد – قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار. كان كلا مجلسي الكونجرس في ذلك العام يغلب عليه الجمهوريون المؤيدون لحرية التجارة ، وكان أحد أعضاء الحزب الجمهوري – بنجماين هاريسون – سيد البيت الأبيض ، لكن قانون شيرمان أقر ولم يعارضه إلا صوت واحد ، فصدر رسميا كقانون.
كان السبب – كما عرف عن هذا القانون – أنه لم يورد تفاصيل كثيرة ، وقد نص على أن "كل عقد يشتمل على إحدى صور الاحتكار أو ما إلى ذلك. يعد بموجب هذا القانون غير شرعي". كما أ،ه جرم "إحتكار أو محاولة احتكار .. أو الاندماج أو التواطؤ في سبيل احتكار أي شكل من أشكال التجارة أو التبادل بين الولايات".
لقد أكدت الإدارات الأمريكية زمن الرؤساء هاريسون وكليفلاند ومكينلي – ومعها المحكمة العليا التي أنتهجت طريقا محافظا جدا في تسعينات القرن التاسع عشر – أن قانون شيرمان لن يستمر في سنواته الاولى . ولكن على حد تعبير المؤرخ تشارلز وارين ساعد قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار على تنبيه "الكونجرس إلى حقيقة الصلاحيات الواسعة التي تتضمنها فقرة التجارة". وسيفيد منها أحد الرؤساء الناشطين في العقد التالي لجعل الحكومة الفدرالية طرفا أساسيا في تنظيم الاقتصاد الأمريكي.
وعليه – وقبل وفاته في العام 1913 – فإن جي بي مورجان – الذي قاد الحركة الساعية إلى مطالبة الشركات بتوحيد أساليب مسك الدفاتر واعتماد مدققي الحسابات المستقلين في مراجعة تقاريرها المالية – سيشكو من أن ثيودور روزفلت قد توقع من الناس مزاولة العمل التجاري "بشفايفة تامة" (بجيوب زجاجية). وعلى غرار معظم الناس – سواء من هم في الحكومة أو من يزاولون التجارة – فقد قدر عاليا قيمة الشفافية في علاقات الآخرين أكثر مما رآها في علاقاته الخاصة.
العصر المذهب
 مقالة مفصلة: العصر المذهب
مقالة مفصلة: العصر المذهب
كان الفولاذ السمة المميزة لاقتصاد أواخر القرن التاسع عشر في العالم الغربي . فقد أصبح انتاجه مقياسا للقوة الصناعية للبلد ، وكانت استخداماته لا تحصى إذا جاز القول. أما تأثيره فكان كبيرا في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسكك الحديد والعقارات. لكن الفولاذ لم يكن ابتكار ذلك الزمان. إذ أنه ظهر في الواقع قبل ثلاثة آلاف عام ، ولم يكن ثمة جديد الآن سوى تكلفة إنتاجه.
ذلك أن تماسيح الحديد - وهي أول مرحلة إنتاج الفولاذ والحديد – تحول إلى سبائك حديد بإعادة صهرها ومزجها مع الجير الأرضي لإازلة الشوائب الباقية. ويصنع الحدي الصلب بعد ذلك بصبع في قوالب لانتاج أدوات مثل القلايات ومواقد الطبخ وقضبان البناء. ولقد استخدم الحديد الصلب كثيرا في عمليات الانشاء في المدن في فترة ما قبل الحرب ، لكنه كان يعاني نواحي قصور حادة. فبفضل قوته الهائلة عند ضغطه كان الحديد الصلب يستخدم في إنتاج أعمدة محكمة القوة. لكن ولأنه سريع الانكسار ولا تيحمل التوتر فإنه لم يكن يصلح لصناعة العوارض ، التي يناسبها الحديد المطاوع.
يستخرج الحديد المطاوع بصهر تماسيح الحديد ، وتحريكها باستمرار إلى أن تعطي مركبا عجينيا متجانسا بعد تطاير معظم الشوائب منها. ولقك كان العمال الذين اشتغلوا على أفران الصهر يعرفون "بالمسوطين Puddlers". كان المسوط على قدر عالي من المهارة ويتقاضى أجورا مرتفعة. وبعد إزالة المعدن من فرن التسويط كان يخضغ للضغط ثم يلف ثم يطوى مرات عدة – كان في الواقع يعجن كعجينة الخبز – إلى أن يكتسب خاصية التليف (التحول إلى خيوط) التي تجعل الحدي المطاوع أقل تهشما من الحديد الصلب ، وبالتالي أكثر تماسكا وصلابة في حالات الضغط والتوتر. ويعتبر الحدي المطاوع لدنا تماما بالمقارنة مع الحديد الصلب ، لكنه بالمقابل يتمتع بقالبلية للسحب والطرق فيأخذ أشكالا عدة ، تماما كالنحاس.
كان الحديد المطاوع – بطبيعة الحال – أعلى تكلفة في الانتاج من الحديد الصلب ، لكنه كان صالحا لصنع العوارض والجسور والسفن وأكثر غنى لاقتصاد القرن التاسع عشر بعد العام 1830 ، وبالتحدي لقطاع السكك الحديد . إذا لم تكن الثورة الصناعية لتبلغ ذروتها من دور توافر الحديد المطاوع بكميات كبيرة.
إن للفولاذ – الذي هو عبارة عن حديد مؤشب بكمية مناسبة من الكربون تحت شروط مناسبة – خصائص جيدة تجمع بين خصائص الحديد الصلب والحديد المطاوع. فهو يتمتع بالصلابة والقوة كالحديد الصلب وقابل للطرق والسحب ويتحمل الصدمات كالحديد المطاوع. وهو أشد كثيرا في ظروف الشد والتوتر من كلا هذين النوعين من الحديد ، لذلك فإنه يمثل مادة للبناء لا تضاهى.
لكنه وحتى منتصف القرن التاسع عشر كانت السبيل الوحيدة لصناعة الفولاذ هي الحصول على أكباش أو قطع صغيرة من الحديد المطاوع ومزجها بالكربون وتسخين المزيج لبضعة أيام. لذلك كان استخدامه محصورا في صناعة الأدوات ذات القيمة العالية كنصول السيوف والشفرات والعدد ، حيث كانت قابليته لامتصاص الصدماء وإمكان شحذه والحصول على أطراف حادة مسوغا لتكلفته العالية . وفي منتصف القرن كانت اوروبا تصنع ما يقارب من 250 ألف طن من الحديد بالطرق التقليدية ، بينما لا يصنع منه سوى 10 آلاف طن في الولايات المتحدة.
ومن ثم وفي العام 1856 ابتكر انجليزي يدعى هنري بسمر (السير هنري فيما بعد) محول بيسمبر الذي ساعد على صناعة الفولاذ مباشرة من تماسيح الحديد. وكما هي الحال غالبا في تاريخ التطور التكنولوجي ، فقد كانت اللمعة الأولى وليد الملاحظة العرضية. فقد طور بيسمير شكلا جديدا من قذيفة المدفعية ، لكن المدافع المصنوعة من الحديد الصلب في تلك الأيام لم تكن بالقوة الكافية لاستيعات تلك القذائف . وبدأت التجارب تجرى أملا في الخروح بمعدن أوقى وأشد. وذات يوم اتفق أن تيارا من الهواء هب على حديد مصهور ، وقد عمل الأكسجين الموجود في الهواء – بعد أن تفاعل مع الحديد والكربون في المعدن المنصهر – على رفع درجة حرارة المعدن وتطاير الشوائب منه. كما طر معظم الكربون ، ولم يبق إلا الفولاذ.
وهكذا انكب بسمر – بعد أن أدرك ما حدث – على تطوير عملية صناعية تحاكي مشاهداته العرضية. كان المحول الذي ابتكره عبارة عن وعاء كبير بعرض عشر أقدام وارتفاع عشر أقدام مزود بمرتكزات للدورات (مبارم) تسمح بتفريغ محتوياته إلى الخارج. كان مصنوعا من الفولاذ وينتظمه آجر حراري.وفي القاعدة يمكن نفخ الخواء عبر الثقوب في الآجر الحراري إلى "الحشوة" أو كتلة المعدن المنصهر في البوتقة ، ليتحول إلى فولاذ في تيار هوائي شديد قوامه اللهب والحرارة. وبفضل محول بيسمير أمكن تحويل ما بين عشرة أطنان وثلاثين طنا من تماسيح الحديد إلى فولاذ كل إثنتي عشرة دقيقة إلى خمس عشرة دقيقة في واحدة من أشهر العمليات الصناعية على الإطلاق.
وكتب الناشط العمالي جون إي فيتش في العام 1910 أن "ثمة إعجابا شديدا بآلية صناعة الفولاذ. إذ أن الحجم الهائل للأدوات ونطاق الانتاج يشده العقل بحس غامر من القوة. لقد فغرت أفران النفخ الشرهة أفواهها – وكانت تبلغ ثمانين أو تسعين أو مائة قدم ارتفاعا – دائما لابتلاع طن إثر آخر من فلز الحديد والوقود والحجارة. لقد بهرت محولات بيسمبر العين بألسنة اللهب المتطايرة منها. كانت قوالب الفولاذ بحرارتها التي وصلت إلى درجة الإبيضاض ووزنها البالغ آلاف الأرطال ، كانت تحمل من مكان إلى آخر وتلقى جانبا كأنها دمى خفيفة. وكانت الرافعات تلتقط عوارض الفولاذ بطول خمسين قدما بخفة ورشاقة كأن أطنانها كانت أرطالا ليس إلا. وهذه هو ما يسحر عين الزائر لورش فولكان Vulcan".
كان أحد زوار ورش صناعة الفولاذ التي يملكها هنري بسمر في شفيلد بانجلترا العام 1872 شاب اسكتلندي هاجر إلى أمريكا اسمه أندرو كارنيجي. لقد تاثر كثيرا – إلى درجة أنه في السنوات الثلاثين التالية سيركب موجة الطلب المتصاعد على الفولاذ ليصبح أحد أغنى أثرياء أمريكا.
لقد ولد كارنيجي في دنفرملاين على بعد بضعة أميال شمال غرب إدنبرة في منطقة فيرث أوف فورث في العام 1835 ، كان والده حائكا يدويا يملك نوله الخاص وينسج عليه الدمقس بتطاريز آية في الروعة والجمال. وكانت دنفيرملاين مركزا لتجارة الدمقس ، حيث كان الحاجة المهرة من أمثال ويليام كارنيجي يكسبون دخلا جيدا من أعمالهم.
لكن الثورة الصناعية قضت على مصدر رزق وليام كارينجي. إذ مع حلول أربعينيات القرن التاسع عشر أصبحت الأنوال الآلية نتج الأقمشة والمنسوجات كالمدقس بتكلفة تقل كثيرا عن تكلفة الأنوال اليديوة. ومع أن عدد الحاكة الأنوال اليدوية بلغ 84.560 في اسكتلندا في العام 1840 فإن هذا القرم سيتراجع بعد عشر سنوات إلى 25 ألفا. ولن يكون ويليام كارنيجي واحدا من هؤلاء.
وانتهى كارنيجي الأب إلى شفير اليأس والقنوط وهبت زوجته – وكانت أكثر تصميما وعنادا – لمواجهة الأزمة بنفسها. لقد تلقت رسالة من أختها – التي هاجرت إلى أمريكا منذ زمن – واستقرت في بتسبرة. وجاء في رسالتها: "هذا البلد أفضل كثيرا للعامل الحرفي من بلدنا الأم وثمة متسع كاف وزيادة ، على الرغم من الألوف التي تقاطرت على عتباته". وفي العام 1847 عندما كان أندرو في عمر الثانية عشرة انتقلت عائلة كارينجي إلى بتسبرة.
كانت عائلة كارنيجي من العائلات التي واكبت أكبر أكبر موجة من الهجرة الجماعية في تاريخ البشرية ، وعرفت باسم هجرة الأطلسي. في البدء كان معظم المهاجرين ينحدرون من الجزر البريطانية ، خصوصا إيرلندا بعد بداية المجاعة العظيمة في أربعينيات القرن التاسع عشر. وفيما بعد قدمت ألمانيا وايطاليا وأوروبا الشرقية أعدادا هائلة من المهاجرين تجاوزت المليونين في العام 1900 وحده.
إن الهجرة الأطلسية تضاهي بحجمها وأهميتها هجرات البربر في العصور الكلاسيكية المتأخرة التي أفضت إلى نهاية الإمبراطورية الرومانية . لكن ، على الرغم من أن كثيرا من القابئل البربرية قد دفعت إلى الهجرة بضغط من القبائل التي استولت على أراضيها ، فإن المهاجرين الذين ربا عددهم على ثلاثين مليونا وعبروا المحيط الأطلسي للاستقرار في أمريكا بين العامين 1820 – 1914 إنما شدهم إلى هناك بريق الفرص الاقتصادية.
وقد انتقل كثير من المهاجرين – كالاسكندنافيين الذين ضاقت عليهم الارض واستقروا في الغرب الأوسط الأعلى – إلى المناطق الريفية وأقاموا لهم مزارع فيها. لكن معظمهم – على الأقل في بادئ الأمر – استقر في المندن الأمريكية المزدهرة ، في الضواحي المتسارعة انتشارا وقد باتت تعرف "بأحياء الفقراء" (ظهرت هذه الكلمة في بريطانيا وأمريكا نحو العام 1925). ولأول مرة في التاريخ الأمريكي ، كان جزء كبير من السكان في عداد الفقراء . لكن معظم فقراء المناطق الحضرية لم يظلوا في براثن الفقر طويلا.
أحياء الفقراء تلك كانت – بالمعايير الحالية – مروعة لا يمكن تصورها .. بمساكنها التي تعشش فيها الجريمة والهوام والحشرات .. والتي لا تعرف الشمس إليها سبيلا. كانت تؤوي كثيرا من الناس وأحيانا عائلات عدة في غرفة واحدة. وكانت كنفها (مراحيضها) مشتركة خلف الأبنية. وفي إحصاء العام 1900 عندما تحسنت ظروف الحياة في الأحياء الفقيرة كثيرا عما كانت عليه في منتصف القرن ، بلغ عدد سكان إحدى الضواحي في الطرف الشرقي الأدنى من نيويورك أكثر من خمسين ألفا ، ومع ذلك فلم يكن فيها إلا نحو خمسمائية حمام فقط.
هذه السكنى لم تكن – على الرغم من هذا – أسوأ ، بل كانت أحيانا أفضل من تلك التي خلفها وراءهم المهاجرون المعدمون من أوروبا. وعلى حد تعبير شقيقة السيدة كارنيجي – وملايين من أمثالها – في رسالتها إلى موطنها الأصلي ، فقد كانت الفرص الاقتصادية أعظم كثيرا. ولم يتراجع نقص الأيدي العالمة وهو مسة ملازمة للاقتصاد الأمريكي منذ أيامه الأولى. لذلك فإن العائلة المهاجرة لم تقم في أسوأ أحياء الفقراء أكثر من خمس عشرة سنة بالمتوسط ، قبل أن يتسنى لها الانتقال إلى سكن أفضل في أحياء أفضل حالا ، والبدء بالارتقاء إلى مراتب الطبقة الوسطى الأمريكية.
إن الهجرة إلى الولايات المتحدة بحثا عن الفرص الاقتصادية لم تتوقف ، على الرغم من وضع ضوابط قانونية لهذه الهجرة في مطلقع عشرينيات القرن العشرين. وساعدت هذه الهجرة السريعة على توفير اليد العاملة اللازمة لتشغيل الاقتصاد الأمريكي . وقد أكسبت الولايات المتحدة تركيبة سكانية كانت الأكثر تنوعا في العالم أجمع. وبفضل هذا ، فقد وفرت لها روابط وعلاقات شخصية وثيقة مع كل دول العالم تقريبا ، وهذا يعد ميزة اقتصادية وسياسية عظيمة.
وانتقلت عائلة كارنيجي إلى حجرتين تعلوان إحدى الورش التي تقع مقابل زقاق موحل خلف منزل شقيقة السيدة كارنيجي في مدينة أليجني وهي من ضواحي بتسبرة. وعثرت السيدة كارنيجي على عمل لها في صناعة الأحذية واشتغل السيد كارنيجي في محلج للقطن. كما حصل أندرو عناك على وظيفة عامل بكرة لقاء 1.2 دولار في الأسبوع. وكا نيعمل إثنتي عشرة ساعة في اليوم ، ستة أيام في الأسبوع.
ولا حاجة إلى القول إن أندرو كارنيجي المشتعل حماسة وطموحا لم ينتظر أكثر من خمسة عشر عاما لارتقاء ذلك السلم. ففي العام 1849 كان يعمل مراسل تلغراف لقاء 2.5 دولار في الأسبوع . وهذا ما وفر له الفرصة للتعرف على بتسبرة ومؤسساتها التجارية ، وأفاد كارنيجي من معظم تلك افرص وعلى الفور حصل على وظيفة عامل مقسم (هاتف) فكان يشتغل على التلغراف بنفسه وتعلم تفسير رموزه سماعا فكان يكتب الرسائل من دون إبطاء ، وارتفع راتبه إلى 25 دولار في الشهر.
وفي العام 1853 – وتجسيدا للقول المأثور عن لويس باستور "الفرصة تخدم العقل المهيأ لها" كان توماس إي سكوت – وكان مشرفا عاما على خط حديد بنسلفانيا ، وكان دائم التردد على مكتب التلغراف حيث عمل كارينجي – يبحث عن عامل تلغراف متخصص للعمل على النظام الذي كانت الشركة قد اعتمدته آنذاك. ووقع اختياره على كارينيج – الذي لم يبلغ حينذاك الثامنة عشرة بعد. وعندما بلغ كارينجي الثالثة والثلاثين – في العام 1868 وصل دخله السنوي إلى 50 ألف دولار بفضل رعاية وإرشاد توماس سكوت وعدد من الاستثمارات الناجحة في عربات النوم المهاج التابعة للسكك الحديد ، والنفط وخطوط التلغراف وصناعة الحديد. لكنه بعد زيارة ورشات بيسمير في شيفلد ، قرر أن يوجه اهتمامه إلى صناعة الفولاذ. لقد حملت المصادفة المحضة عائلة كارينجي إلى بتسبر ، لكن الميزات النسبية التي تمتعت بها ستجعلها مركز صناعة الفولاذ في الولايات المتحدة.
لقد تأسست بتسبرة – كالكثير من المدن غرب الجبال – مركزا تجارية ، وهي قائمة في نقطة التقاء نهري أليجني وموناجاهيلا حيث يتشكل نهر أوهايو ، ما ييسر سبل النقل عبر مساحات شائعة. وفي فترة وجيزة بعد الثورة ، بدأت بتسبرة تشتغل ماكمن فلز الذهب والفحم الغنية التي تقع في جوارها ، وشرعت في التخصص في المجالات الصناعية. وفي وقت كانت المناطق الأخرى في البلاد تعتمد على الخشب مصدرا للطاقة صار الفحم المصدر المهيمن للطاقة في بتسبرة ، فأمد المعامل التي كانت تنتج الزجاج والحديد والمنتجات الآخرى التي يتطلب إنتاجها كثيرا من الطاقة . لقد كان ثمة 250 معملا في زمن كان عدد السكان لا يتجاوز ستة آلاف ، في العام 1817، وكانت المدينة الناشئة – وقد غمرتها روح الحماسة الأمريكية – تطلق على نفسها اسم "برمنجهام الأمريكية" . وبفضل الفحم الرخيص أفادت بتسبرة من المحرك البخاري قبل فترة طويلة من استخدامه بدل قوة الماء في المناطق الأخرى ، وكان معظم مصانعها يعمل بطاقة البخار في العام 1830.
ومع ذلك كانت للفحم الرخيض عواقبه الحتمية ، إذ أنه يولد دخانا من الاحتراق يفوق ذلك الذي يطلقه الخشب. وفي نحو العام 1820 عندمات كانت بتسبر بلدة صغيرة نسبيا ، كتب أحد زوارها أن الدخان شكل "غمامة بحجم الليل غطت بتسبرة بجناح من الكآبة والسوداوية". وفي ستنينات القرن التاسع عشر كان أنطوني ترولوب نفسه - وهو المولود في لندن وعلى معرفة بدخان الفحم – مأخوذا من سحب الدخان الكثيفة . وروي عن ترولوب – بعد أن ألقى نظرة إلى الهضاب المحيطة – أن بعض قمم الكنائس تمكن رؤيتها " لكن المدينة نفسها كانت مدفونة في سحابة كثيفة. لم أكن مشدوها من الدخان والسخام بقدر ما كنت كذلك حينما وقفت هنا وراقبت ظلام الليل يلف السخام الطافي على أسطح المنازل في المدينة". ومع اشتداد عود الثورة الصناعية عم التلوث بدخان الفخم وسخامه المدن الأمريكية الأخرى ، لكن أيام منها لم تبلغ درجة الانحدار التي وصلت إليها بتسبرة.
كانت أهم مكامن الفحم في منطقة بتسبرة تلك الواقعة في محيط بلدة كونيسلفيلد على مبعدة ثلاثين ميلا جنوب شرق المدينة . وما يميز فحم كونيسلفيلد كان قابليته التامة تقريبا للتحول إلى فحم الكوك. وهو في الحقيقة أفضل أنواع الفحم المتحول إلى كوك في العالم.
ويمثل الكوك مقارنة بالفحم العادي ما يمثله الفحم النباتي مقارنة بالخشب. إذ أن تسخينه من دون هواء للتخلص من الشوائب ، يحوله إلى كربون خالص يحترف عند درجة حرارة معتدلة ويمكن ضبطها بيسر وسهولة. ولا يمكن الاستغناء عن الفحم النباتي وفحم الكوك في إنتاج الحديد والفولاذ. ومع تنامي صناعة الحديد في بتسبرة تحولت تدريجيا إلى فحم الكوك الذي كان الانتقال بإنتاجه إلى النطاق الصناعي أسهل كثيرا من الإنتقال بالفحم النباتي.
وعندما بدأ أندرو كارنيجي بالتحول إلى صناعة الفولاذ كان هنري كلاي فريك – المولود في ويست فيرتون ببنسلفانيا في العام 1849 – يتحول إلى استخدام فحم الكوك . ومثل كارنيجي كان فريك رجل أعمال صلب العزيمة مقبلا على تحمل مخاطر عظيمة لتحقيق مكاسب عظيمة. وعلى غرار كارنيجي أيضا ، أصبح مليونيرا لدى بلوغه سن الثلاثين. لكنه على عكس كارنيجي ، مع ذلك ، لم يكن يلقى بالا كثيرا إلى الرأي العام أو الأحداث الاجتماعية البارزة في ذلك الزمن. لقد اراد كارنيجي أن يحظى بإعجاب المجتمع جميعه. أما فريك فكان يسعى كثيرا إلى اكتساب احترام المجتمع. ولم يظهر إلا نادرا – على عكس كارنيجي – في مقابلات صحفية ، ولم يكتب مقالات لها إطلاقا.
وفي ثمانينات القرن التاسع عشر ، هيمنت شركة كارينجي للفولاذ وشكرة إتش سي فريك على القطاعات الصناعية التي عملت فيها. وأصبح كارنيجي أكبر عملاء فريك على الإطلاق. وفي أواخر العام 1881 ، وبينما كان فريك يمضي شهر العسل في نيويورك، تقدم كارنيجي – وهو عاشق للمفاجآت – باقتراح مفاجئ بدمج الشركتين في جلسة غداء العائلة ذات يوم ، ولأن فريك لم يكن يعلم البتة بهذا الاقتراح فقد أصابه الذهول ، وكذلك كانت والدة كارنيجي – وهي إمرأة شديدة الحذر – وقد بلغت آناذاك السبعينات من العمر.
وقطع الصمت محادثة ربما هي أبرز الأمثلة على حرص الأمهات في تاريخ الأعمال والتجارة الامريكية . إذ بدر عن السيدة كارنيجي بلكنتها الاسكتلندية العريضة: "آه" أندرا ، إن هذا لشئ رائع بالنسبة إلى السيد فرييك ، لكن م الذين سنفيده منه"؟.
بالطبع ، قد فكر كارنيجي جيدا بما يمكن أن يفيده من ذلك. أولا ، ستحصل شركة كارنيجي للفولاذ على توريدات مضمونة من فحم الكوك وبأفضل الأسعاء. ثانيا ، سيكون ذلك فرصة لتعلم المهارات الإدارية المتطورة التي يتمتع بها هنري كلاي فريك . ثالثا ، سيعزز ذلك التكامل العمودي لنصاعة الفولاذ عامة ولشركته بوجه الخصوص.
إن التكامل العمودي هو أن تضع شركة واحدة يدها على بعض مراحل الإنتاج – أو كلها – من مرحلة تأمين المواد الأولية إلى مرحلة التوزيع. وقد كان هذا التكامل معروفا منذ فجر الثورة الصناعية – كان فرانسسيس كابو لويل أول من جمع أعمال الغزل والحياكة تحت سقف واحد – لكنه شهد تسارعا عظيما في الربع الأخير من القرن التاسع عشر عندما سعى الصناعيون إلى تحقيق وفورات الحجم وتخفيض التكاليف.
لقد اشترك كارنيجي وفريك في فلسفة إدارية بسيطة:
1- الابتكار الدائم والاستثمار بكثافة في أحدث المعدات والتقنيات بغية خلفض التكاليف التشغيلية.
2- حرص الصناعي على أن يكون أقل المنتجين تلكفة للمحافظة على مركز رابح عندما تسوء الظروف الاقتصادية.
3- استبقاء معظم الأرباح في الفترات المواتية للاستفادة من الفرص المتاحة في الفترات غير المواتية حينما ينتهي المنافسون الأقل كفاءة إلى الفشل.
وقد ظهرت إحدى هذه الفرص في العام 1889 ، وكان فريك آنذاك رئيس مجلس إدارة شركات كارنيجي للفولاذ (لم يشغل كارنيجي نفسه أي منصب إداري في الشركات التي خضعت لسيطرته ، لكنه بفضل حيازته أغلبية كافية تماما في ملكية الأسهم ، ظل دائما مسيطرا على مقاليد القيادة والمسئولية). وفي ذلك العام اقتنص فريك شركة ورش فولاذ دوكيسني – وكانت تعاني صعابا مالية – ودفع قيمتها مليون دولار من سندات شركة كارنيجي مستحقة الأداء بعد خمس سنوات ، وفي موعد استحقاق السندات كان المصنع قد حقق لنفسه خمسة أضعاف ذلك المبلغة.
وقد جاء كثير من الابتكارات التقنية التي سارع كارنيجي إلى توظيفها من صناعات الفولاذ الأوروبية الأقدم والأعرق ، تماما كصناعة الملابس الأمريكية قبل قرن مضى تقريبا حين نهضت على ركب التقدم التقني الذي حققته بريطانيا ، وقد بين العقيد دبليو إم جونز – وهو من أعضاء طاقم كارينجي الأساسييين- أمام المعهد البريطاني للحديد والفولاذ في العام 1881: " في وقت كان فيه عملاء المعادن في بلادكم إلى جانب أولئك الذين في فرنسا وألمانيا يكرسون وقتهم وخبراتهم لاكتشاف معالجات جديدة فقد تلقفنا المعلومات التي أوردتها التقارير الصادرة عن المعهد وكرسنا أنفسنا – تدفعنا الأنانية وحب الذات – إلى أن نتفوق عليكم في الإنتاج".
وبالفعل فقد تفوقوا عليهم. ففي العام 1867 وحده انتج 1643 طنا من حديد بيسمير في الولايات المتحدة. وبعد ثلاثين عاما – في العام 1897 – بلغ الحديد المنتج 7.156.957 طنا ، أي ما يتجاوز إنتاج بريطانيا وألمانيا مجتمعتين. ومع نهاية القرن سيفوق إنتاج شركة كارنيجي للفولاذ وحدها إنتاج بريطانيا. وستحقق أرباحا طائلة أيضا. إذ بلغت أرباح الشركة – وهي أقل منتجي الفولاذ تكلفة في السوق الأمريكية الرائجة والخاضعة لضوابط حمائية صارمة – 21 مليون دولار. وفي العام التالي تضاعف الرح. ولا عجب ان هتف أندرو كارنيجي بحماسة ذات مرة : " هل كان ثمة عمل مثل هذا Was there ever such a business".
كان الفولاذ يغير أيضا وجه الحياة الحضرية في الولايات المتحدة ففي وقت كان فيه الحجر مادة البناء الأساسية في المباني الضخمة لم يتسن الإرتفاع بها لأكثر من ستة طوابق ، حتى عندما صر المصعد قيد الاستخدام في خمسينيات القرن التاسع عشر بسبب الحاجة إلى زيادة سماكة الجدران. ولم تجاوز الأبنية المجاورة ارتفاعا إلا أبراج الكنائس التي اخترقت أفق السماء في المدن.ولكن التراجع المطرد في سعر الفولاذ بفضل ارتفاع كفاءة الصناعة – حيث كانت تكلفة قضبان السكك الحديد المصنوعة من الفولاذ الأطول عمرا تقل في ثمانينات القرن التاسع عشر عن تكلفة قضبان الحديد المطاوع القديمة – أدى إلى زيادة مطردة في عدد المباني التي أقيمت على هياكل فولاذية ، وكانت قادرة على بلوغ عنان السماء . وفي الفترة الفاصلة بين ثمانينيات القرن التاسع عشر والعام 1913 كان القرم القياسي لارتفاع المباني يحطم كل عام تقريبا مع هيمنة ناطحات السحاب على سماء المدن الأمريكية في استعراض مهيب لقوة الفولاذ.
إن لكل من رأس المال والعمل أهميته في الانتاج الصناعي واسع النطاق كصناعة الفولاذ. وذلك أنه لا يمكن لأي من عنصري الإنتاج هذين خلق الثروة من دون وجود الآخر. لكن المشكلة كانت تتمثل دائما في تحديد نصيب كل منهما من الثروة المخلقة. قبل الثورة الصناعية ، كان رأس المال والعمل في علاقة حميمة. بل كانا يعدان من العائلة نفسها. وكان قدر كبير من العمل يوفره المتدربون (الصناع) الذين لم يحصلوا إلا على النذر اليسير ، علاوة على ما كان يوفر لهم من مسكن وطعام ، لكنهم اكتسبوا الخبرات التي سيفيدون منها لاحقا عندما يبلغون سن الرشد.
أما العمل الذي كان ثمة طلب عليه في السوق المفتوحة فكان العمل عالي المهارة ، القادر على المطالبة بأجور جيدة ، لكن هذا لم يعن بالتأكيد أنه لم تكن ثمة حالات من عدم التوافق والاتفاق. إذ أن أول إضراب سجل فيما يعرف اليوم بالولايات المتحدة إنما وقع في العام 1768 عندما تظاهر الخياطون المياومون في مدينة نيويورك . وفي العام 1798 تأسست أول نقابة عمالية – وهي الجمعية الاتحادية لصناع الأحذية المياومين في فيلادلفيا (المياومين كما ينم معناها تشير إلى أوليك الذين يتقاضون أجورهم على أساس يومي). وفي عشرينات القرن التاسع عشر كانت هذه النقابات تتجمع في اتحادات مهنية تمثل كل – أو بعض – العمال المهرة في حرفة أو مهنة معينة . وفي خمسينيات القرن التاسع عشر – ومع انشاء اتحاد الطباعة اليدوية الدولية ، الذي كان يمثل عمال الطباعة في الولايات المتحدة وكندا معا – بدأت منظمات العمال ، سواء الوطنية أم الدولية ، في الظهور.
لكن مع انتشار نظام المصانع والتعمق في تقسيم العمل ، بدأت أعداد متزايدة من العمال غير المهرة البحث عن عمل لها في المصانع ، أولا في صناعت كالغزل والحياكة ومن ثم في صناعة الفولاذ وغيره من الصناعات الثقيلة مع توسعها الهائل في الحجم بعد الحرب الأهلية. وعلى عكس العمال المهرة كالمسوطين لم يكن لدى أولئك – الرجال والنساء العاملين في صناعة الملابس – إلا القليل من القدرة التفاوضية كأفراد.
كان ذلك لأمد طويل أصل المشكلة في الحرب العوان الدائرة بين رأس المال والعمل في الاقتصاد الأمريكي . إذ يتحدث راس المال بصوت واحد (بصوت جماعي) ، إما لأن شخصا واحدا يهمين على الشركة – من أمثال أندرو كارنيجي – أو يستأجر حملة الأسهم إدارة تتكلم بصوتهم . أما العمل فهو في المقام الأول مشتت ، وليس للعمال كافراد الخيار إلا بقبول ما هو مقدم لهم.
وحتى بعد تأسيس اتحادات العمل المهنية فإنها لم تفعل كثيرا لمساعدة العمال غير المهرة. وقد نظر العمال المهرة بعين التعالي والتباهي إلى العمال غير المهرة – وكثير منهم كانون من المهاجرين الجدد – فلم يروهم فقط حلفاء ضد الإدارة ، بل عبئا على الشركة قد ينعكس سلبا على أجورهم . وقد ولد هذا انقساما عميقا بين فئات العمال لن يتم رأبه حتى خسيمينات القرن العشرين.
كانت ثمة محاولات عدة لتأسيس منظمات تمثل العامل جميعا – على غرار اتحاد العمل الوطني ، الذي تأسس في العام 1866 ، والاتحاد ذائع الصيت : فرسان العمل Knight if Labor الذي تأسس بعد ثلاث سنوات وكان يضم أكثر من سبعمائة ألف عضو في ثمانينات القرن التاسع عشر . وقد قبل في عضويته عمالا من كل مستويات الخبرة ومن مختلف المنطاق ، لا بل إنه قبل في عضويته أيضا العمال السود. إن اتحاد عمال العالم الصناعيين الذي تأسس في العام 105 لم تتعد عضويته مئات الآلاف ، لكنه كان ذا نفوذ عظيم بفضل تكتيكاته المتقنة واقتراحاته التقدمية. ولسوء الطالع كان اللكثير من منظمات العمل ذات القاعدة الواسعة أجندات أخرى تهدف إلى تحسين أجور أعضائها وظروف عملهم. لقد اعتنقوا بأعداد متزايدة الأفكار الاشتراكية المستوردة من اوروبا التي وجدت – ولا عجب في ذلك – القليل من الدعم من مواطني بلد تاسس وأنشئ بفضل أجيال من دعة المصلحة الشخصية (الفرادنيين) الذين انكبوا على تحقيق مصالحهم الاقتصادية.
إن الإشتراكية في شتى صورها تقوم على مفهوم الطبقات ، وعلى فكرة أن طبقات المجتمع المختلفة ثابتة لا حراك بها ، وبالتالي فإن أفراد كل طبقة لديهم مصالح اقتصادية مشتركة تتعارض مع مصالح الطبقات الأخرى . لكن الطبقات كما هي في الدول الديموقراطية ليست في الواقع أكثر من خطوط يرسمها المفكرون من خلال ما يعد في الواقع صيرورة اقتصادية مستمرة. لقد عد أكثر من 90 في المائة من الأمريكيين – طوال أجيال خلت – من أبناء الطبقة الوسطى.
ولم يوجد بلد – على مر التاريخ – هيكلا اجتماعيا أكثر مكافأة للنجاح الاقتصادي للفرد كذلك الذي خلقته الولايات المتحدة. ويصف الانتماء إلى تلك الجماعة وارد مالك إكستر – الذي عين نفسه حكما على مجتمع نيويورك في العصر الذهبي ، كان أول من نحت عبارة "الأربعمائة" The Four Hundred. وهي تضم وفق ما جاء في كتاباته: "أولئك الذين هم في المقدمة بكامل البهاء والمجد .. الذين لديهم وسائل الحفظ على موقعهم سواء بالذهب أو بالفكر او بالجمال ، وإن الذهب هو دائما مفتاح ما استغلق ، يليه الجمال أهمية أما الفكر والتفاخر بالحسب والنسب فلا شأن لهما". ولا عجب أن كثيرا من المفكرين كانوا ساخطين دائما على المجتمع الأمريكي.
كان أندرو كارنيجي نفسه – بالطبع – مثالا ساطعا عما كان يأمل ملايين المهجرين أن يحققوه هم وأولادهم . لقد سلك مهاجر آخر من جيل كارنيجي طريقا مختلفا جعلته في زمرة الخالدين. لقد ولد صموئيل جومبرز في العام 1850 لأسة بريطانية فقيرة ، كحال كارنيجي تماما. كان والده يهوديين ، وعمل والده صانعا للسيجار ، وكان عضوا نشطا في الاتحاد والحركات الاشتراكية في بريطانيا. وفي العام 1863 هاجرت العائلة إلى نيويورك حيث بدأ جومبرز على الفور مزاولة أعمال صناعة السيجار بنفسه ، وانخرط سريعا في شئون الاتحاد ، وفي ثمانينات القرن التاسع عشر صار رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي السيجار.
كان جومبرز يؤمن بانشاء الاتحادات وفق المهنة معطيا الاولوية للمنظمات الوطنية – على حساب المحلية – ولبلوغ أهداف العمال عن طريق الفعل الاقتصادي (الاضرابات والمقاطعات والاعتصامات وما سواها) وليس العمل السياسي. كان على اقتناع بأن العمل الاتحادي "المحض والبسيط" هو سبيل النجاح و"الانعتاق الاقتصادي". كان جومبرز اشتراكيا – في عقيدته – لكنه أدرك أن السبيل الوحيدة لبلوغ ذلك الهدف البعيد هي أن يرى جانب العمل يزداد قوة تكفي للتفاوض الندي مع الإدارة في المقام الأول.
وفي العام 1886 أخرج عمال السيجار من فرسان العمل وأسس الاتحاد الأمريكي للعمل وهو منظمة تضم النقابات المهنية. وسيصبح رئيس الاتحاد الأمريكي للعمل بقية حياته (باستثناء العام 1895) وسيصبح أشهر قائد عمالي في البلاد. ومع حلول العام 1900 كان نحو 10 في المائة من العمال الأمريكيين أعضاء في الاتحادات ، وهي نسبة تفوق ما نجده في القطاع الخاص في يومنا هذا.
ولاأنه لم تكن ثمة قواعد للتعامل مع الصراع الحتمي بين العمال والإدارة ، فقد كانت الصدمات التي تحولت إلى عنف أمرا محتوما ايضا. ولأن الإدارة كانت في وضع أفضل كثيرا للتاثير في الحكومة في ذلك الوقت ، فقد كانت الحكومة دائما في صف الشركات في كل الأزمات. وفي العام 1877 ، عندما بلغ كساد سبعينيات القرن أشده ، سعت إدارات معظم خطوط السكك الحديد الشرقية فيما بينها إلى خفض الأجور بنسبة 10 في المائة على كل العمال على نحو مفجائ ومن دون سابق إنذار. واضرب عمال السكك الحديد في بالتيمور وأوهايو واغتصبوا ممتلكات حظائر السكك ورفضوا السماح لقطارات الشحن بالمغادرة.
وانتشر الاضراب سريعا إلى خطوط الحديد الأخرى ، ومنها ثلاثة خطوط رئيسية كبرة ربطت الساحل الشرقي بالغرب الاوسط. وعندما استدعي حاكم ينسلفانيا قوات الولاية فرقت تلك القوات المضربين في سكك حديد بنسلفانيا في بتسبرة ، بعد أن قتلت ستة وعشرين منهم. وعندما أجبرت الجشود الغاضبة هذه القوات على الاحتماء في أحد مباني القاطرات في حظيرة قطارات بنسلفانيا وأضرمت النار فيه. وتدبرت القوات الخروج من مخبئها وغادرت مدينة بتسبرة وقد وقعت بين أيدي المضربين والنهابين ، الذين دمروا ما تزيد قيمته على خمسة ملايين دولار من أملاك شركة السكك الحديد. وشعر الرئيس هايس بأن لا خيار أمامه سوى إرسال قوات نظامية لإعادة النظام المدني.
وبسبب هذا العنف – وبالطبع حرصا على مصالحهم الشخصية – خشى كثير من المواطنين الموسرين تلك الاتحادات واعتبروا قادتها – وكثير منهم مهاجرين من أمثال جومبرز – أجانب يحملون أفكار خطرة تنافي المصلحة الأمريكية. أما أندرو كارنيجي – على الرغم من ذلك – فقد دافع عن حقوق العمال في مقالاته مستمرا في كتباتها ونشرها. لكن تلك المقالات تطرقت إلى الجوانب المجردة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية. وحيثا كانت مصالح كارنيجي الشخصية مهددة ، فإنه لم يتردد في معارضة اتحادات العمال وتقويضها بمكره وخداعه ، مع أنه لم يلوق يديه "بالأعمال القذرة" وإنما ترك إنجازها للآخرين.
وفي العام 1889 أدى إضراب في مواجهة الطلب الكبير على الفولاذ في اقتصاد يمر بطور ازدهار ، وحالة الهلع التي أصابت أحد إداريي شركة كارنيجي وكان مكلفا بالتفاوض ، إلى إبرام إتفاقية تلبي كثيرا من مصالح الاتحاد الممثل للعمال في ورش هومستيد قرب بتسبرة ، وكان كارنيجي مصمما على أن يحل الاتحاد قبل أن يحين موعد تجدي الاتفاقية في العام 1892. إن كارنيجي المشغول أبدا بسمتعته – قد أعطى هنري كلاي فريك تفويضا مطلقا بأن يتخذ كل ما يلزم – ثم غادر إلى اسكتلندا.
وأقام فريك سياجا بإرتفاع إحدى عشرة قدما وطول ثلاثة أميال حول المصنع وجهزه بأبراج مراقبة وأضواء كاشفة وأسلاك شائكة ، وأطلق عليه اسم "حصن فريك For Frick" ، وأجرى ترتيبات مع وكالة تحقيقات بنكرتون لتوفير ثلاثمائة رجل لحراسة المصنع في وقت الإغلاق التعجيزي للمصنع.
وعندما رفض الاتحاد عرض فريك – وهذا ما أمله فريك وتوقعه – أعلن فريك أن المصنع لن يتفاوض مع العمال إلا كل بمفرده ، وليس عبر الاتحاد ، وشرع في إغلاق المصنع. وأضرب العمال وحاول ان يتسلل بنوظفي وكالة تحقيق بنكرتون إلى المصنع على ظهور زوارق تجر إلى أعال نهر مونوجاهيلا ، لكن العمال علموا بالأمر فاخترقوا السياج فورا واحتلوا المصنع (ياله من حصن حصن فريك هذا) . وإندلعت معركة استغرقت سحابة اليوم عندما حاول رجال بنكرتون الرسو ، ووقع ضحايا من الجانبين.وأخيرا أبرمت هدنه تسمح لرجال بنكرتون بالانسحاب. مع ذلك فقد ثلاثة منهم في أثناء الانسحاب ، وأرسل حاكم بنسلفانيا قوة من ستة آلاف رجل لإعادة النظام . وتحت حماية تلك القوت استطاع فريك أن يوظف عمالا غير منضمين في اتحادات عمالية.
لقد قوض سيل من الدعايا سمعة كارنيجي كنصير للعمال ، وكان قد بنى تلك المسعة بالحرص والاهتمام. ولكن عندما تعرض فريك لهجوم بعد بضعة أيام في مكتبه من قبل قاتل مأجور اسمه ألكساندر بيركمان كسب تعاطف الامة وإعجابتها أيضا. فعلى الرغم من إصابته بعياريين نارييين في الرقبة وثلاث طعنات ، فقد قاوم فريك ببسالة واستطاع أن يسطير على المهجم بمساعدة معاونيه في المكتب. ثم رفض أن يخضع للمخدر عندما كان الطبيب يحاول إزالة الطلقات وأصر على متابعة عمله في ذلك اليوم.
ولم يكن للقاتل المأجور علاقة بالخلاف العمالي لكنه ربط به – بطبيعة الحال – وانحسر التعاطف العام مع الاتحاد ، وذكر قائد الإضراب هيو أودونيل: "يبدو أن الطلقة التي خرجت من مسدس بيركمان وأخطأت هدفها اللعين قد استقرت في قلب إضراب هومستريد". وفي نوفمبر انتهى الاضراب وحققت الشركة نصرا مبينا من الناحية الاقتصادية.
ومع نهاية القرن التاسع عشر تراجعت حالات العنف في الخلافات العمالية. لكن توفير الحكومة ضمانا كاملا لحقوق العمال وامتلاك العمال القدرة على التفاوض مع الإدارة على اساس الند للند لن يتسنيا إلى بعد مرور جيل ، وتحديدا في ثلاثينيات القرن العشرين.
النفط
ومع أن الاقتصاد الأمريكي في أواخر القرن التاسع عشر كن يرتكز أساسا على صناعة الفولاذ ، فإن النفط كان الدم الذي يجري في عروقه. ففي العام 1859 حينما حفر أدوين دريك أول بئر للنفط ارتفع إنتاج الولايات المتحدة إلى ألفي برميل فقط. وبعد عشر سنوات وصل الإنتاج إلى 4.25 مليون برميل ، وفي العام 1900 سيبلغ قرابة 60 مليون برميل. لكن بينما كان الإنتاج يحقق زيادة مطردة ، ظل سعر النفط يعاني تقلبات شديدة ، فكان يهبط إلى مستويات متدنية عند 10 سنتات للبرميل – وهذا يقل كثيرا عن تكلفة إنتاج البرميل أصلا – ويرتفع إلى مستويات عالية عند 13075 دولار في ستينيات القنر التاسع عشر . واحد من أسباب ذلك هو العدد الكبير من مصافي النفط التي كانت تعمل آنذاك . ففي كليفلاند وحدها كان ثمة ما يزيد على ثلاثين مصفاة كثير منها صغير الحجم وآيل للسقوط.
كان كثيرون – على الرغم من سعادتهم بالإفادة من تجارة النفط حديثة العهد – غير مستعدين لبذل إلتزامات مالية كبيرة في هذه الصناعة خوفا من أن ينضب النفط على حين غرة. وظل الحقل الذي يقع في شمال غرب بنسلفانيا الوحيد تقريبا في العالم حتى سبعينيات القرن التاسع عشر ، عندما فتح حقل باكو فيما يعرف حينها بجنوب روسيا. ولن يظهر حقل كبير آخر في الولايات المتحدة حتى تبدأ أعمال الحفر في بئر سبندل توب الأسطوري في تكساس لأول مرة في العام 102.
لكن شركة روكفلر وفلاجر وأندرو – التي أسست لاستغلال سوق المشتقات النفطية المزدهرة خصوصا الكيروسين – قامرت ببناس مصافي نفط متطورة. وعلى غرار شركة كارنيجي كانت تلك الشركة تعتزم الإفادة من انخفاض التكاليف فيها وكل المزايا التي تقترن بذلك ، وشرعت أيضا في شراء مصاف أخرى كلما سنحت الفرصة.
لقد أدركت الشركة أنه ليس ثمة ما يتحكم في سعر النفط الخام ، لكنه يمكن أن تتحكم – جزئيا على الأقل – بأحد العناصر المهمة الأخرى في سعر المشتقات النفطية ألا وهو النقل. فبدأت مفاوضات جريئة مع خطوط السكك الحديد للحصول على تخفيضات في أسعار النقل لقاء مستويات عالية ومضمونة من الشحنات . كانت هذه الاتفاقية هي ما سمح للشركة بالبيع بأسعار تقل عن أسعار منافسيها والحصول مع ذلك على أرباح وفيرة ، مما ساهم في تقوية مركز الشركة التنافسي الذي كان قويا في الأساس.
وفي العام 1870 أقنع أحد الشركاء – وهو هنري فلاجلر – شركاؤه بتغيير الشكل القانوني من شراكة إلى شركة ذات شخصية اعتبارية ، مما يسهل على الشركاء الاستمرار في تأمين رؤوس الأموال اللازمة لتمويل توسيعهم الدؤوب والحفاظ على زمام السيطرة بأيديهم في الوقت نفسه ، وقد بلغ راسمال الشركة الجديدة – وحملت اسم ستاندرد أويل – مليون دولار وكانت تملك آنذاك 10 في المائة من طاقة مصافي النفط في البلاد. وفي العام 1880 سيطرت على 80 في المائة من هذه الصناعة التي تحققت زيادات كبيرة في الحجم.
لقد صار توسع ستنادرد أويل من القصص الأسطورية التي تروى عن أمريكا أواخر القرن التاسع عشر حينما حقق حملة أسهمها الثراء الذي لا يدركه الخيال وازداد تأثيرها ونفوذها في الاقتصاد الأمريكي بصورة كبيرة. وبالفعل فإن ردة فعل وسائل الإعلام على ستاندرد أويل وجون دي روكفلر في العصر الذهبي مشابهة – وياللغرابة – لرد الفعل الذي قوبل به ارتقاء شركة مايكروسوفت وبيل جيتس بعد مائة عامة . ولربما كان من قبيل المصادفة أن روكفلر وجيتس كانا في العمر نفسه تقريبا – في مطلع الأربيعنيات – عندما صار اسمهما يترددان في كل مكان ورمزين خالدين لهيكل اقتصادي جديد، يحمل في طياته تهديدا للبعض.
لقد كانت الصورة العالقة اليوم عن ستاندرد أويل في الذاكرة الشعبية الأمريكية نتاج عمل الكتاب ورسامي الكاريكاتورات الافتتاحية الذين حمل أغلبهم أجندة سياسية غايتها التقدم والارتقاء أولا وقبل كل شيء . كان ألمع أولئك الكتاب أيدا تاربيل الذي صور كتابع "تاريخ شركة ستنادرد أويل" – الذي نشر أول مرة في مجلة مكلو McClure's في العام 1902 – تصويرا حيا شركة تتوسع من دون هوادة على حساب كيانات الشركات المنافسة فالتهمت موجوداتها بينما كانت ساعية في طريقها.
لكن ذلك من دون ريب تصوير زائف ، ولنقل أنه إلى درجة ما مضلل. فمن ناحية أولى ، ومع اشتداد قبضة ستاندرد أويل الرهيبة على صناعة النفط بدأت أسعار المشتقات النفطية تتراجع بإطراد ، فهبطت بنحو الثلثين في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر. إنها بموجز القول لمن ضروب الأسطورة القول بأن الاحتكارات تعمل على رفع الأسعار عندما يتسمى لها ذلك ، فالاحتكارات – كغيرها – تسعى إلى تعظيم أرباحها ، وليس أسعارها ، فالأسعار المتدنية – التي ترفع الطلب وبالتالي كفاءة العمل ، التي بدورها تخفض التكلفة – هي في العادة أفضل السبل لتحقيق أعلى مستويات الأرباح . أما ما يجعل الاحتكارات شرا كبيرا على الاقتصاد (وأغلبها اليوم وكالات حكومية من مكاتب السيارات إلى المدارس العامة) فهو حقيقة أن غياب الضغوط التنافسية يجعلها تحجم عن تحمل المخاطر وبالتالي تقلع عن الابتكار ولا تكترث براحة العملاء.
إلى ذلك فقد استخدمت ستاندرد أويل مركزها كأكبر مصافي النفط في البلاد ليس فقط لانتزاع أعلى التخفيضات من خطوط السكك الحديد ، ولكن أيضا لحثها على إمساك هذه التخفيضات عن المصافي التي أرادت ستاندرد اويل استحواذها. لقد أجبرت أحيانا سكك الحديد أن تكشف عن تخفيضاتها السرية ليس فقط على شحناتها الخاصة من النفط ، لكن على شحنات الشركات المنافسة ايضا ، وذلك جزاء لها على منافسة ستنادرد أويل (وهذا يشابه أفعال اللصوص النبلاء) . وهكذا كانت النصيحة المبطنة التي قدمتها لهذه المصافي اختياريا قسريا: إما أن تقبل أن تستحوذ على سعر تحدده ستنادرد أويل أو أن تنتهي إلى الإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف النقل.
لقد حسب سعر الإستحواذ – الذي اعتبر مع ذلك سعرا عادلا – على اساس صيغة وضعها هنري فلاجلر وطبقها مرارا وتكرارا. وفي بعض الأحيان التي يكون فيها لدى أصحاب المصفاة المستحوذة خبرات إدارية مميزة ورغبت ستنادرد أويل الإفادة منها ، كان سعر الإستحواذ سخيا. كما أن للبائع خيار قبض السعر نقدا أو على شكل أسهم في ستاندرد أويل. وأصبح أولئك الذين اختاروا العرض الثاني – وعدوا بالمئات – مليونيرات بفضل أسهم شركة ستنادرد أويل الذي حملهم على أجنحة المجد الرأسمالي. أما أولئك الذين اختاروا القبض نقدا فانتهت بهم الحال إلى أن يشكوا سوء طالعهم إلى إيدا تاربيل.
ولم يكن في هذا بالطبع ما ينافي القنون ، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية. ففي أواخر القرن التاسع عشر كان أشخاص من أمثال روكفلر وفلاجلر وكارنيجي وجي بي مورجان يؤسسون بسرعة فائقة اقتصاد الشركات الحديثة. وبالنتيجة عالما اقتصاديا جديدا تماما. كانوا يمضون بوقع أسرع مما يتخيله المجتمع. كان لزاما – في ظل العملية السياسية البطيئة – أن تسن قوانين تحكم هذا العالم الوليد بروح الحكمة والعدل. لكن هذا هو دين الرأسمالية الديموقراطية دائما ، حيث يمكن للأفراد – بسرعتهم وحركتهم – أن يسبقوا المجتمع برمته. وإلى أن صيغت القواعد القانونية كتابة – وأغلبها وضعت في العقود الأولى من القرن العشرين – كان الوضع (كما عبر عنه السير والتر سكوت) مسالة:
القواعد القديمة المثلى .. الخطط البسيطة .. هذا ما يجب أن ينتهجه كل ذوي سلطان .. لأنها ستصون من يصونها..
كان بعض المشكلة يتمثل في الجمود الكبير المتأصل في أي نظام سياسية ، والديموقراطية ليست مستثناة من ذلك. فالسياسيون لا هم لهم سوى إعادة انتخابهم. وأن يحجم المرء عن أي تصرف أو سلوك لهو أفضل من الإساءة إلى جماعة أو أخرى. لذلك وبنيما طرأت تغيرات جذرية على الاقتصاد الأمريكي منذ منتصف القرن التاسع عشر فإن قوانين تأسيس الشركات في الولايات – لم يسمح لستاندرد أويل بالتملك في ولايات اخرى أو حيازة أسهم الشركات الأخرى. ومع توسعها عبر الشمال الشرقي وفي البلد برمته ، ومن ثم في العالم أجمع ، حازت سستناندر أويل – بواقع الحال – أملاكا في ولايات أخرى واستحوذت على مؤسسات أخرى.
ولم تعد قوانين تاسيس الشركات- و أكثرها وضع في حقبة سابقة لتلك التي جعلت فيها السكك والتلغراف قيام اقتصاد ونطني حقيقة ممكنة التطبيق – كافية لتلبية متطلبات الاقتصاد الجديد. وللالتفاف حول القانون القديم عين هنري فلاجلر – بصفته أمين سر ستاندرد أويل – أمينا وكيلا تسجل باسمه الأملاك والأسهم التي لا يحق لستاندرد أويل نفسها أن تمتلكها. وفي نهاية سبعينيات القرن التاسع عشر – مع ذلك – حازت ستاندرد أويل عشرات الأملاك والشركات في الولايات الأخرى ، كان كل منها مسجلا – وإن صوريا – باسم الأمين الوكيل ، الذي كان أحيانا هو فلاجلر نفسه أو أشخاصا يعينهم. كان ذلك هيكلا مؤسسسيا يفتقد الصفة العملية تماما.
وكما كان فلاجلر دائما – وهو الإداري الفذ – هو من خرج بحل المشكلة . فبدلا من أن يعين أمينا وكيلا لكل شركة تابعة ، حيث كان أولئك الأمناء متناثرين في أرجاء إمبراطورية ستاندرد أويل – فقد عين الرجال الثلاثة أنفهسم – وكل منهم باقي في مقرالشركة في كليفلاند – أمناء للشركات التابعة كلها. كانوا صوريا يسيطرون على كل موجودات شركة ستاندرد أويل خارج أوهايو ، لكنهم في الواقع كانوا ينفذوا ما يملى عليهم بحذافيره.
العهدة
وهكذا ولدت العهدة Trust ، وهي شكل قانوني تبنته سريعا الشركات الأخرى التي بدأت تعمل على النطاق الوطني. وسيصبح الأمناء بعبعا عظيما في أروقة السياسة الأمريكية في الأعوام المائة التالية ، ولكن فلاجلر لم يكتب له الإستمرار بعد العام 1889 ، ففي ذلك العام أصبحت نيوجرسي – وكانت تسعى إلى تأمين مصدر جديد للإيرادات الضريبية – أول ولاية تخرج بقوانين تأسيس الشركات فيها وتوائمها مع الوقائع الاقتصادية الجديدة. فقد أجازت نيوجيرسي آنذاك الشركات القابضة ومزاولة العمل التجاري بين الولايات ، فسعت الشركات إليها لتؤسس مقار لها على أراضيها ، كما أنها ستقصد – فيما بعد – ديلوار للإفادة من مزايا المناخ القانوني المواتي لعمل الشركات. واحتلت شركة ستاندر أويل النيوجيرسية سريعا نقطة المركز في مصالح روكفلر ، أما ستاندرد أويل ترست (العهدة ) فلم يعد لها وجود بالمعنى القانوني.
ومع النمو الذي حققته الصناعة الأمريكية طرأ تغيير جذري على جوهر التجارة الخارجية الأمريكية فقد ظلت الولايات المتحدة – كما هي اليوم – مصدرا رئيسيا للمنتجات الزراعية والمعدنية . كما أضيفت منتجان جديدان في الحقبة التي تلك الحروب الأهلية:البترول ، والنحاس. لكنها باتت أيضا مصدرا رئيسيا للسلع المصنعة التي دابت على استيرادها في الماضيز وفي العام 1865 لم تشكل تلك الصادرات إلا نسبة 22.78 في المائة من الصادرات الأمريكية. وفي نهاية القرن العشرين بلغت 31.65 في المائة من تجارة وصل حجمها إلى مستويات هائلة . إن نسبة مساهمة أمريكا في التجارة الدولية تضافعت في تلك السنوات إلى نحو 12 في المائة من حجم التجارة الإجمالية.
ولقد تجلى ذلك خصوصا في منتجات الحديد والفولاذ ، وهما آخر ما بلغته التكنولوجيا في أواخر القرن التاسع عشر. فقبل الحرب الأهلية لم تتجاوز صادرات الولايات المتحدة من منتجات الحديد والفولاذ ستة ملايين دولار سنويات. وفي العام 1900 صدرت الولايات المتحدة ما قيمته 121.914 مليون دولار من القاطرات والمحركات وخطوط السكك الحديد والآلات الكهربائية والأسلاك والأنابيب وآلات التشغيل المعدنية والمراجل وغيرها. حتى آلات الخياطة والآلات الكاتبة كانت تصدر بكميات كبيرة.
وقد خلق الاقتصاد الأمريكي ثروات شخصية هائلة ، وبمعدلات لم تكن في الحسبان. وبالفعل لم يميز الاقتصاد الأمريكي عبر تاريخه شيء كنزعة الثروات الجديدة لتأخذ مكان سابقاتها. فعندما توفي جون جاكون آستور ، وكان أغنى رجل في أمريكا في العام 1848 ، خلف ثروة بلغت 25 مليون دولار. وخلف الكومودور فاندربلت 105 ملايين دولار في اقل من ثلاثين سنة مقبلة. وبيعت ممتلكات أندرو كارنيجي في العام 1901 بملبلغ 480 مليون دولار. وبعد ثلاثين سنة أخرى ، قدرت ثروة جون دي روكفر بملياري دولار.
ووقف مارك توين على هذه النزعة أول مرة العام 1867 عندما ذكر أن "أبناء الطبقة الأرستقراطية النيويوركية من مهاجري إيرلندا يجدون من يفوقهم ثراء من الأمراء فاحشي الثراء المفاخرين بثرواتهم ، المبتذلين الذين لا تعرف لهم أصول. إن دخولهم – التي كانت مادة لعامة الشعب ليفغروا عليها أفواههم ويطلقوا الاشاعات حولها – لهي اليوم دراهم معدودات لا تكفي المبتذلين سداد إيجارات قصورهم". ولم يتغير ذلك الواقع. وبستثناء روكفلر وهيرست لم يحقق شخص آخر ثورة إسطورية في العصر الذهبي – وهم أمراء الإبتذال كما أطلق عليهم توين – ذلك أن الثروة في ذلك العصر نجدها اليوم على قائمة مجلة فوربس للأغنياء الأربعمائة الكبار – وأن ثروة روكفلر – مع أنها تظل ثروة طائلة – لا تشكل إلا عشر الثروة التي تحققت لبيل جيتس في فترة لا تتجاوز عشرين سنة.
لم تنشأ في هذه البلاد طبقة أرستقراطية لأن مفهوم حق البكورة ، حيث يرث الإبن الأكبر كل ثروة أبيه ، لم يكن مطبقا. ذلك أن الثروات العظيمة كانت تتبدد بين الورثة في بضعة أجيال فقط. لذلك فإن أثرى أثرياء أمريكا هم دائما محدثوا الثراء ويتحدد سلوكهم بموجبات ذلك ، وبالتالي فإن عبارة "الاستهلاك التفاخري Conspicuouc Consumpition" ، تأخذ معنى جديدا في كل جيل. وفي العصر الذهبي ، كان هؤلاء يسعون إلى الزواج من ثريات أوروبا. لكن الأكواخ الصيفية الكبيرة والمعتزلات الشتوية التي كلفت ملايين الدولارات لم تسكن إلا أسابيع معدودة في السنة.
كانت مساكنهم الدائمة فاخرة ومترفة. وبينما كان لكل بلدة ومدينة أمريكية أحياؤها (حيث أنشئت أبنية المليونيرات) وحيث سكن المصرفيون وأرباب المصانع فلا مجال للمقارنة بما أنجبته نيويورك – وهي أغنى مدن البلاد وأكثرها شغفا بالمال. ومع مطلق القرن العشرين زحفت سلسلة من العزب (البيوت أو القصور العظيمة) وكل منها يفوق تاليه حجما وعظمة ، على مسافة ثلاثة أميال على طول الجادة الخامسة . كان ذلك إحدى عجائب العصر التي أنتجتها واستقطبت زوارا من كل أنحاء العالم ليحدثوا منشدهين إلى رمز الثراء الأمريكي الذي لا حدود له. واليوم ، كما كانت حال الثروات التي شيدتها فإن كل المنازل قد زالت إلا قليلا. أما تلك التي كتب لها البقاء فقد تحولت اليوم إلى قنصليات ومدارس ومتاحف.
وكل ما بقي قائما النصب العامة التي أقاهما الأثريا أيضا لتخليد ذكرهم وإثبات مشروعية ثرواتهم. إن تبرع الأثرياء بالأموال الطائلة للمؤسسات الخيرية هو صنيع يميز الأمريكين ، فالطبقات العليا في اوروبا لم تعتد ذلك. لقد بدأت في مطلع القرن التاسع عشر على أيدي أشخاص مثل جورج بيبودي (وهذا يذكرنا بمتاحف بيبودي في هارفارد وييل ، من جملة كثير غيرها) وبيتر كوبر (اتحاد كوبر ، ولا تزال الجامعة الرئيسية الوحيدة في الولايات المتحدة التي لا تفرض رسوما تعليمية) وجون جاكون آستور ، الذي تعد مكتبته (آستور ليبراري) اليوم نواة مكتبة نيويورك العامة ، ثانية كبرى المكتبات في الولايات المتحدة وكبرى المكتبات الممولة من مصادر خاصة في العالم أجمع.
وعندما شارف القرن التاسع عشر على نهايته ، بدأ الأشخاص الذين كانوا يصنعون ثروات عظيمة بتاسيس المتاحف وقاعات الموسيقى والأوركسترات والكليات والمشافي أو وقف أموالهم عليها ، وذلك بأعداد مذهلة في كل مدينة كبرى. لقد كتب كارنيجي أن "الرجل الذي يموت غنيا ، يموت مسربلا بالخزي والعار". فتبرع بكامل ثروته تقريبا لبناء ما يربو على خمسة آلاف مكتبة في المدن الصغيرة. إلى جانب كثير من الأعمال الخيرية الآخرى. وقد تبرع هنري كلارك فريك بمجموعته الفنية النادرة إلى مدينة نيويورك ، وكذلك فعل بعزبته في الجادة الخامسة لإيواء تلك المجموعة إضافة إلى 16 مليون دولار لصيانتها والاهتمام بها ، كما وهب جون دي روكفلر – وكان معمدانيا ملتزما دأب على الصدق بعشر دخله قبل أن يصبح أغنى رجل في العالم – الملايين من دون حساب خدمة لقضايا جليلة في جميع أنحاء العالم ، ومجموعة جي بي مورجان الفنية – وهي أكبر مجموعة فردية في العالم – باتت اليوم في معظمها في متحف المتروبوليتان وفي مكتبة وادسورث العامة في هارتفورد ومكتبة مورجان التي تضم أيضا واحدة من أعظم مجموعات المخطوطات والكتب النادرة في العالم.
لقد كانت الولايات المتحدة في أول عهدها في مرتبة ثقافية متردية. فكان الفنانون والكتاب يقصدون أوروبا – عادة – للدراسة. ومع نهاية القرن العشرين حققت الولايات المتحدة مكانة ثقافية وفكرية تضاهي قوتها الاقتصادية ، والفضل في ذلك أساسا يعود إلى الرجال الذين لم ينالوا قسطا وافيا من التعليم والذيني يذكرون اليوم باسم اللصوص النبلاء.
إن الإمبرطوريات الصناعية التي أقامها "اللصوص النبلاء" كانت تبدو أكثر خطرا على مراكزهم الاقتصادية مع تحولها إلى شركات تزداد حجما. وفي الشطر الثاني من تسعينيات القرن التاسع عشر تسارعت النزعة نحو اندماج الشركات.
وفي العام 1897 جرت 69 حالة اندماج بين الشركات ، وفي العام 1898 ارتفع العدد إلى 303 ، وفي العام التالي إلى 1208 . ومن أصل الاحتكارات (الترسانات) الثلاثة والسبعين التي تجاوزت قيمتها الرأسمالية 10 ملايين دولار في العام 1900 ، فإن ثلثها أقيم في السنوات الثلاث السابقة.
وفي العام 1901 أسس جي بي مورجان كبرى الشركات على الإطلاق وهي فولاذ الولايات المتحدة U.S. Steel بعد دمج إمبراطورية شركات أندرو كارنيجي بعدد من شركات الفولاذ الأخرى في شركة جديدة بلغ رأسمالها 1.4 مليار دولار. كانت عائدات الحكومة الفدرالية ذلك العام لا تتجاوز 586 مليون دولار. وأذهل حجم المشروع في حد ذاته العالم. فأقرت وول ستريت جورنال بأن "حجم المشروع مثير للقلق" ، وتساءلت إن كانت الشركة الجديدة يتؤذن ببداية "موجة كبيرة من الرأسمالية الصناعية" ، وتناقل الناس دعابة تقول إن معلما سأل تلميذا: "من خلق العالم؟ فأجاب التلميذ: "خلق الله العالم في العام 4004 قبل الميلاد .. وأعاد جي بو مورجان تنظيمه في العام 1901".
ولكن عندما دخل ثيودور ورزفلت الأبيض في سبتمبر 1901 بدأ اتجاه الحكومة الفدرالية نحو الحرية الاقتصادية (دعه يعمل) في التغير. وفي العام 1904 أعلنت الحكومة أنها ستتخذ الخطوات القانونية بموجب قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار Anti-trust – وكان ثمة اعتقاد أن هذا القانون صار في طي الماضي – لتفكيك أحد اندماجات مورجان الجديدة وشركة الاوراق المالية الشمالية Northern Securities Corporation. وهرع مورجان إلى واشنطن لتسوية المسألة. وهناك أخبر الرئيس موجزا له فكرته عن آلية عمل العالم التجاري: "إذا كنا قد أخطأنا في شيء .. فأرسل محاميك إلى محامي ليعملا على إصلاح الخطأ".
وأجاب روزفلت: " لا يمكن ذلك". وبين فيلاندر نوكس المحامي العام المسألة: "إننا لا نريد إصلاح الخطأ . بل نرغب في استئصاله". ومنذ تلك اللحظة ستكون الحكومة الفدرالية حكما فاعلا في السوق ، في سعيها – وإن لم تفلح دائما – إلى الموازنة بين متطلبات الكفاءة واقتصاديات الحكم في مواجهة تهديد القوة المتعجرفة للشركات المدينة بالولاء لحملة أسهمها وليس للمجتمع.
وفي العام 1907 وضعت الحكومة الفدرالية يدها على أكبر "الاحتكارات" على الإطلاق ، ستنادرد أويل . وبلغت القضية المحكمة العليا في العام 1910. وفصل فيها في العام التالي ، حيث قضت المحكمة بالإجماع أن ستاندرد أويل كانت "تكتلا" يعيق التجارة. وأمرت بتفكيك ستاندرد أويل إلى أكثر من ثلاثين شركة مستقلة.
ورحب الجناج الليبرالي في أروقة السياسة الأمريكية بالحكم ، بكل تأكيد ، ولكن في واحدة من أغرب المفارقات في التاريخ الاقتصادي الأمريكي ، كان أثر الحكم الصادر على أكبر تكتل للثروة في العالم اجمع هو أن زاد تلك الثروة. ففي العامين اللذين أعقبا تفكيد ستاندرد أويل تضاعفت قيمة أسهم الشركات التي انبثقت عنها ، مما زاد من ثروة جون دي روكفلر إلى ضعف ما كانت عليه.
معيار الذهب: صليب من ذهب
 مقالة مفصلة: معيار الذهب
مقالة مفصلة: معيار الذهب
لأن الولايات المتحدة باتت بلدا ذا قدرات صناعية متقدمة في تسعينات القرنالتاسع عشر، فقد جلب الكساد الذي بدأ في العام 1893 مآسي اقتصادية للشعب الأمريكي لم يعرف لها مثيلا. ففي العام 1860 كان ثمة أرعة عمال زراعيين مقابل كل عامل صناعي ، لكن هذه النسبة هبطت في العام 1890 إلى اثنين مقابل واحد. كان ذلك يعني أن عائلة أمريكية من كل ثلاث عائلات كانت تعتمد على دخل منتظم لتأمين حاجتها إلى الطعام والمأوى والملبس.
وفي ربيع ذلك العام أعلنت شركة فيلادلفيا وريدينج للخطوط الحديد وشركة كوردج الوطنية – أو ما كانت يعرف باحتكار روب – من دون مقدمات أنهما معسرتان ماليا ، وعم الهلع وول ستريت ودب الوباء سريعا في جسم الاقتصاد. وفي نهاية ذلك العام كان خمسة عشر ألف شركة قد انتهت إلى الافلاس ، ومعها 491 مصرفا. وتراجع الناتج القومي الاجتماعي بنسبة 12 في المائة ، وارتفعت البطالة سريعا من 3 في المائة في العام 1892 إلى 18.4 في المائة بعد عامين.
وحتى سبعينات القرن التاسع عشر كانت كلمة "عاطل عن العمل" تطلق على كل فرد لا مهنة لديه ، وتشمل الأطفال في عمر خمس سنين على الأقل ، وربات المنازل، والأفراد الذين كانوا يعتمدون في معيشتهم على دخول استثماراتهم . ولكن في العام 1878 ، حينما كان الكساد الذي عصف بذلك العقد يشارف على نهايته ، أعاد مسح احصائي أجري في ماساتشوستس تعريف العاطلين عن العمل بأنهم الذكور الذين تجاوزوا الثامنة عشرة "وكانوا من دون عمل ويبحثون عنه". وفي منتصف التسعينيات من القرن التاسع عشر عد أولئك بالملايين ، وتفشى الجوع في شوارع ما بات يعرف اليوم بضواحي الاحياء الفقيرة المتناثرة حول المدن الأمريكية ، ولم يكن ثمة من يحارب الشقاء والبؤس سوى المؤسسات الخيرية الخاصة.
إن السبب المباشر للكساد الجديد – كما كانت الحال في معظم فترات الكساد السابقة في هذا البلد – هو فرط التوسع الاقتصادي نتيجة افتقاد البلاد مصرفا مركزيا يعمل مكابحه وقت الضرورة. وكان أيضا ثمة سبب غير مباشر : السياسة النقدية التي سعت إلى تحقيق غايتين متنافيتين في آن معا.
وفي السنة التي أعقبت جنون الذهب في العام 1869 ، عقفد مجلس النواب جبسات استماع لمناقشة المسألة. فمن ناحية ، أكسبت الجلسات التي رأسها النائي جيمس جارفيلد هذا الرجل – وهو عضو الكونجرس عن أوهايو – شهرة قومية. فقد كت جارفيلد – أكثر حكماء المال فطنة – في التقرير الذي أصدرته اللجنة أنه "مادمنا نعتمد معيارين للقيمة يقرهما القانون – ويمكن أن يتعارضا بوسائل مصطنعة – فإن المضاربة على سعر الذهب هي مصدر إغراء كبير من الصعب مقاومته".
لقد أراد جارفيلد – بعبارة أخرى – العودة إلى معياد الذهب ووقف التعامل بالأوراق النقدية الخضراء (الدولار). لقد رغب التجار المنخرطون في التجارة الدولية – وكثير منهم رأى الإفلاس محدقا به يوم الجمعة السوداء – في العودة إلى معيار الذهب. وكانت هذه أيضا رغبة مصارف وول ستريت الكبرى وأرباب الصناعات الثقيلة في البلاد. كان أولئك بالطبع هم الذين هيمنوا آنذاك على الحزب الجمهوري. لكن كان ثمة كثير ممن عارضوا العودة إلى معيار الذهب.
إن لمعيار الذهب ميزة كبيرة كنظام نقدي: فهو يجعل التضخم بعيدا خارج دائرة الاحتمال. فإذا زاد بلد ما عرض نقوده النقدية إلى ما وراء القدرة الاستيعابية للسوق فإن حملة الاوراق النقدية المصرفية (البنكنوت) سيردونها للحصول على قيمتها ذهبا ، وسيتحول الذهب إلى الخارج مع شروع المصارف المركزية في سحب ثقتها من العملات وإيلائها وسيطا تثق بها ألا وهو الذهب.
لكن التضخم أثير دائما على قلوب المدينين ، لأنه يستاعدهم على سداد الديون المستحقة علهيم بنقد انخفضت قوته الشرائية . لقد كان النظام النقدي الذي يقوم على معيار الذهب يعني بالنسبة إلى مناطق مثل الجنوب المنكوب – الذي دمرته الحرب الأهلية معظم موجوداته المصرفية ما سواها من الثروات النقدية – استمرار الكساد ، أما الأموال الميسرة فكانت السبيل إلى إحياء الاقتصاد. لقد تميزت فترة أواخر القرن التاسع عشر – في واقع الأمر – بتباطؤ شديد ومستقر في معدلات التضخم.
لقد كان معيار الذهب – بفضل آثاره – شائع التطبيق في الشمال الشرقي حيث مركز المال والتجارة الخارجية والصناعة ، لكنه لم يلق قبولا من صغار المزارعين الذين عملوا في مناطق التخوم وفي الجنوب . إذ نظر كثير من سكان تلك المناطق إلى معيار الذهب على أنه مجرد مؤامرة من "وول ستريت" لدفعهم إلى مهاري الإفلاس. وفي العام 1867 رشح حزب العمل أحد أعضائه لمنصب الرئاسة (وكان رجلا طاعنا في السن هو بيتر كوبر من نيويورك ، وكان – ويا للمفارقة – أغنى رجل في البلاد ليبراليا يقود ليموزينا). وفي العام 1878 حصل الحزب على 1.060.000 صوت في انتخابات الكونجرس كانت كفيلة بانتخاب أربعة عشر عضو كونجرس.
وعلى الرغم من أن الحكومة أوقفت طباعة الأوراق النقدية الخضراء (من دون طرح بديلا لتلك التي أبلاها الاستخدام) في نهاية الحرب الأهلية ، فقد سكت دولارت فضية ، وذلك بفضل تزايد كميات الفضة التي اكتشفت في المناطق الغربية ، مما وفر ببلاد معيارا ثنائي المعدن. ومن ثم ، وفي العام 1873 ، أوقفت سك تلك الدولارات حين صوت الكونجرس بالموافقة على العودة إلى معيار الذهب في العام 1879 ، وقد نعت المعارضون لمعيار الذهب ذلك على الفور "بجريمة 73". ومارس طرفا الإصدار ضغوطا حثيثة على الكونجرس الذي حاول استرضاء الطرفين – وهذه حال المشرعين الديموقراطيين – خصوصا حين التعامل مع قضايا شائكة وعويصة.
وعاد البلد إلى معيار الذهب كما كان مخططا له في الأول من يناير 1879 ، وطلب إلى الخزانة الاحتفاظ باحتياطي من الذهب بقيمة 100 مليون دولار بمقابلة الطلب على المعدن النفيس . لقد صوت الكونجرس في السنة السابقة بالإبقاء على ما يعادل 346.681.000 دولار من الأوراق النقدية الخضراء التي كانت لا تزال قيد التداول ، لكن على أن تكون قابلة للاسترداد ذهبا ، كما كان شأن المسكوكات الفضية. كما أقر الكونجرس قانون "بلاند – أليسون" الذي أوجب على الخزانة شراء ما بين مليوني دولار و 4 ملاييين دولار شهريا من الفضة في السوق المفتوحة وتحويلها إلى مسكوكات بنسبة معادل "12 إلى 1" من الذهب. بكلمة أخرى ، أعلن الكونجرس – وبقوة القانون – أن ست عشرة أوقية من الفضة تعادل أوقية واحدة من الذهب. وقد كان لمسكوكات الفضة الجدية بالطبع أثر كبير في زيادة عرض النقد في البلاد ، وتلك هي الطريق النموذجية نحو التضخم.
في البدء ، كانت نسبة 16 إلى 1 هي نسبة السعر الفعلي تقريبا بين الذهب والفضة ، لكن بدء إنتاج مكامن الفضة العظيمة في الغرب – كما في كورادلين بإيداهو وعرض كومستوك الشهير في نيفادا ، الذي اكتشتفت أول مرة في العام 1859 – أدى إلى تراجع سعر الفضة في الأسواق . وفي العام 1890 وصلت نسبة السعر بين المعدنين إلى "20 إلى 1" . وفي تلك السنة أصدر الكونجرس "قانون شيرمان" الذي قضي بأن تشتري الخزانة 4.5 مليون أوقية من الفضة شهريا ، أي ما يعادل تقريبا الانتاج الإجمالي للفضة في الولايات المتحدة ، وضربها نقدا.
ويحافظ معيار الذهب على قيمة الدولار من دون تغيير ، وبعد أن أدت سياسة الفضة إلى زيادة عظيمة في عرض النقد ، كانت الحكومة – في واقع الأمر – تفتح الباب أمام التضخم والمخاطر التي تترتب عليه. وهكذا فعل "قانون جريشام" فعله المحتوم. إذ بما أن قيمة الفضة السوقية كانت تعادل واحدة من عشرين من قيمة الذهب ، بينما كان الشعر يحدد عند ضرب النقد بنسبة 1 إلى 16 فقد سعى الناس – بطبيعة الحال – إلى إنفاق الفضة والاحتفاظ بالذهب ، وبدأت احتياطيات الذهب ترشح من الخزانة.
لقد حققت الحكومة في ثمانينيات القرن الثامن عشر فوائض هائلة في الميزانية ساعدت على إخفاء حالة الإزدواج في السياسة النقدية . ولكن عندما آذن إنهيار السوق في العام 1893 ببدء مرحلة كساد جديدة ، تحول رشح الذهب من الخزانة إلى نزيف. ومع تراجع إيرادات الحكومة – انخفضت من 386 مليون دولار إلى 306 مليون دولار بين العامين 1893 – 1894 0 سارع الكونجرس إلى وقف العمل بقانون شيرمان. لكن الناس – والحكومات الاجنبية ، وهذا الأهم – فقدوا الثقة بالدولار ، وتصاعد الطلب على ذهب الخزانة بمستويات عظيمة. وأصدرت الحكومة سندات لشراء كميات إضافية من الذهب لتعويض النقص الحاصل في احتياطي الذهب لكن الذهب ظل ينزف من الخزينة.
وتفاقمت الحالة بعد وقت قصير ، وانخفض احتياطي الخزانة من الذهب إلى ما دون 100 ملوين دولار (وهو الحد الذي اشترطه القانون في العام 1894) ، ومن ثم تعويض العجز بعوائد إصدار سندات بقيمة 50 مليون دولار في يناير من ذلك العام. لكن الاحتياطي هبط غلى 68 مليون دولار من العام التالي. وفي غضون أسبوع واحد بلغ 45 مليون دولار. ورفض الكونجرس السماح للرئيس كليفلاند – وهو مناصر عنيد لمعيار الذهب – بطرح إصدار جديد من السندات لتعويض رصيد لاذهب المتناقص.
لقد أصيبت الحكومة بالشلل. وبعد مدة قصيرة كان ممكنا – وبالمعنى الحرفي للكلمة – رؤية الذهب يتدفق خارج البلد عندما كانت سبائك بملايين الدولارت تحمل على متن السفن في نيويورك قاصدة المصارف المركزية الاوروبية. وقامت مضاربات في وول ستريت حول موعد نفاذ الذهب من الخزانة لتضطر الدولة حينها إلى وقف التعامل بمعيار الذهب.
واستقل جي بي مورجان ، بعد أن تناهت إليه أخبار لا تبشر بخير – وكان آنذاك أعظم مصرفيي البلد من دون منازع – القطار إلى واشنطن ليحول دون ذلك. كان الرئيس كليفلاند ، مدركا تماما – وهو نفسه كان مؤيدا لمعيار الذهب واستقرار العملة – أنه على رأس حزب كان كثير من أعضائه يطمحون إلى التخلص من معيار الذهب ، ويحملون كرها كبيرا للول ستريت وكل أفعالها . ورفض مقابلة مورجان . لكن تفاقهم الوضع سوءا من ساعة إلى أخرى ، حمل كليفلاند في صباح اليوم التالي على الإصغاء إلى ما سيقوله مورجان.
كان الرئيس لا يزال يحدوه أمل بإقناع الكونجرس بالموافقة على إصدار جديد للسندات ، لكن ذلك سيستغرق وقتا بطبيعة الحال. ونقل موظف إلى كليفلاند أن الخزانة الاحتياطية في نيويورك لم يبق فيها سوى 9 ملايين دولار من الذهب. وأبلغه مورجان أنه على علم بأن ثمة طلبات سحب بقيمة 12 مليون دولار قد تقدم إلى الخزانة في أي لحظة. وإذا حصل هذا – قال مورجان محذرا – "فسينتهي الأمر كله في السعة الثالثة".
وطرح عليه كليفلاند – بعد أن عدم الخيارات – السؤال التالي: ألديك ما تقترحه؟" .. وكان لدى مورجان ما يقترحه بالفعل. ذلك أن إصدار مزيد من السندات في السوق المحلية – وفق رايه – لن يفيد على الاجل الطويل بأي حال . ولأن الذهب سيكمل دورته إلى خارج الخزانة في نهاية المطاف . لكنه وأوجست بيلمونت الإبن – وهو وكيل آل روتشيلد في الولايات المتحدة وكان حاضرا في البيت الأبيض ذلك اليوم – سيؤمنان مبلغ 100 مليون دولار ذهبا من أوروبا ، وسيكون ذلك كفيلا بوقف نزف الذهب من الخزانة. كما أن محامي مورجان وضعوا أيديهم على قانون غامض يعود إلى زمن الحرب الأهلية – لا يزال ساري المفعول – يسمح للحكومة بإصدار السندات اللازمة لشراء النقد المعدني من دون العودة غلى الكونجرس في ذلك.
كان مورجان – وهنا يكمن وجه الغرابة – راغبا في أن يحول دون تدفق الذهب إلى أوروبا ، على الأقل على الأجل القصير. وكان هذا عملا من ضروب "الشجاعة" المالية الفائقة. وبفضل سمعته التي ملأت الآفاق واللجوء إلى تقنيات متطورة في أسعار الصرف استطاع مورجان الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه. وفي يونيو 1895 وصل احتياطي الخزانة من الذهب إلى 107.5 مليون دولار.وبدأت الاقتصاد – وهذا الأهم – يتعافى. وهذكا أنقذ مورجان معيار الذهب.
ومن الطبيعي أن مناوئي معيار الذهب قد سلقوا مورجان وبيلمونت بألسنة حداد ، وكان هؤلاء يهيمنون على المؤتمرالوطني للعام 1896 ، وقد قدم ويليام جينينج بريان – وهو عضو أسبق في الكونجرس عن نبراكسا ، وكان يرأس آنذاك تحرير صحيفة "أوهاما وورلد هيرالد:" وكان من مؤيدي معدن الفضة بشدة – لوفود المؤتمر كل المعلومات المهمة التي كانوا تواقين إلى معرفتها عن هذه المسألة ، وذلك في واحدة من أشهر الخطب العمة في التاريخ الأمريكي.
لقد طمأن بريان الحضور منذ البداية إلى أن "أحقر مواطن في هذا البلد – عندما يتسربل بدرع قضة عادلة – يكون أقوى من كل قوي الخطيئة مجتمعة". وكانت قضيته وقف العمل بمعيار الذهب ، وعرض بكلمات رنانة كيف أضر هذا المعيار بمصالح المزارعين والعمال ، ولم يخدم سوى مصالح من وصفهم – بكلمات توماس كارليل – "أرباب المال العاطل المتكاسلين".
وكان ذلك صلب القضية ، كما أخبر الخضور. "لمصلحة أي طرف سيقاتل الحزب الديموقراطي لمصالح "ارباب المال العاطل المتكاسلين أم إلى جانب الجماهير الكادحة؟".
كان يشد الحضور طرف راحته عندما بلغ نهاية خطبته ، وكان صوته يبلغ من دون جهد كل أركان قاعة المؤتمرات في شيكاغو : "بحصولنا على عدعم الجماهير المنتجة في الأمة والعالم ، مدعومة بالمصالح التجارية ومصالح العمال والكادحين في كل مكان ، سنرد على مطالبهم بمعيار الذهب بأن نقول لهم ، لن تثبتوا على جبين العمال تاج الشوك هذا ، لن تصلبوا البشرية على صليب من ذهب".
وجاش الحضور حماسا في ختام ما نعته الروائي ويلا كاثر Willa Cather – وكان حاضرا حينها – "بحفلة لا تنسى". وساد الهرج والمرج نحو نصف ساعة ، وفي نهاية المطاف رشح يريان لمنصب الئاسة ولم يتجاوز آنذاك السادسة والثلاثين من العمر. ولا يزال – حتى يومنا هذا – أصغر مرشحا لأحد الاحزاب الرئيسة.
وأطلق المرشح الجمهوري ويليام ماكينلي حملته الانتخبية من شرفته في كانتون بأهايو ، فألقى خطبة على حشود حملت إلى هناك بالقطارات . لقد تنقل بريان أيضا من دون كلل أو ملل في أول حملة انتخابية في التاريخ الأمريكي تتخللها جولات قصيرة في مختلف المدن الصغيرة. وكانت الشقة الفاصلة بين الحزبين على أشدها. ودعم القضاء حزب الشعب أيضا – وكان أكثر تطرفا من الديموقراطيين – المرشح بريان بدلا من مرشحهم.
وأعلن بريان في خطبته العظيمة: "لقد عرضنا مطالبنا .. لكنها قوبلت بازدراء ، لقد توسلنا .. لكن توسلاتنا لم تلق آذانا صاغية ، لقد تضرعنا .. لكنهم سخروا منا في محنتنا . إننا لن نتوسل بعد الآن .. لن نتضرع .. لن نطالب .. وإننا نتخداهم!".
وفي غضون ذلك ، نشرت إحدى الصحف الجمهورية في افتتاحيتها أن اليعاقبة يبسطون سيطرتهم تماما على شيكاغو حيث كان بريان مرشحا). إن أي حركة سياسية في أمريكا لم تخلق ردود فعل كريهة وعبثية مثل هذه".
لقد جرت عادة المرشحين – كما هي حالهم دائما – أن يتركوا التسميات والألقاب لأنصارهم. لكن أفكار بريان الاقتصادية قرعت ناقوس الخطر ، حتى بالنسبة إلى أولئك الأمريكيين المغمورين وكثير من ذوي المطامح الشخصية. إن كثيرا من الديموقراطيين في المناطق الشرقية والغرب الأوسط – الذين راعهم ما رأوا من أفعال بريان الدهماوية بنظرهم – قد اختارو نصرة ماكينلي.
لكن في بداية الحملة ، تبين أن الكفة قد ترجح لمصلحة فريق بريان ، وترنح مؤشر داو جونز الصناعي – الذي أسسه في ربيع ذلك العام تشارلز داو محرر صحيفة "وول ستريت" حديثة العهد آنذاك لقياس الأداء الجماعي لسوق الأسهم – متراجعا بمقدار الثلث طوال فصل الصيف.
وبدأ الاقتصاد يتعافى من فترة الكساد بزخم أشد في فصل الصيف ، وهذا ما ساعد الحزب الذي أسس حملته على شعار "العملة المستقرة ل، الحماية الجمركية ، الازدهار". واسترد مؤشر داو جونز – وهو ميزان حرارة الوضع السياسي والمالي – عافيته مع تعاقب أيام الخريف.
وفي نوفمبر كسب ماكينلي سباق الرئاسة بنسبة 52 في المائة من الأصوات ، فاكتسح المناطق الغنية والأكثر تطورا في الولايات المتحدة ، الشمال الشرقي والغرب الاوسط كلها ، بالإضافة إلى ولايات السهول العليا وكاليفورنيا وأوريجون. أما بريان فحاز الجنوب وبقية الولايات الغربية.
لكن بريان – على الرغم من خسائره المتكررة (سيخسر في الحملات الرئاسية عامي 1900 و 1908 ، وسيجر صليبا من ذهب عبر الفلاة السياسية) – قد استشرف تماما مستقبل السياسة القومية الأمريكية – واشار في خطبته أمام الحضور إلى أن "الحزب الديموقراطي متعاطف مع الجماهير الكادحة التي استمد منها الحزب قواعده . إن ثمة منظورين للحكومة. فهناك من يعقتد أن التشريعات التي تسن فقط خدمة لمصالح الأغنياء إنما تساعد على إنتقال الازدهار للجماهير تساعد على إنتقال الازدهار إلى الطبقات الدنيا. أما من منظور الديموقراطيين فإن التشريعات التي تحقق الازدهار للجماهير تساعد على إرتقادء هذه الجماهير عبر كل الطبقات العليا التي تقوم عليها". كان الخيار "واضحا لا لبس فيه" ، لكن الأمة اختارت كلا المنهجين. إن السياسة في الولايات المتحدة هي سياسة الوسط – لا اليمين ولا اليسار – وإن قدر هذه الأمة معايشة الاختلافات المقسمة أو السير على كلا المنهجين في آن واحد ما كان إلى ذلك سبيل. وفي السنوات المائة التالية ، حين يتناوب الحزبان على إمساك مقاليد الهيمنة السياسة ، ستعتمد البلاد سياسات اقتصادية تراعي مصالح الطبقتين العليا والدنيا. لقد كانت النتيجة ذات آثار حميدة كلية تقريبا - على الرغم من أنها خلقت فوضى فلسفية – وهذا دائما حال العمل السياسي في الدول الديموقراطية.
ولم يشغل دوائر السياسة في البلاد في هذه الحقبة السلمية – إلى جانب معيار الذهب – سوى النظام الضريبي . فلقد اعتمدت الحكومة الفدرالية على التعريفات الجمركية كمصدر رئيس لايراداتها منذ أيام ألكساندر هاملتون ، إلى أن أضطرتها الحرب الأهلية إلى فرض ضرائب على كل شيء تقريبا بما في ذلك الدخول.
وعندما أمكن الاستغناء عن ضرائب المجهود الحربي بعد كسب الحرب انخفضت كثير من الضرائب الفدرالية الجديدة أو ألغيت تقريبا. لكن التعريفات الجمركية لم يلحقها أي تعدل. ذلك أن القاعدة الصناعية المتعاظمة قد استمدت زخمها من الحماية الجمركية التي وفرتها التعريفات الجمركية وحاربت بضرواة للابقاء عليها. وفي غضون ذلك ، فقد مركز ثقل المعارضة طويلة الأجل لرفع مستوى التعريفات الجمركية – وهو الجنوب – تأثيره السياسي حتى فترة نهابة الإعمار في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر. في ذلك الحين كانت فكرة التعريفات الجمركية المرتفعة من مبادئ الحزب الجمهوري. وبغض النظر عن درجة النضج والكفاءة التي بلغتها الصناعة الأمريكية – إذ أن الاقتصاد الأمريكي أضحى مع نهاية القرن أكثر اقتصادات العالم كفاءة – فقد جاهدت إدارات الشركات الصناعية وحملة أسهمها وعمالها بلا هوادة لإبقاء التعريفات الجمركية عند مستوى يتجاوز كثيرا حاجة الحكومة من الإيرادات وأفلحوا في هذا .
وبالنتيجة ، حققت الحكومة سلسلة من الفوائض الضريبية المباشرة طوال عشرين عاما منذ العام 1866 ،ولم يشهد الاقتصاد الأمريكي شيئا كهذا في تاريخه. وفي العام 1882 ، حين عم الازدهار الاقتصادي ، تجوزت إيرادات الحكومة على نفقاتها بنسبة كبيرة بلغت 36 في المائة . ومع نهاية القرن انخفض الدين الهائل الذي خلفته الحرب الأهلية بمقدار الثلثين تقريبا بالأرقام المطلقة ، وانخفض كثيرا قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 50 في المائة إلى ما دون 10 في المائة كثيرا.
وفي العام 1867 خضت ضريبة الدخل المخصصة للحرب الأهلية إلى 5 في المائة على كل الدخول التي تزيد على 1000 دولار. وبعد ثلاث سنوات خفض معدل الضريبة مرة أخرى حتى ألغيت نهائيا في العام 1872 ، ولم يكن قبل الحربالأهلية تاييد يذكر – إن كان حقا ثمة تأييد – لضريبة الدخل ، لكن كل برامج الحكومات – حالما كانت توضع قيد التطبيق – تخلق تأييدا سياسيا وهذا كان أيضا شأن ضريبة الدخل.
لقد نجح مؤيدوا ضريبة الدخل من الناحييتين المنطقية والسياسية – لنقل – في حشد الراي إلى جابنهم. حيث إن الضرائب غير المباشرة – مثل ضرائب السلع الكمالية والتعريفات الجمركية – هي ضرائب على الاستهلاك ، وبالتالي فهي تصاعدية بطبيعتها ، أي إنها تصيب أساسا أولئك الأقل قدرة على تحملها ، فالفقراء مضطرون إلى إنفاق نسبة عالية جدا من دخولهم على الحاجات الأساسية (الضروضريات) تفوق نسبة ما ينفقه الأغنياء ، وبالتالي فهم ينفقون نسبة أكبر كثيرامن دخولهم على ضرائب الإستهلاك.
لقد شرح عضو مجلس الشيوخ جون شيرمان – وهو جمهوري من أوهايون ، ولم يكن راديكاليا باي شكل من الأشكال – في احد الحوارات موضوع إلغاء ضريبة الدخل في العام 1872 فقال: "إن لدينها هنا في نيويورك السيد آستور .. بدخل يعد بالملايين يكسبها من تجارة العقارات .. ولدينا في المقابل رجل فقير لا يزيد دخله السنوي على ألف دولارز ما وجه التمييز الذي يحمله القانون في هذه الحالة؟ إنه بالتأكيد متحيز ضد الرجل الفقير ، إذ إننا نفرض ضريبة على كل ما يستهكله هذا الرجل ، ونبقى من ذلك مترددين في فرض ضريبة على دخل السيد آستور ، هل ثمة عدالة في ذلك؟ لماذا يا سيدي تكون ضريبة الدخل الوحدية التي تنحو إلى مساواة هذه الأعباء بين الغني والفقير؟
لقد كان شيرمان محقا ، لكن كحال الضرائب دائما ، فهي سلطة سياسية طاغية وليست من وسائل تحقيق العدالة ، لقد صوت أعضاء الكونجرس عن سبع ولايات شمالية شرقية – كانت تدفع بالمجموع نحو 70 في المائة من ضريبة الدخل – بأغلبية 64 مقابل 14 لمصلحة إلغاء الضريبة ، في حين صوتت أربع عشرة ولاية جنوبية وغريبة – كانت تدفع نحو 11 في المائة من ضريبة الدخل – بأغلبية 61 مقابل 5 لمصلحة الإبقاء على الضريبة. هذا يعني أن دعم ضريبة الدخل كان يرتبط بصورة عكسية تامة بأثرها المحلي. ففي البلد الديموقراطي ، يسعى السياسيون دائما إلى انتهاج مبدأت ينسب إلى عضو مجلس الشيوخ رسل لونج من لويزيانا "لا تدعم يفرضون ضريبة عليك .. ولا علي .. وليفرضوها على الرجل الذي يقف خلف الشجرة.
ولم يحقق أنصار ضريبة الدخل تقدما يذكر في ثمانينات القرن التاسع عشر التي كانت تنعمل بالازدهار الاقتصادي ، ولكن عندما حل الكساد العظيم في التسعينات وتراجعت الإيرادات الفدرالية ، ظهرت دعوات متجددة لتطبيق ضريبة الدخل. وبوجود رئيس ديموقراطي – وهو جروفر كليفنلاند – في البيت الأبيض وهيمنة الديموقراطيين على كلا مجلس الكونجرس صدر قانون في العام 1894 يجير فرض ضريبة جديدة على الدخل.
كانت الضريبة الجديدة تختلف كثيرا من حيث أثرها عن ضريبة الدخل زمن الحرب الأهلية ، فالضريبة الأولى كانت لا تصيب الفقراء فقط. أما الضريبة الجديدة التي قضت بفرض نسبة 2 في المائة على كل الدخول التي لاتتجاوز 4 آلاف دولار ، فأعفت كل الفئات ما عدا الأغنياء. ومن بين كل الأسر الأمريكية ، التي بلغت إثنى عشر مليونا في العام 1894 لم يكلن إلا لخنس وثمانين عائلة دخول تعادل 4 آلاف دولار أو تزيد. وكان هذا يقل عن 1 في المائة من مجموع الأسر. ولأول مرة في التاريخ الأمريكي فرضت الضريبة على طبقة بعينها من الشعب ، طبقة اقترن اسمها بالنجاح الاقتصادي . لذلك السبب عارضها كل الجمهوريين بمن فيهم عضو مجلس الشيوخ شيرمان . ولذلك السبب أيضا ، سمح كليفلاند بإجازة مشروع القانون من دون توقيعه.
ولا عجب أن أقيمت على الفور دعوى قانونية ،حاجج فيها المدعون بأن ضريبة الدخل تعارض فقرة من الدستور تنص على أن تحدد حصة كل ولاية من الضرائب المباشرة وفق عدد سكانها ، وهذا ما كان من ضروب المستخيل – كما كان واضحا – في حال ضريبة الدخل. فالدستور لا يتحدث عن ماهية "الضريبة المباشرة" (طلب روفوس كينج إجابة). وفي العام 1796 قضت المحكمة الدستورية بأن الضريبة المباشرة هي كل ضريبة "يمكن" تخصيصها على أساس عدد السكان. وكانت المحكمة قضت في العام 1881 بأن ضريبة الدخل المخصصة للحرب الأهلية هي ضريبة غير مباشرة.
وبغض النظر عن هذا ، ومع غياب أحد أعضاء هيئة المحكمة بسبب المرض انقسمت المحكمة بين أربعة معارضين وأربعة مؤيدين حول مسألة اعتبار ضريبة الدخل ضريبة مباشرة ، ومدة دستوريتها . واستقطبت قضية بولاك ضد اتحاد التسليف الزراعي اهتماما واسعا في كل أنحاء البلاد أكثر مما استقطبته قضية "بليسي ضد فيرجسون" التي أيدت مبدأ العزل على أساس الفصل مع المساواة في العام التاليز وبسبب الاهتمام الشعبي الكبير بالقضية ، وافقت المحكمة على سماع الدعوة مرة أخرى ، وحضر القاضي هويل جاكسون – وكان مصابا بمرض عضال ، وتوفي بعد ثلاثة أشهر – وبنية لا مراء فيها أن يكون الصوت الخامس المؤيد للضريبة.
وقد بدل أحد القضاة (ولم يعرف أيهم ، وكان الاعتقاد الغالب أنه القاضي جورج ثيراس) موقعه وصدر حكم بعد دستورية ضريبة الدخل ، بخمسة أصوات مقابل أربعة. وهكذا كانت الغلبة لمؤسسة الحزب الجمهورية ، وإن كان بهامض ضئيل جدا. ومع ذلك فقد نشأ في السنوات القليلة التالية جناح تقدمي داخل الحزب الجمهوري ، يستمد قاعدته من الغرب والغرب الاوسط ، كان أكثر تعاطفا مع مصالح أفراد الطبقة الوسط. وأيد التقدميون ضريبة الدخل.
وعندما تبوأ ثيودور روزفلت منصب الرئاسة في العام 1901 ، عقب اغتيال الرئيس ويليام ماكينلي ، أبدى انحيازا شديدا إلى الجناح التقدمي في حزبه . وفي العام 1906 أيد فرض ضريبة المواريث لغاية معلنة هي إعادة تنظيم البنية الاجتماعية من خلال الحيلولة دون انتقال تلك الثروات – التي تركمت على نحو خطير جدا – بقضها وقضيضها". كان الاتجاه العام في الحزب الجمهوري – من دون مبالغة – راعبا من الفكرة ، لكن لم يظهر حقا ما يهدد الوضع الراهن حتى عم الهلع في العام 1907 وأعقبه ركود قصير ، مما سبب انخفاضا حادا في الإيرادات الحكومة من التعريفات الجمركية.
وفي خضم الجدل حول قانون التعريفات الجمركية للعام 1909 ، اقترح النائب كورديل هل من تينيسي (وفي ما بعد وزير خارجية الرئيس روزفلت) أن يعاد سن ضريبة الدخل للعام 1894 ، مما حدا المحكمة العليا (التي كانت بفضل تعيينات ثيودور روزفلت أبعد عن صيغتها المحافظة التي اتسمت بها قبل أربعة عشرة سنة) على إبطالها للمرة الثانية.
ولم يتسن لتعديل ههل إجتياز مجلس النواب ، لكن الأحداث اتفقت في مجلس الشيوخ لتغيير هذا الوضع. وتقدم أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي – واسمه جوزيف دبليو بايلي من تكساس – بتعديل على ضريبة الدخل إلى المجلس الأعلى (مجلس الشيوخ) بدعم من تقدميين من الحزب الجمهوري من أمثال وليام إي بورا من إيداهو. أما زعيم المعارضين للتعديل فكان عضو مجلس الشيوخ نيلسون دبليو ألدريتش من رود آيلاند. كان ألدريتش – الذي أصاب ثروة من تجارة السلع الاستهلاكية بالجملة وكان حمو جون روكفيلر ، الإبن – واحدا من أكثر من عضرين مليونيرا من أعضاء مجلس الشيوخ آنذاك.
لقد استطاع ألدريتش الحفاظ على التعريفة الجمركية المرتفعة على الرغم من انقسام الجمهوريين المزمن حول ضريبة الدخل. وتضرع ألدريتش للرئيس الجديد – ويليام هوارد تافت – لإيجاد مخرج للأزمة.
كانت تافت – وهو محافظ أكثر من روزفلت – ينظر إلى المحكمة العليا بعين الاحترام والإجلال. وسيتبوأ – فيما بعد – منصب رئيس القضاة. وهو منصب أقرب في طبيعته إلى منصب الرئاسة. في معظم عشرينيات القرن العشرين. وقد كان راعبا من فكرة معارضة حكمة المحكمة في بولاك. وقد ساوره شعور بأن المحكمة إن أذعنت ، فن هيبتها كجهة حاكمة بالدستور ستهتز كثيرا ، وإذا أسقطت ضريبة الدخل ثانية فستنشأ أزمة بين المحكمة وذراعي الحكومة المنتخبين من الشعب.
لذلك اقترح تافت – وكان محاميا بارعا – إجراء بديل ، إذ دعا إلى تعديل دستوري يجيز تحديدا فرض ضريبة دخل شخصية ، واقترح من ناحية فرض ضريبة دخل على أرباح الشركات. كانت أسهم الشركات آنذاك في حيازة الأثرياء ، لذلك فإن ضريبة أرباح الشركات كانت في واقع الأمر ضريبة على دخول الأغنياء. كما رأى أيضا أن الضريبة لن تكون تحايلا على الدستور ، لأنها ليست ضريبة دخل إطلاقا ، بل ضريبة غير مباشرة تقاس بالدخل ، لقاء التمتع بإمتياز مزاولة العمل التجاري تحت مسمى القانون للشركة. بكلمة أخرى كانت ضريبة خاصة. وفي العام 1911 وافقت المحكمة العليا على هذا التعديل بالإجماع.
وقد اجتاز التعديل السادس عشر – في غضون ذلك – مجلس الشيوخ ب77 صوتا كاملة. واجتاز الكونجرس بنسبة 318 إلى 14 ، واقر التعديل من قبل العدد اللازم من الهيئات التشريعية في الولايات ووضع في التنفيذ في 3 فبراير 1913.
وفي الوقت الذي كان فيه الحزب منقسما بين جمهوريي تافت المحافظين وجمهوريي روزفلت التقدميين الذين إنشقوا عن مؤتمر العام 1912 لتشكيل حزبهم الخاص ، الذي اتخذوا له الموظ شعارا ، في هذا الوقت انتخب الديموقراطي ودرو ويلسون رئيسا بأقل من 43 في المائة من أصوات الشعب و82 في المائة من أصوات الناخبين. كما أن انقسام الحزب الجمهوري قد أكسب الحزب الديموقراطي الأغلبية في كلا مجلسي الكونجرس . وكان من بين الخطوات الأولى التي اتخذتها إدارة ويلسون الجديدة إصدار قانون ضريبة الدخل الشخصية.
وعلى الرغم من أن هذا القانون كان مقتضبا إلى درجة تثير السخهرية بالمعايير اللاحقة – إذ لم يتجاوز عدد صفحاته 14 صفحة – فإنه كان يضم بين طياته بذور التعقيدات الواسعة التي ستظهر لاحفا. وفرضت ضريبة تصاعدية على الدخول التي تجاوزت 3 آلاف دولار باعتماد نسب تتراح بين 1 في المائة و7 في المائة (على الدخول التي تتجاوز 500 ألف دولار ،وهو مبلغ كبير جدا في تلك الأيام). لكن كانت ثمة استثناءات كثيرة مثل الفوائد على السندات التي تصدرها الولايات والسلطات المحلية وعلى توزيعات أرباح الشركات (بسقف يصل إلى 20 الف دولار). وكانت الفوائد على كل ضروب الديون واهتلاك الموجودات ، وغير ذلك الكثير ، تقتطع من الدخول التي تخضع للضريبة.
ولم تدمج ضريبة دخل الشركات – التي طبقت في الأصل بوصفها بديلا مؤقتا – مع الضريبة الشخصية ، إذ ظلت مستفلة تماما. إن الأعباء المالية للحروب الكبرى التي شهدها القرن العشرون سترفع معدلات ضريبة الدخل إلى مستويات عالية جدا لم يتصورها حتى أكثر أنصارها حماسة. ومع الارتفاعات المتكررة في معدلات الضريبة سيبدأ المحاسبون والمحامون إيجاد وسائل لا حصر لها لحماية الدخول من الضريبة عبر استغلال غياب التنسيق بين النظامين الضريبيين.
كانت الولايات المتحدة في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر تشهد إزدهارات لم يسبق له مثيل. وفي السنوات العشر ، بين العامين 897 و1907 ، تضاعفت الصادرات الأمريكية ، وكذلك الواردات . وازدادت كمية النقد المتداول – الأوراق النقدية المصرفية الوطنية والمسكوكات الذهبية والفضية – من 1.5 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار ، بينما حققت إيداعات المصارف ارتفاعا هائلا من 1.6 مليار دولار إلى 4.3 مليار دولار ، وهذا الرقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للعام 1860 ، وارتفعت قيمة موجودات المصارف وبيوت السمسرة وشركات التأمين من 9.1 مليار دولار في العام 1897 إلى 21 مليار دولار عد عشر سنوات تلت . الدول المتقدمة الأخرى كانت أيضا تشهد إزدهارا عظيما.
لكن ثمة مشكلة في الأفق ، إذ لما كان العالم يسير على معيار الذهب ، كان نمو الاقتصادات الوطنية – على الأجل الويل على الأقل – محصورا بحدود نمو المعروض من الذهب الذي كان اساس عملات العالم آنذاك. وشهد إنتاج الذهب ركودا في ثمانينيات القرن التاسع عشر ، لكن الاكتشافات الجديدة في يوكن في جنوب أفريقيا – خصوصا – التي تحولت إلى مرحلة الإنتاج في العقد التالي ، أحدثت نموا سريعا في حجم المعروض من الذهب. ذلك أنه في العام 1893 لم يكتشف إلا ما قيمته 157 مليون دولار من الذهب. ولكن بعد سنوات خمس وصلت قيمة الذهب المستخرج من باطن الأرض إلى 287 مليون دولار. وتجاوز الإنتاج 400 مليون دولار في السنوات الأولى من القرن العشرين، لكنه ظل عند ذلك المستوى في وقت حافظ فيه اقتصاد العالم على معدلات نمو سريعة.
وارتفع الطلب على رأس المال لتمويل اندماجات الشركات الصناعية (كذلك ارتفعت حاجة الحكومات إلى تمويل الحروب مثلحرب بوير Boar war والحرب الروسية – اليابانية . وفي العام 1907 كانت أسواق النقد تعاني نقصا حادا في السيولة ، وزاد هذا النقص تفاقما . وبدأ جيم جي هيل – يحذر مما أسماه "شلل التجارة" إذا ارتفعت تكلفة رأس المال كثيرا . وفي مطلع العام 1907 تعذر بيع السندات الممتازة التي تستحق بعد عام واحد. إذ كانت ذات قسائم (كوبونات) تتراوح فوائدها بين 5 في المائة و7 في المائة ، وتعتبر هذه المعدلات مرتفعة جدا بمعايير اليوم. أما السندات الطويلة الأجل فلم يتسن بيعها على الإطلاق.
وفي مارس أصاب سوق الأسهم انهيار مؤقت تعافى منه على الفور. كما تراجعت في ربيع ذلك العام أسواق الأسهم في دول أخرى وخصوصا مصر واليابان. وبدأ الذهب يتدفق خارج الولايات المتحدة في وقت سعت في مصارف إنجلترا وفرنسا إلى تقوية مراكزها والحيلولة دون استنزاف عملاتها . ولم تكن الولايات المتحدة – وهي لم تعرف لها مصرفا مركزيا منذ زمن أندرو جاسكون – أي قدرة على التحكم في عرض النقد فيها.
وفي 10 اكتوبر ، وفي أعقاب محاولة لاحتكار أسهم النحاس ، دب الرعب في وول ستريت ، وانتشر سريعا المصارف التي ورطت في تمويل هذا الاحتكار ، وخصوصا نيكربوكر ترست . وبدأت موجة نزيف الأموال من نيكربوكر ترست ، ومن ثم وقعت المصارف الأخرى تحت الصحار أيضا ، حيث سعى المودعون إلى إسترداد أموالهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لقد امتحد الطابور الواقف خارج المقر الجديد لمصرف نيكربوكر في الجادة الخامسة عبر مجمعين من الأبنية. وفي يوم الأربعاء 23 اكتوبر استنزف مصرف لنكولن ترست 14 مليون دولار من إيداعاته في بضع ساعات فقط. وأوشكت مصارف أخرى أن تجبر على إغلاق أبوابها أيضا.
ولم تكن أمام الحكومة الفدرالية خيارات كثيرة . وقصد وزير الخزانة جورج بي كورتيلو إلى نيويورك وأودع ستة ملايين دولار في مصارف نيويورك لتعزيز سيولتها ، لكن القانون كان يحظر الإيداعات الفدرالية في المصارف باستثناء المصارف الوطنية. لقد كانت مؤسسات التسليف ومصارف الولايات هي التي قاست أشد الظروف.
واقدم كورتيليو على الفعل الوحدي الذي كان باستطاعته القيام به في ظل الظروف السائدة : أبلغ جي بو مورجان عزم الحكومة الفدرالية بذل ما في وسعها لاستئصال أسباب الهلع ، واضعا ثقته به من جديد للخروج بحل لهذه الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد.
كان مورجان على دراية تامة بسبب المشكلة. وفي يوم الخميس 24 اكتوبر أبلغ الصحفيين أنه "إذا أبقى الموعدون أموالهم لدى المصارف فكل شيء سيكون على ما يرام". لكن إقتناع الناس الذين شلهم الهلع على التعاون كان الجانب الأصعب في المهمة.
وأدرك مورجان أن نيكربوكر ترست كان متعذرا إنقاذه ، وأن مؤسسة تسليف أخرى "مؤسسة التسليف الأمريكية" – وعلى الرغم من أنها كانت تستنزف إيداعاتها – إنما كانت مملوءة ماليا. لذلك إرتأى أن "هذا هو الموضع حيث يجب أن تبدأ معالجة المشكلة". وأقنع كورتيليو بإيداع 35 مليون دولار لدى المصارف الوطنية. وطلب إلى المصارف إقراض شركة التسليف الأمريكية . ولما لم يكن لدى المودعين ما يكرههم على سحب أموالهم فإنه ما عادوا راغبين في سحبها. وهكذا زالت موجة الهلع التي ضربت شركة التسليف الأمريكية.
لكن الوضع ظل حرجا. وفي يوم الخميس عبر رئيس بورصة نيويورك شارع برود ستريت إلى مصرف مورجان ليبلغ مورجان بوجوب إغلاق البورصة لأنه لم يعد ثمة قروض تحت الطلب (وهي الأموال التي يقضها السماسرة لعملائهم لتمويل حسابات الشراء بالهامش). وقد رفض مورجان بثقة فغلاق البورصة وأمن ملبغ 27 مليون دولار في خمس دقائق من المصارف الأخرى لتحاشي إغلاق البورصة . واستدعى في تلك الليلة المصرفيين إلى مكتبته الجديدة العظيمة في الجادة السادسة والثلاثين ، ووضعوا خطة للحفاظ على سيولة المصارف وتحسين عمل الموسرة منها التي كانت تعاني ضغوطا كبيرة ،وتوفير مزيد من أموال القروض تحت الطلب للسماسرة. وقد أذاع أنه "سيتم التصدي بالوسائل اللازمة لكل من يبيع على المكشوف مستغلا حالة الهلع". ولم يكن كثير من السماسرة في حاجة إلى من يدلهم على المقصود بذلك. لقد أشرفت الأمور على الإنفلات تقرياب ن لكن سوق نيويورك المالية استطاعت أن تكفل بقية الأسبوع من دون أن تقع ضحية الفشل أو الإنهيار. وبعد أن طلب الإجتماع بالمصرفيين خلال الأسبوع طلب أيضا لقاء رجال الدين (الكهنوت) في المدينة ، وحثهم على إلقاء مواعظ شاحذة للهمم والمعنويات في قداس الأحد.
وبدأت موجة الهلع في الانحسار تدريجيا ، وفي الأسبوع التالي زال الخطر. لقد ساهم كثير من مصرفيي نيويورك من أمثال جيمس ستيلمان وجورج إف بيكر ، عينا ونقدا في دره الأزمة. لكن الرأي العام كان مجمعا على أن مورجان وحده – وكان آنذاك أكثر مصرفيي العالم نفوذا ومكانة ، وربما في كل الأزمان – كان قادرا على جمع شمل مجتمع وول ستريت بأسره وحمله على العمل لأجل المصلحة العامة.
وقد أثنى ثيودور ومصرفي نيويورك الآخرين ، لم يأذن انهيار السوق في العام 1907 ببداية فترة كساد شديد ، كما حدث في انهيارات العامين 1873 و1893 ، لكن ثبت مع ذلك وبصورة قطعية أن البلد غير قادر على الاستمرار من دون مصرف مركزي . صحيح أن رجلا بمكانة جي بي مورجان ونزاهته قد يكون قادرا على التصدي لأي كارثة مالية مستقبلا ، لكن ليس ثمة ما يضمن أن يجود الزمن برجل مثله. كان مورجان قد تجاوز السبعين ، ومع ذلك فقد اقتضى الحصول على الموافقة السياسية لتأسيس مصرف مركزي (نظام الاحتياطي الفدرالي) ست سنوات طوال من المفاوضات المعقدة.
كان على كل المصارف الوطنية الانضمام إلى عضوية نظام المصارف المركزي الجديد ، وكانت مصارف الولاية القادرة على تحقيق متطلبات رأس المال المفروضة على المصارف الوطنية (وقليل منها كان قادرا في الواقع) مخولة بالانضمام إلى العضوية أيضا. وكانت ميزة العضوية – بالطبع – أن يتاح للمصارف الأعضاء – في فترات الهلع – استخدام محافظ قروضها كضمانات للحصول على النقد فورا من مصارف الاحتياطي الفردالي ، وبالتالي إجهاض نزيف إيداعاتها. أما سلبيات العضوية فكانت تتمثل في إضافة مجموعة جديدة من الضوابط إلى الأجهزة الرقابية القديمة – مثل الرقابة على النقد – بدلا من أن تحل مكانها.
وكان الأثر العملي لذلك أن المصارف التي كانت في أمس الحاجة إلى الانضباط والحماية من نزيف الإيداعات كانت هي المصارف نفسها التي تنضوي تحت هذا النظام ، المصارف الريفية الصغيرة المستقلة بذاتها. وفي العام 1920 سيصل عدد تلك الوسائط المالية الواهنة التي تستأثر بالموجودات السائلة لملايين العائلاة والمشاريع الأمريكية إلى ثلاثين ألفا تقريبا. كانت تلك المصارف تنذر بكارثة وشيكة.
وولد نظام الاحتياطي الفدرالي الجديد في العاد 1913 ، وأصبح للولايات المتحدة مصرف مركزي ،وإن كان لا يخلو من العيوب ، للمرة الأولى منذ أن كان أندرو جاكسون رئيسا. إن من أعظم المصادفات في التاريخ الاقتصادي للولايات المتحدة أن جي بي مورجان – الذي كان يعد مضطلعا بمهما المصرف المركزي في معظم حقبة ما بعد الحرب الأهلية – قد ولد في العام 1836 ، في العام نفسه الذي انتهت فيه رخصة المصرف الثاني للولايات المتحدة . وقد توفي في العام نفسه الذي رأى فيه المصرف الاحتياطي الفدرالي – وهو بيدله الذي طال انتظاره – النور.
لقد بدت السنوات الاولى من القرن العشرين لأولئك الذين عاصروها فجر عصر جديد من التقدم والازدهار في هذا البلد. كان البلد يحقق تقدما على الصعيدين الاقتصادي والسياسية لم يعرف له مثيل. وكان الولايات المتحدة لها ثلث خطوط السكك الحديد (من حيث الطول) في العالم ، و40 في المائة من إنتاج العالم من الفولاذ . كما كانت أكبر مصدري المنتجات الزراعية في العالم. وتجاوز دخل الفرد فيها بأشواط كبيرة دخل الفرد في ثاني أغنى الامم – بريطانيا العظمى – التي سيطرت على اقتصاد العالم في القرن التاسع عشر.
لقد ربط أعظم مشروع هندسي في التاريخ – وهو قناة بنما – المحيطين اللذين تشرف عليهما الولايات المتحدة بشواطئها. وقد قهر الأخوان رايت الجو. وكانت السيارات قد شرعت تحل مكان الخيول بوصفها وسيلة النقل المحلي الرئيسية.
لقد بلغت نسبة المتعلمين من الشعب الأمريكي 90 في المائة ، وكان ذلك يشكل قاعدة أساسية لأكثر من ألفين ومائتي صحيفة. وكان في البلد ألف كلية وجامعة ، وتجاوز عدد طلاب المرحلة الثانوية فيها ذاك الذي في أي بلد آخر في العالم.
وهذه الأرض المعطاء – التي ترابطت أوصالها بفضل المراكب البخارية وخط التلغراف كما لم يحدث من قبل – كانت لا تزال بعيدة عن اوروبا وسياساتها الدولية المبغضة للغير وسباق التسلح الخطير الذي انتهجته. وكان جيش الولايات المتحدة من بين أصغر جيوش القوى العظمى ، ولكن اتساع جبهة الأطلسي وامتلاك الولايات المتحدة ثالث أكبر قوة بحرية لحماية تلك الجبهة أسبغ على البلاد شعورا بالأمان والبعد عن كل ما قد يحدث في العالم القديم.
لكن تلك السنوات – مع ذلك – لم تكن في الواقع فجر عصر ولكن الشفق الذهبي لعصر كان في طور الأفول. لقد تميز العصر الفيكتروري – مع قفلته الإدواردية – بإيمان عميق في إمكان التقدم ، وكان عصرا طغى عليه التفاؤل والروح الإيجابية أكثر من أي عصر آخر في التاريخ. هذه التفاؤلية ستكون كارثة كبري ، لا بل وكما نعتها الديبلوماسي والمؤرخ جورج كينان – وكان صائبا - : "أصل كوارث القرن العشرين" ، أي: الحرب العالمية الأولى.
الكارثة الأخرى هي السذاجة الأمريكية والاعتقاد أن العالم الجديد سيظل بمنأى عن اضطرابات العالم القديم ومشكلاته. إذ مع غرق اوروبا في حروب الإخوة Fratricidal في أواخر صيف العام 1914 ، في الوقت الذي كانت فيه قناة بنما قد فتحت أمام حركة التجارة ، أوردت صحيفة النيويورك تايمز في افتتاحيتها ، بروح يملأها الاعتداد بالنفس : "أن المثل الاوروبية تحمل كل نذر الدمار والهمجية في وقت تقدم فيه المثل الأمريكية للعالم جهودا عظيمة لخدمة السلام والنزاهة والمنافسة الشريفة".
لكن في أقل من ثلاث سنوات من ذلك التاريخ ، سيزف أمريكي في باريس إلى العالم القديم خبرا يفيد بأن "أمريكا قد ضمت قواتها إلى قوات التحالف ، وإننا نضع أرواحنا وأموالنا تحت تصرفكم .. إننا نرهن أفئدتنا وشرفنا في سبيل كسب هذه الحرب . لا فاييت ! إننا هنا".
لقد بدأ القرن العشرون بكل ما في الكلمة من معنى – باستثناء المعنى التقويمي – في الأول من اغسطس 1914.
الجزء الرابع: بداية القرن الأمريكي
مقدمة: مرحلة تحول .. الحرب العالمية الأولى
لم تندلع حرب عظيمة ، على نحو غير متوقع أوبسبب جد تافه وبسيط كالحرب العالمية الأولى. لقد كانت القوى العظمى – بالتأكيد – في سباق تسلح لسنوات عدة ، وكانت ثمة مخاطر على السلم مصدرها سلسلة من الأزمات بدأت في العام 1912 . إذ هددت حرب البلقان الأولى – عندما أعلنت صربيا وبلغاريا الحرب على تركيا – بتدخل النمسا وروسيا وإشعال نزاع مدمر. واستجابت أسواق العالم سريعا وبشدة ، فشهدت كلها انخفاضات حادة. وارتفعت أسعار الفائدة. وبدأت الذهب يخرج من الولايات المتحدة عندما عملت المصارف المركزية الاوروبية على بيع استثماراتها الأجنبية وأعادت توطين موجوداتها. لكن الأزمة انتهت بتنازل روسيا.
لكن في وقت كان فيه القلق يساور العالم الغربي ، اعتبر كثير من العرافين والمتبصرين أن حروب القوى العظمى صارت طي الماضيز إذ لم تندلع حرب واحدة في نصف قرن تقريبا. وقد اعتبر نورمان إنجيل – الذي سيفوز بجائزة نوبل للسلام – في كتابه عميق الأثر "الوهم الكبير" الذي نشره في العام 1910 أن تشتت الائتمان الدولي سيجعل تمويل مثل هذه الحروب مستحيلا ، أو سيجعل نهايتها إذا اندلعت سريعة جدا. وكتب أحد الاقتصاديين من كتاب نيويورك تايمز في العام 1914 أنه: "ما من حرب حديثة اندلعت ولاقت معارضة بصوت واحد في أوساط التجارة والأعمال ، ذلك أن الحرب إنما تستمد وقودها من خزائن التجار".
لذلك فإن نبأ إغتيال الأرسيدوق فرانز فيردناند وريث عرش النمسا – هنجاريا في 28 يونيو 1914 لم يثر أي مخاوف فورية. لكن النماس – وهي أضعف القوى العظمى – كانت مصممة على استغلال الفرصة السياسية السانحة في هذا الظرف ، فطالبت بتعويضات من صربيا التي وقعت فيها حادثة الاغتيال ، ودعمت روسيا – وهي القوة السلافية الرئيسية – صربيا وهددت بإعلان التعبئة العامة ، وأبدى القيصر فلهيلم الثاني (إمبراطوري ألمانيا) – الذي كان قادرا على نزع فتيل الأزمة متى شاء بالتأثير في النمسا – دعمه لها.
وفي 28 يوليو بدأت روسيا التعبئة العامة . وتصاعدت الأحداث سريعا وخرجت عن السيطرة – كان إعلان التعبئة العامة في زمن السكك الحديد يتطلب خططا مدروسة ومفصلة . وإذا بدأت التعبئة فلا يمكن وقفها من دون أن تقع الدولة في حالة تنعدم فيها دفاعاتها الذاتية. وعندما بلغ التحذير الذي وجهته ألمانيا إلى روسيا لوقف استعدادتها على جبهتها موعده النهائي في الأول من اغسطس أعلنت ألمانيا الحرب. وفي غضون أربعة أيام كانت كل القوى العظمى في اوروبا في حالة حرب. ولن يحل السلم في اوروبا إلى بعد أربع سنوات وثلاثة أشهر ، ومصرع ثمانية ملايين مقاتل.
وستخسر القارة الاوربية – وكانت مركز العالم الغربي طوال ألفين وخمسمائة عام – أكثر من جيل كامل من شبانها. وعندما وضعت الحرب أوزارها أخيرا ، كان الرابح الوحيد - من الناحية الجغرافية السياسية (الجيوسياسية) هو الولايات المتحدة ، التي ستصبح أقوى أمم الأرض على الإطلاق ومركز العالم الغربي الجديد.
ومع تعاظم خطر الحرب في أواخر أيام يوليو 1914 ، ساد الهلع أسواق الأسهم العالمية وتصاعد الطلب كثيرا على الذهب . وفي يوم الثلاثاء 28 يوليو أغلقت بورصات فيينا وروما وبرلين بعد أن فقدت القدرة على حفظ النظام في سوق التداول. وفي اليوم التالي بلغ حجم التداول في بورصة نيويورك 1.3 مليون سهم ، وهي أعلى قيمة تصل إليها البورصة منذ فترة الهلع التي سادت في العام 1907 ، وانخفضت أسعار الأسهم القيادية بأكثر من 20 في المائة . وفي يوم الجمعة 31 يوليو أغلقت بورصة لندن لأول مرة في تاريخها ، وكانت بورصة نيويورك البورصة الرئيسية الوحيدة التي عزمت على العمل في اليوم التالي.
ولم يكن أمامها من خيار فعلي إلا الإغلاق أيضا . ذلك أنه مع ترابط أسواق العالم بشبكة معقدة من الكيبلات تحت البحر ، فقد تجمع البائعون في نيويورك وبدأت أوامر البيع تتراكم بأعداد هائلة ترقبا لافتتاح البورصة يوم السبت (وستظل بورصة نيويورك تعقد جلسة تداول صباحية يوم السبت إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية). وصوت محافظوا الاحتياط الفدرالي لإغلاق البورصة ، وطلب رئيسها المشورة من جي بي مورجان الإبن وكان يرأس آنذاك بيت مورجان (مؤسسة مورجان المالية) ووزير الخزانة ويليام جيبس ماكادور. وقد أيدوا كلهم ذلك ، فأغلقت بورصة نيويورك وعلقت تنفيذ أوامر التداول إلى إشعار آخر.
ولن تفتح البورصة أبوابها حتى ديسمبر وعلى نطاق ضيق جدا. وفي 30 ديسمبر 1914 لم يتجاوز حجم التداول في البورصة أكثر من 49937 سهما ، وهو أدنى مستوى يبلغه التداول في القرن العشرين. ولن يعود التداول إلى سابق عهده إلا في شهر ابريل من العام التالي. وسيشهد الوضع آنذاك تغيرا جذريا . فقد ثبت خطأ الفرضية التقليدية حول الآثار المالية والاقتصادية التي قد تخلقها أي حرب اوروبية كبرى في اقتصاد الولايات المتحدة.
لقد ظلت أبواب المصارف مشرعة بعد إعلاق البورصة وجرب عمليات سحب هائلة للإيداعات ، وأكثرها كانت ذهبا. لكن ذلك توقف في سبتمبر عندما توقفت الحركة على الجبهة الغربية أيضا. ومع نهاية ذلك الشهر كان الذهب يتدفق إلى نيويورك ليحفظ فهيا. وظل معظمه هناك منذ ذلك الحين ، إذ لا يزال محفوظا اليوم في عمق خمسة وثلاثين قدما أسفل مبنى مصرف الاحتياط الفدرالي في شارع الحرية (ليبرتي) في خزائن قدت في الطبقة الصخرية الام بمنطقة مانهاتن.
في أول الأمر أصيبت التجارة الأمريكية بأضرار بالغة. فتراجعت صادرات القطن بشدة وكذلك صادرات القمح. فلقد اتستوردت ألمانيا 2.6 مليون "شوال" من القمح في يوليو ، لكنها لم تستورد شيئات في اغسطس مع إحكام البحرية الملكية حصارها البحري عليها.
لكن الوضع انقلب سريعا ، وارتفعت الصادرات الأمريكية من المنتجات الزراعية سريعا. كان من الأسباب سوء موسم الحصاد في اوروبا ذلك العام ، مما ضمن للمزارعين الأمريكيين صادرات جيدة بعض النظر عن الحرب الدائرة. لكن السبب الأهم كان أن ألمانيا بسطت سيطرتها على البلطيث ، وعطلت تركيا - وستتحول سريعا إلى حليف لألمانيا – حركة التجارة عبر البحر الأسود ، مما أدى إلى توقف الصادرات الروسية من القمح تماما. لقد كانت روسيا أحد أكبر مصدري القمح في العالم في أواخر القرن التساع عشر ، لكن حصتها من السوق العالمية ذهبت على الفور إلى الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وأستراليا. ولم تسترد حصتها منذ ذلك اليوم. ومن أهم أسباب ذلك بالطبع الدمار الذي لحق الزراعة الروسية على يد الشيوعية.
وبين ديسمبر 1913 وابريل 1914 صدرت الولايات المتحدة ثمانية عشر مليون "شوال" من القمح. وفي الفترة ذاتها من العام التالي. وصلت صادرات القمح إلى ثمانية وتسعين مليون شوال. ومع استمرار الحرب استدعيت أعداد متزايدة من العمال الزراعيين إلى الخدمة العسكرية في اوروبا وظلت الصادرات الزراعية الأمريكية في ازدياد. وارتفع دخل المزارع الصافي في سنوات الحرب إلى أكثر من الضعف ، ليصل إلى 10 مليارات دولار. وارتفعت قيمة الاراضي والأبنية والمعدات الزراعية بنسبة 30 في المائة تقريبا.
كما زاد حجم التصنيع في الولايات المتحدة بمعدلات سريعة ايضا. وباتت أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا التي كانت الشركات الاوروبية تمدها بالسلع الضرورية مفتوحة آنذاك أمام الشركات الأمريكية. والأهم من هذا وذاك كان سيل طلبيات الشراء التي بدأت تتدفق على الشركات الأمريكية من بريطانيا العظمى وحلفائها على منتجات مثل الفولاذ والعربات وكل أنواع مركبات السكك الحديد وقضبان السكك الحديد. ووردت طلبات من الأطراف المتحاربة لشراء الأسلاك الشائكة – وهي ابتكار أمريكي يرجع إلى سبعينيات القرن التاسع عشر كانت الغاية الأساسية منه حماية المزارع الغربية حيدثة العهد بتكاليف بسيطة – وكانت الطبيات بمئات آلاف الأيمال لحماية الخنادق من هجمات الجنود المشاة.
كما كان ثمة طلب كبير على الذخائر الحربية بالطبع من قبل جيوش بريطانيا وفرنسا وايطاليا. كان دوبون شركة متوسطة الحجم تخصصت في تصنيع بارود الأسلحة النارية قبل الحرب ، لكنها ستزود الحفاء بنحو 40 في المائة من حاجتهم إلى الذخائر الحربية. وفي سنوات الحرب الأربع ، ارتفع حجم الإنتاج العسكري في شركة دوبون بنحو 276 ضعفا. وأصبحت من كبرى شركات الكيماويات في العالم كله. لقد هيمنت ألمانيا على صناعة الكيماويات في العالم في العقود التي سبقت الحرب ، لكنها خسرت سوق صادراتها بسبب الحصار الذي ضربته البحرية الملكية عليها. واقتنصت شركة دوبون وغيرها من شركات الكيماويات الأمريكية هذه السوق الواسعة من دون إبطاء . ومع نهاية الحرب تجاوزت الإيرادات السنوية لشركة دوبون ستة وعشرين ضعف ما كانت عليه في العام 1913.
أما شركة بتهليم للفولاذ Bethlehem Steel – وهي مصنع رئيسي للدروع والسفن – فلم يسبق أن حازت عقد تصنيع من خارج البلاد تزيد قيمته على 10 ملايين دولار ، ولكن في نوفمبر 1914 عرضت عليها الأدميرالية البريطانية عقدا بقيمة 135 مليون دولار لتصنيع سفن ومدافع وغواصات. وقد حاولت الحكومة الألمانية – وهي العاجزة عن الوصول إلى محاكاة القدرة الصناعية الأمريكية – أن تنكرها على أعدائها وذلك بشرائها. ففي العام 1915 عرضت على تشارلز سكواب – رئيس شركة بتهليم للفولاذ وكبير حملة أسمهما – ضعف السعر السوقي لأسهمه للسيطرة على الشركة – وعلمت بريطانيا – التي استطاعت استقراء الاتصالات الديبلوماسية الألمانية – بالعرض واستعدت لتقديم عرض مقابل. لكن سكواب طمأن البريطانيين بأنه سيلتزم بتعاقداته وسيرفض العرض الألماني من أساسه.
وعلى العموم ، ارتفع الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 21 في المائة في سنوات الحرب الأربع ، بينما ارتفى التصنيع بنسبة 25 في المائة.
لقد غرقت البلاد في موجة ركود في العام 1914 ، وبفضل الحرب الدائرة في اوروبا بدأت الصناعة الأمريكية تسترد عافيتها والنمو بمعدلات غير مسبوقة منذ الحرب الأهلية. واستشعر أثر ذلك النمو المفاجئ حالا في وول ستريت وحقق مؤشر داو جونز الصناعي أكبر ارتفاع في تاريخه – وقدره 86 في المائة – في العام 1915.
ورأت جنرال موترز – وكانت آنذاك ثانية كبرى شركات السيارات الأمريكية – أن سهمها يفقد 39 في المائة من قيمته في آخر أيام التداول قبل إغلاق بورصة نيويورك في الاول من اغسطس ليستقر عند 39 ، ومع نهاية العام ، مع تدفق طلبيات شراء المركبات ، ارتد سعر السهم إلى 81.5 ، وبعد عام واحد وصلت قيمة سهم جنرال موتورز إلى 500 ، أما سهم بتهليم للفولاذ فارتفع عشرة أضعاف في العام 1915.
وفي مطلع ذلك العام وقعت الحكومة البريطانية اتفاقية مع جي بي مورجان وشركاه ، جعلت المصرف وكيل مشتريات الحكومة البريطانية في أمريكا ، وكانت أولى صفقاتها شراء خيول بقيمة 12 مليون دولار ، وكان ثمة حاجة ماسة إليها لنقل المدفعية والإمدادات على الجبهة (كانت الأسعار الباهظة التي دفعت في شراء الخيول في سنوات الحرب سببا أساسيا لحلول المحاريث سريعا مكان الخيول في المزارع الأمريكية آنذاك). ووقع المصرف بعد ذلك بمدة وجيزة اتفاقية مشابهة مع الحكومة الفرنسية.
لم يكن أحد يتصور عشية اندلاع الحرب قيمة مشتريات الحلفاء من الولايات المتحدة لدعم المجهود الحربي ، لكن وزير الحربية البريطاني اللورد كتشنر قدر ألا تتجاوز 50 مليون دولار. لكن قيمة تلك المشتريات سترتفع – في الواقع إلى أكثر من 3 مليارات دولار ، أي ما يتجاوز أربعة أضعاف الإيرادات الإجمالية للحكومة الفدرالية في العام 19116. كان أثر مصرف مورجان في الصناعة الأمريكية في تلك السنوات – وذلك بفضل قدرته الشرائية العظيمة – كبيرا جدا وكان لدى مورجان فريق من 175 موظفا عاكفين على توفير الإمدادات اللازمة وترتيب شحنها والتأمين عليها.
لكن كان لابد من رفع ثمن الصادرات الهائلة من الذخيرة الحربية التي ذهبت إلى القوى المتحاربة ، ولم يكن ذلك بالأمر اليسير. فلقد بلغت ميزانية الدفاع السنوية البريطانية في السنوات السابقة للحرب 50 مليون دولار وسطيا. وبعد ذلك بفترة وجيزة كانت بريطانيا تنفق 5 ملايين جنيه في اليوم لتخوض غمار الحرب.
وبدأت بريطانيا الآن – وكانت لمدة طويلة مصدر رؤوس الأموال الرئيسي للاقتصاد الأمريكي النامي – ببيع استثماراتها الأمريكية. وفرضت ضريبة خاصة على توزيعات أرباح الأوراق المالية الأمريكية لكنها أجازت للمكلفين (دافعي الضرائب) البريطانيين سداد ضرائب دخلهم بأوراق مالية أمريكية بقيمتها الاسمية. وبذلك قدمتا الخزانة البريطانية الأوراق المالية لمصرف مورجان الذي تدبر أمر بيعها من دون لفت الأنظار ومن دون التأثير سلبا في أسعار الأسهم. لقد بيع 70 لي مائة من الأوراق المالية الأمريكية التي كانت بحيازة مواطنين فرنسيين وبريطانيين مع نهاية الحرب.
ومع ذلك فإن بيع الاستثمارات الأمريكية لم يوفر إطلاقا المال اللازم لمواصلة الحرب ، ولذلك فقد سعت الحكومتان البريطانية والفرنسية إلى الحصول على القروض الأمريكية. وفي بادئ الأمر عارضت حكومة ويلسون – خصوصا وزير الخارجية ويليام جينينج بريان – تقديم أي قروض للوقى المتحاربة ، وأطلق بريان على تلك القروض عبارة "اسوأ ضروب المهربات". لكن بريان – وكان من أشد دعة سياسة الإنعزال ويفتقر إلى المرونة الفكرية – لم يبق طويلا في منصبه وزيرا للخارجية بعد إندلاع الحرب. وقد استطاع خلفه – روبورت كارنينج – إقناع ويلسون بأهمية القروض في استدامة النمور الاقتصادي للبلد.
وفي سبتمبر 1915 رتب مصرف مورجان لقرض بقيمة 500 مليون دولار للحكومة البريطانية ، وهو أكبر قرض مصرفي على الإطلاق في التاريخ حتى الآن. لكن ذلك لم يكن سوى البداية كما ستكشف الأيام . ففي الوقت الذي دخلت فيه الولايات المتحدة الحرب كان مورجان قد رتب قروضا بقيمة 1.5 مليار دولار لبريطاينا ، وأكثر منها لفرنسا. وبعد أن دخلت الولايات المتحدة الحرب ، صارت من كبار مقرضي الحلفاء . إذ ستصل قيمة قروض الحكومة الفدرالية للحلفاء إلى 9.6 مليار دولار ، أي ما يعادل ثمانية أضعاف الدين القومي الأمريكي في العام 1916.
لقد صار جليا في العام 1917 – وعلى الرغم من المعونة المالية والصناعية الكبيرة – أن الحلفاء كانوا في ورطة كبيرة. إذ إن غرق السنف التجارية البريطانية على يد الغواصات الألمانية أنذر بوقوع مجاعة في بريطانيا. بينما كان الجيش افرنسي على شفير العصيان. ومع سقوط نظام القياصرة في روسيا في مارس من ذلك العام ، كانت فرصة خسارة الحلفاء للحرب قد باتت أمرا واقعا.
لقد أدت تصرفات ألمانيا في الحرب – على سبيل المثال انتهاك حياد بلجيكا وإغراق سفينة الركوب العزل لويستانيا – التي أفادت الدعاية السياسية البريطانية منها بفطنة بالغة – إلى انقلاب الرأي العام الأمريكي على قوى المحور. وقد كان استئناف حرب الغواصات المفتوحة في يناير 1917 آخر "قشة" اضطر بعدها الرئيس ويلسون إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع ألمانيا آنذاك.
وبعد شهر ، ذاع على العلن خبر برقية زيمرمان التي وعدت المكسيك باستعادة "أقاليمها السليبة" مقابل إعلان الحرب على الولايات المتحدة إذا اندلعت الحرب بين الولايات المتحدة وألمانيا. وثارت حفيظة الرأي العام الأمريكي وطلب ويلسون – الذي ترشح للمرة الثانية لمنصب الرئاسة في العام 1916 تحت شعار "لقد نأى بنا عن الحرب" – أن يعلن الحرب بعد أقل من شهر واحد من بدء فترة رئاسته الثانية.
وبانخراط أمريكا في القتال الدائر ، اتضحت بجلاء براعة الأمة الأمريكية في التجاوب الفوري للمقتضيات العسكرية . فلقد كان الجيش يعد مائتي ألف مقاتل فقط قبل الحرب ، ولكن بحلول نوفمبر 1918 سيكون في اوروبا مليونا جندي أمريكي ، ومعهم أربعون ألف عربة وشاحنة بالإضافة إلى خمسة وأربعين جوادا وألفي طائرة.
كان أثر الحرب في الوضع المالي للاتحاد بالغا ومستداما ، تماما كما كانت الحال زمن الحرب الأهلية. فمنذ العام 1865 لم تنفق الحكومة في العام الواحد أكثر من 746 مليون دولار ، وهو ما أنفقته في العام 1915. وكان الدين القومي في ذلك العام لا يتجاوز 1.191 دولار (كان يمكن لجون دي روكفلر أن يسدده بنفسه ويظل أغنى رجل في البلاد). وبعد الحرب العالمية الأولى ، لم تقل نفقات الحكومة السنوية عن 2.9 مليار دولار ، وارتفع الدين القومي إلى أكثر من 25 مليار دولار في العام 1919.
كان تطبيق حملات إصدار السندات – باستخدام تقنيات ابتكرتها جاي كوك في أثناء الحرب الأهلية – جاريا على قدم وساق ، لكن بإضافة جديدة آنذاك هي ظهورنجوم السينما من أثمال دوجلاس فيربانكس وماري بيكفورد وتشارلي شابلن لتشجيع المواطنين على شراء سندات الحرية Liberty bonds.
وقد بدأت ضريبة الدخل – التي كانت مجرد أداة لتنظيم المجتمع تحمل الغني على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية – تزحف إلى الطبقة الوسطى. فقد خفض الإعفاء الشخصي – الذي حدد أولا بمبلغ 3 آلاف دولار – إلى ألف دولار. وارتفع معدل الضريبة – وكان لا يتجاوز 7 في المائة على الدخول التي تتجاوز 50 ألف دولار قبل الحرب – إلى 77 في المائة. وهكذا أصبحت ضريبة الدخل أهم مصدر لإيرادات الحكومة الفدرالية ، وبقيت كذلك منذ ذلك الحين. وبدل هذا من جوهر النفط الدائم حول موضوع الضرائب.
كان الخلاف – عندما كانت التعريفات الجمركية مصدرا أساسيا للإيرادات الفدرالية – يدور بين قطاعات الاقتصاد. إذ أيد أصحاب مسانع نيوإنجلاند وعمالهم التعريفات الجمركية المرتفعة على الملابس. أما منتجو المحاصيل الجنوبيون وملاك الأراضي الذين عملوا بها فأيدوا خفض التعريفات. وبتطبيق ضريبة الدخل الآن انتقال الجدال إلى ما بين الطبقات الاقتصادية.
وعلى الرغم من ذلك فلم يطرأ تغير على الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة ، وذلك مقارنة بأملاكها والتزاماتها الدولية. لقد كانت الولايات المتحدة في السابق – بوصفها ملدا ناميا – مستوردا رئيسيا لرأس المال . ولتأكيد ذلك يمكن القول أنه مع الآثار الجانبية الغريبة التي خلفتها دورات الازدهار والهلع والكساد الشديد التي صبغت الاقتصاد الأمريكي في القرن التاسع عشر ، فإن كثيرا من رؤوس الأموال المستوردة انتهت آخر المطاف في أيد أمريكية. ففي فترات الازدهار كان رأس المال يتدفق إلى البلاد لبناء السكك الحديد والمصانع الجدية. ومن ثم وبعد التراجع المحتوم في الأداء الاقتصادي كان حملة الأسهم والسندات الاوروبيون يسعون – بعد أن يصابوا بخيبة الأمل – إلى التخلص من الأوراق المالية التي خسرت كثيرا من قيمتها نظير السعر الذي يتيسر لهم في السوق الأمريكي. وبالنتيجة ، كانت الولايات المتحدة تنتهي إلى حيازة الموجود (الأصل) وحق الملكية.
ومع ذلك – وحتى في تاريخ ليس بالبعيد 1914 – ظلت الولايات المتحدة أكثر الأمم مديونية ، إذ بلغت استثماراتها في الخارج نحو 5.3 مليار دولار مقابل استثمارات اوروبية في الولايات المتحدة بقيمة 7.2 مليار دولار ، بالإضافة إلى هذا ، كانت الحكومات الأجنبية خصوصا فرنسا وبريطانيا مدينة للولايات المتحدة بنحو 9.6 مليار دولار من قروض الحرب. وهكذا وفي أربع سنوات انقلبت الولايات المتحدة من دول مدينة بمبلغ 3.7 مليار دولار إلى دولة دائنة بمبلغ 12.6 مليار دولار.
لقد كان الواقع الجديد للسياسة العالمية أكثر تأثرا مما تبديه الأرقام والإحصائيات. إذ بينما وصل عدد القتلى في صفوف الجيش الأمريكي إلى 126 ألفا في الحرب العالمية الأولى ، فإن فرنسا – التي كان عدد سكانها يقل عن 40 مليونا – فقدت 1357000 من شبابها ، وخسرت الإمبراطورية البريطانية 9.8 آلف ، وألمانيا 1.773 مليون ، والنمسا 1.200 مليون ، وروسيا 1.700 مليون.
وبعد أن خسرت النمسا إمبراطوريتها الاوروبية فقدت مركزها كقوة عظمى. وستصارع ألمانيا ، التي وقع على كاهلها العبئ الذي خلفته اتفاقية فرساي الصارمة في بنودها والجرح النفسي العميق من رؤية جيشها الذي لا يضارع يسقط في مهاوي الهزيمة ، طوال عقد ونيف قبل أن تقع في قبضة النازيين. أما روسيا فستشغل نفسها ببناء الدولة الشيوعية.
كما أن الدول الاوروبية التي خرجت منتصرة وإن شكليا – بريطانيا وفرنسا – قد خسرت مواردها العسكرية والاقتصادية وروحها المعنوية بسبب هذه الحرب العظمى. ولن تعود هذه القوى إلى سابق عهدها في العلاقات الدولية الذي كانت عليه طوال قرون.
وحدها الولايات المتحدة خرجت من الصراع بحال أقوى من الناحية المادية الملموسة ، فقد كانت القوى الصناعية الأولى في العالم طوال العقود الثلاثة السابقة (إلى نهاية الحرب العالمية الأولى) . وهي في هذه اللحظة القوة المالية الأولى في العالم أيضا ، بعد أن أخذت من بريطانيا هذا الدور. وسيبدأ المال بالدوران في فلك مركز الجاذبية المالي الجديد: وول ستريت ، بدلا من شارع لومبارد في بريطانيا.
لقد اضطلعت بريطانيا ، بفضل إمبراطوريتها العالمية وتجارتها العظيمة ، بدور المركز العالمي والمصرف المركزي العالمي – بحكم الواقع – وذلك برغبة منها وكفاءة. وقد رحبت بريطانيا – في الحقيقة – بهذا الدور بوصفه أداة لسلطة كبرى تمارسها على المسرح الدولي. أما الولايات المتحدة فلم تحدها رغبة كبيرة في ذلك – وهي بلد جديد على الساحة الدولية لا يزال متخوفا جدا من "التحالفات المورطة" التي حذر منها الرئيس واشنطن قبل مائة عام خلت. (لقد أصرت الولايات المتحدة على أن يشار إليها بهذا المسمى الغريب "قوة مساعدة" بدلا من "حليف" ، بعد إعلانها الحرب).
ولن يقبل الشعب الأمريكي حقيقة أن بلدهم بات ، وفق تعبير الرئيس جون كينيدي "بمشيئة القدر لا بالإختيار ، حارس أسوار حرية العالم" إلا بعد عقدين من الزمن ، عندما تستنأف الأمم حربها العالمية.
الفصل الخامس عشر: لجم الأسعار في حدود القوة الشرائية
بدأت مصرف الاحتياطي الفدرالي – الذي تأسس في العام 1913 – عمله في أول أيام الحرب العالمية الأولى. لكنه لم يؤد الدور المطلوب منه إلا بعد إعادة إرساء دعائم السلام. وقد ارتكب الخطأ الفادح الاول في سياسته فورا تقريبا.
فكما هي الحال دائما خينما تنشأ الحاجة إلى تمويل حالات العجز الهائل ، سببت الحرب العالمية الأولى تضخا حادا وتضاعف مؤشر أسعار المستهلكين CPI تقريبا بين العامين 1915 و1920 ، وقد أبقى مصرف الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة في متسويات متندية في أثناء الحرب لتأمين حاجة الحكومة من القروض ، وأبقى على تلك المعدلات المتندية حتى نوفمبر 1919. ومن ثم رفع سعر إعادة الخصم – وهو آنذاك وسيلته الأساسية للتأثير في سعر الفائدة – في سلسلة من الخطوات المفاجئة من 4 في المائة إلى 7 في المائة في الأشهر التالية.
كان الاقتصاد في واقع الأمر يسير نحو مرحلة ركود بعد توقف سيل الطلبيات العسكرية ، واستعادة الزراعة الاوروبية عافيتها. وأدى تدخل مصرف الاحتياطي الفدرالي إلى تراجع الاداء الاقتصادي ليبلغ شفير الكارثة. إذ تقلص عرض النقد بنسبة 9 في المائة وارتفعت البطالة من 4 في المائة إلى 12 في المائة. وانخفض الناتج القوي الاجمالي بنسبة 10 في المائة تقريبا. لقد قسم التصحيح الجائر الذي أحدثه مصرف الاحتياطي الفدرالي ظهر التضخم زمن الحرب – على الأقل ، وتراجعت أسعار الجملة بنحو 40 في المائة تقريبا بين العامين 1920 و1921 ، وهذا ما أفضى إلى أشد حالات انكماش الأسعار في التاريخ الأمريكي.
ولحسن الطالع ، تبين أن كسد العام 1920 – 1921 كان قصير الأجل. وتوافرت كثير من الفرص الجديدة في عشرينيات القرن العشرين تولد عتها عقد من الازدهار الكبير.وكانت المحركات الاقتصادية الجديدة لهذا الازدهار المتجدد هي السيارات والكهرباء.
كان اقتصاد نهاية القرن التاسع عشر – الذي هيمنت عليه صناعة الفولاذ والنفط والسكك الحديد – عصر الصناعات الثقيلة . وسيشهد عقد العشرينيات من القرن الجديد ولادة اقتصاد أكثر تركيزا على "المستهلك" ، وهي نزعة تسارعت في البقية الباقية من القرن. لكن بذور الاقتصاد الجديد – بطبيعة الحال – ولدت من رحم الاقتصاد القديم.
لم تكن السيارات اختراعا أمريكيا (على الرغم من أن أحد محامي براءات الاختراع من روشتستر – وكان محاميا فطنا – اسمه جورج بي سيلدون ، لم يصنع سيارة حقيقية لكنه حصل على براءة إختراع سيارة مطورة تعمل "بمحرك هيدروكربون سائل بآلية الضغط" في العام 1879 ، حتى قبل أن تدخل كلمة "سيارة Automobile اللغة الإنجليزية). إذ إن معظم التقنية اللازمة إنما طورت في أوروبا. فقد صنع ألماني يدعى نيكولاس أوتو أول محرك إحتراق داخلي عملي في العام 1876 ، كما ابتكر ألماني آخر هو فيلهلم مايباخ المكربن Carburetor في العام 1893. والمكربن كان آخر قطعة في أحجية صناعة عربة لا تحتاج إلى أحصنة لتجرها ، وبدأ الصفاحون والمستحدثون بالمئات في أوروبا وأمريكا بتصنيع السيارات في الفناءات الخلفية لمساكنهم وفي ورشات الحدادين. وفي العام 1900 صنعت أربعة آلاف سيارة في الولايات المتحدة على أيدي عشرات الشركات والأفراد.
واندلعت منافسة داروينية ضارية تلك التي تحدث في النظام البيئي الطبيعية عند إرتقاء مخلوق جديد أو بلوغ مجاهل جديدة. فلا يكاد يتسنى وضع التقنية الجديدة الخلاقة في التطبيق العملي ، حتى يكون هناك دائما عدد كبير من الأفراد والشركات الذين ينكبون على محاولة الإفادة منها في سبيل الربح ، ومعظمهم يسقط صريعا خارج السباق عندما يعجزون عن المنافسة. ومن ثم مع دخول الصناعة مرحلة النضج ، تضطر إلى الإندماج في شركات أقل عددا وأكبر حجما ، بسبب الحاجة إلى اقتصاديات الحجم والمتطلبات الرأسمالية الهائلة التي تجب تلبيتها. وكان هذا بالفعل واقع السيارات. ففي العام 1903 وحده ، ظهرت إلى حيز الوجود في الولايات المتحدة سبع وخمسون شركة للسيارات ، أفلس منها سبع وعشرون . واليوم ليس في العام أكثر من إثنين وعشرين شركة مصنعة للسيارات فقط – وجلها بالضرورة شركات عملاقة (برؤوس أموال تعد بمليارات الدولارات).
ومن بين الشركات الأمريكية التي بدأت العمل في العام 1903 شركة فورد موتور. لقد أراد أكبر ملاكها (والمالك الحصري لها بعد العام 1915) هنري فورد إنتاج نوع جديد من السيارات ، سيارة لعامة الشعب ، وليس للأغنياء الذين كانوا هم سوق السيارات. صحيح أن السيارة اخترعت في اوروبا ، لكن السيارة الجماهيرية التي بيعت بسعر يناسر دخل الطبقة الوسطى – كانت فكرة أمريكية خالصة ، وقد غيرت هذه الفكرة اقتصاد أمريكا واقتصادات العالم.
لقد ميزت السيارة الجماهيرية القرن العرين عن القرن التاسع عشر ، أكثر من أي تطور اقتصادي آخر . فبعد اقل من ثلاثين عاما من تأسيس شركة فورد موتورز كتب الروائي البريطاني ألدوس هكسلي رواية من الخيال العلمي الكلاسيكسي "عالم جديد شجاع Brave New World" ، صور فيها عالم المستقبل وقد غلب عليه طابع التصنيع إلى درجة ان البشر أنفسهم كانوا يصنعون في مصانع الأطفال ، وأن العالم بدأ بحساب التاريخ ليس منذ ولادة المسيح ، بل من ولادة هنري فورد.
لقد درس هنري فورد – وهو ابن مزارع من ديربورن بمتشيجان ، في المدارس العامة هناك إلى أن اتجه إلى العمل في عمر السادسة عشرة كمتدرب في ورشة للآلات. وقد أظهر على الفور – ولم يكن واسع التعليم والثقافة – مهارة متميزة في علم الميكانيك وشغفا به. وبدأ يمارس أعمال الصفاحة على محركات الحتراق الداخلي في مطلع تسعينيات القرن التاسع عشر ، وفي العام 1896 صنع أول سيارة له في مرآب للعربات حيث كان سكنه . وفي السنوات القليلة التالية صنع عددا من سيارات السباق ذات سرعات قياسية ، وكذلك بمساعدة عدد من أعوانه أسس شركة فورد موتورز في العام 1903.
ولم تصب الشركة في البداية نجاحا يذكر. ومن ثم في العام 1908 خرج فورد بنموذج تي Model T. ، لقد صمم هذا النموذج ليكون ذا قدرة عالية على التحمل والسير على الطرقات الرديئة التي شاعت آنذاك (لم يكن ثمة أكثر من مائتي ميل من الطرقات المعبدة في كل أنحاء البلاد في العام 1900 ، وخارج المدن) ، وأن يكون ذا تكلفة متدنية. كان سعره الأولي 850 دولارا ، وهذا يشكل نسبة لا تذكر من تكلفة معظم أنواع السيارات الآخرى. أما تكاليف تشغيلها فكانت أيضا منخفضة نسبيا ، ولا تتجاوز – وفق بعض التقديرات – بنسا واحد لكل ميل. وحققت السيارة إقبالا واسعا وسريعا من الناس ، فبيع من النوذج تي 10607 سيارات في ذلك العام.
لقد سعى هنري فورد – بعد أن وضع هذا النموذج الذي رأى فيه كل آيات الكمال – جاهدا إلى الوقوف على طرق للحد من تكاليفه التصنينيعة ، وبالتالي جعله في متناول شرائح أكبر من السكان ، وفي العام 1913 خرج بخط التجميع في مصنع جديد أنشئ لهذا الغرض ، في هايلاند بارك بمتيتشجان (لقد قصد فورد إلى معمل لتعليب اللحوم وخلص إلى ما يلي: إذا كان بالإمكان تقطيع الحيوانات على خط إنتاج متحرك ، فإن من الممكن أيضا تجميع السيارات بالطريقة نفسها وتحقيق وفورات كبيرة في اليد العاملة).
لقد استغرق تجميع السيارات من النموذج تي في ذلك العام ثلاثة وتسعين دقيقة فقط. وفي العام 1916 ، خفض السعر إلى 360 دولار فقد ، وباع فورد 730041 سيارة منها. وفي عشرينيات القرن العشرين ، وعلى الرغم من أن التضخم الذي نجم عن الحرب العالمية الأولى ، فإن سعر السيارة من نموذج تي لم يتجاوز 265 دولار ، ومع ذلك لم يعدم فورد الوسيلة لتخفيض تكاليف اليد العاملة بنسبة وسطية قدرها 7.4 في المائة سنويا.
لقد أسفر سعي هنري فورد ، الذي لم يعرف الكلل ، إلى الحد من تكاليف تصنيع النموذج تي ، عن واحدة من أعظم قصص النجاح الاقتصادي في تاريخ العالم. فعلى مدى تسعة عاشرة عاما – التي انكبت فهيا شركة فورد موتورز على تصنيع النموذج تي ، أنتجت الشركة خمسة عشر مليونا من سيارات النموذج ، ولما أوقفت الشركة إنتاجه كانت قد جنت 700 مليون دولار من الأرباح غير الموزعة. كانت فورد تنتج في العام 1920 نصف عدد السيارات المصنعة في العالم. وقد ساعد النجاح الباهر للموذج تي على إنطلاق صناعة السيارات بمجملها. وبعد أن كان إنتاج البلاد لا يتعدى 4 آلاف سيارة في العام 1900 وصل هذا الإنتاج إلى 187 ألف سيارة في العام 1910. وبلغ عدد السيارات التي جادت بها خطوط الإنتاج نحو 1.9 مليون في العام 1920 ، ووصل عدد السيارات المسجلة إلى 8.1 مليون. وفي العام 1929 كان عدد السيارات المصنعة قد بلغ 4.5 مليون وعد السيارات المسجلة 23.1 مليون. وهذا أسدل الستار على خمسة آلاف عام ظلت فيها الخيول وسيلة النقل الرئيسية للإنسان.
ولن يكون من قبيل المبالغة القور بأثر السيارة في الاقتصاد الأمريكي في عشرينيات القرن. إذ لم تكن صناعة السيارات توظف مئات الألوف من العاملين ، بل حرضت الصناعات الأخرى بدرجة كبيرة. ففي عشرينات القرن كانت صناعة السيارات تستخدم 20 في المائة من الفولاذ المنتج محليا (وجميع الفولاذ الصفائحي تقريبا) ، و80 في المائة من المطاط و75 في المائة من الزجاج المصقول.
وفي عشرينيات القرن العشرين ، أصبحت صناعة السيارات كبرى صناعات الاقتصاد الأمريكي . لقد خلق الطلب الكبير في الولايات المتحدة على السيارات عقدا من الازدهار الصناعي العظيم. فقد ارتفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 59 في المائة بين العامين 1921 و 1929 ، فوصل إلى 103.1 مليار دولار. وفي غضون ذلك إرتفعت حصة الفرد من الناتج القومي الأمريكي بنسبة 42 في المائة ، أما الدخل الشخصي فحقق نموا تجاوز 37 في المائة.
وقد أدت صناعة السيارات إلى إرتفاعه عظيم في أعمال الطرق وتعبيدها ، بحيث صارت جزءا أساسيا من صناعة الإنشاءات وحفزت كثيرا أعمال المقالع وتصنيع الأسمنت. وبعد أن كانت الطرق المعبدة شيئا نادر الوجود في العام 1900 ، بلغ طولها في العام 1920 نحو 369 ألف ميل ، وفي العام 1929 وصل إلى 662 ألف ميل. وكما حرضت الطرقات الرئيسية القديمة في أواخر القرن التاس عشر التجارة وحركة التجارة عبرها ، فقد فعلت الطرقات الجديدة الشئ نفسه. كان البنزين يباع أول الأمر في المتاجر العامة وورشات الحدادين التي تحولت - استجابة لتغير السوق – كلها تقريبا إلى مرائت لإصلاح السيارات في نهاية عقد العشرينيات. وفي العام 1905 افتتحت أول محطة بترول أنشئت لهذا الغرض في سان لويس ، وبعد ربع قرن ، ظهرت عشرات الألوف من هذه المحطات ومعظمها بامتياز (الكاز) الذي لا يحتفظ بقوامه – كأحد أهم المركبات البترولية المتطايرة – مما أعطى صناعة البترول مركزا أكبر في السوق.
لقد كانت ثمة ضرورة لتغيير أسلوب الخطاب والإعلان في ضوء تجاوز السيارات بسرعتها كثيرا سرعة الخيول والعربات. ذلك أن العين لن تلتقط صورة اللافتات على الطريق بسرعة ثلاثين أو أربعين ميلا في الساعة إلا لحظيات ، أو سيفوت الناظر إدراكها كلية. واكتسبت شعارات الشركات (اللوجوهات) أهمية خاصة لأول مرة ، حتى في مجالات وحقول أخرى كإعلانات الصحف ، حيث صار الأسلوب المقتضب واللافت للنظر هو الأسلوب "الحديث".
وبدأت السيارات تغير الواقع السكاني (اليدموغرافي) في البلاد. إن تحول التركيبة السكانية من تركيبة يغلب عليها سكان الأرياف إلى تركيبة حضرية كان جاريا منذ فجر الجمهورية ، وقد بلغ أوجه في إحصاء العام 1920 ، الذي كان أول إحصاء يسجل غلبة في عدد سكان المدن على عدد سكان الريف ، لكن السيارة أتاحت ولادة منطقة جديدة تماما: إنها الضواحي.
ويمكن تمثيل الخريطة الديموغرافية للمدينة الأمريكية في القرن التاسع عشر بساقين طويلتين ، حيث كان التركز الحضي كثيفا سكانيا وكانت خيوط طويلة هزيلة من التجمعات السكانية تمتد بمحاذاة السكك الحديد وخطوط الترام. وبين الخطوط قامات أرياف شاسعة. وحالما كان المرء يترجل من القطار ، كان يعود ثانية إلى سرعة الحصان. ومع وصول السيارة إلى تلك المناطق ، صار الناس قادرين على العيش بعيدا عن خطوط السكك الحديد وكان بلوغ المدينة أمرا يسيرا. وبدأت أعداد متزايدة من الناس العيش في الريف والعمل في المدينة.
كما أدخلت السيارة تغييرا على المناطق الريفية تماما كما غير المناطق الحضرية والضواحي. فقد أنهت من ناحية العزلة الخانقة التي عانتها المزارع الأمريكية. إذ عاش المزارعون الاوروبيون عموما في الأرياف وكانا يخرجون إلى الحقول (التي يملكها أشخاص آخرون) للعمل. أما المزارعون الأمريكيون فقد عاش معظمهم في مزارعهم الخاصة التي كانت تبعد أحيانا عن جارتها من المزارع الأخرى ميلا أو يزيد وأميالا كثيرة عن أقرب القرى. كانت الزيارات شاقة وتستغرق وقتا طويلا.
لقد أتاحت السيارة للمستهلك من سكان الأرياف أن يتسوق بعيدا عن مكان أقامته. وقبل وجود السيارة كانت البضائع المتوافرة في المتاجر العامة المحلية تطلب حصرا على طريق أدلة البيع (الكتالوجات) كتلك التي تنشرها متاجر سيرز Siars وروبك Roebuck ومنتجومري وارد Montgomery Ward ، وقد بدأت السيارة الرخيصة تغير هذا الواقع كله. كانت الاحتكارات القريبة التي أدارها التجار والمصارف المحلية تنتهي إلى الإفلاص عندما يتاح لعملائها الإنتقال بالسيارة إلى البلدات الكبيرة حيث يتسوقون هناك ، مستفيدين من رخص الأسعار الذي يميز دائما الأسواق الكبيرة. وبدأت التجارة في البلدات الصغيرة تنحدر ، ولا تزال في تراجه منذ ذلك الحين. ولأن المصارف المحلية كانت تعتمد في أعمالها المستقلة على اقتصادات المجتمعات المحلية التي عملت فيها ، فقد بدأ كثير منها في التراجع بعد أن شرع عملائها يلتمسون مصارف أخرى. كان ثمة عدد هائل منها – بلغ في العام 1921 ذروته عند 29798 – وكلها تقريبا منافذ بفرع واحد لا تتجاوز قبعة موجوداتها مليون دولار ، كما أنها لم تكن عضوا في نظام الاحتياطي الفدرالي. ونزعت حالات فشل المصارف في الولايات المتحدة في عشرينيات القرن العشرين إلى الإرتفاع على الرغم من حال الإنتعاش الاقتصادي العام. ومع نهاية العقد صار معدل فشل المصارف في المناطق الريفية يتجاوز ستمائة مصرف، وكانت تلك المصارف تذهب بمدخرات عملائها أدراج الرياح.
ولقد جلبت السيارة أيضا ضغوطا كبيرة جدا على اقتصاد المناطق الريفية عموما. ففي العام 1900 كان ثلث أراضي المزارع مخصصا لمحاصيل الأعلاف التي خصصت للأعداد الكبيرة من الخيول والبغال ، مصدر الطاقة الرئيسي في قطاع النقل المحلي والصناعات الزراعية. وفي العام 1929 اختفى معظم تلك القطعان بعد أن حلت محله السيارات وتحولت كثير من الأراضي التي كانت تزرع فيها محاصيل الشعير والشوفان إلى زراعة محاصيل الغذاء البشري ، مما زاد من عرض المواد الغذائية إلى مستويات فاقت الطلب عليها ، فتراجعت الأسعار تراجعا حادا. وكانت النتيجة عصيبة على كل المزراعين الذي لم يروا الأسعار تعود إلى سابق عهدها بعد الانخفاض الحاد في طلبيات الشراء الاوروبية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. إن الكساد الذي عصف بالزراعة الأمريكية – الذي لم تستشعره آنذاك وسائل الإعلام العاملة في المدن- سيتسع ويستفحل رويدا وريدا.
كانت الكهرباء لغزا عصيا على الفهم في القرن السابع عشر وحيلة ساحرة في القرن التاسع عشر ، عندما سعى أشخاص مثل بنجامين فرانكلين إلى اكتشاف ماهيتها. ومع أن مطلع القرن التاسع عشر تميز بمعرفة أوسع بالكهرباء وماهيتها (في العام 1831 أثبت الفيزيائي البريطاني الكبير مايكل فارادي مهاية الكهرباء والمغناطيسية) وسيخرج بأولى التطبيقات العملية للكهرباء – وهي البرق أو التلغراف – فإن الكهرباء لن تفرض حضورها في الحياة اليومية إلا في نهاية القرن. ولم يكن لأحد الفضل الأكبر في هذا كما كان لتوماس أديسون الذي اثبت أنه عبقري النبوغ الامريكي مثلما كان شكسبير عبقري الدراما.
ولا يزال توماس أديسون "يذكر اليوم بفضل سيل إبتكاراته التي لا تحصى ، والتي نقلت العالم من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين. ويعلم كل تلميذ اليوم أن أديسون ابتكر – أو ساهم كثيرا في ابتكار – الحاكي (الفونوغراف) وشريط البورصة المتحرك والهاتف (إلى جانتب التحسينات الميكانيكية المهمة على جهاز جراهام بل الأصلي ، كما كان أديسون هو من نحت كلمة Hello بالإنلجيزية) والأفلام وبالطبع المصباح الكهربائي.
لكن الناس قلما تذكر إثنين من أعظم ابتكارات أديسون لأنهما بطبيعتها لا يمكن أن يدرجا في نظام براءة الإختراع. أحدهما ولا ريب أعظم إبتكاراتها كلها: مختبر البحوث الصناعية. فقد أنشأ أديسون مختبره الخاص في مينلو بارك في نيوجيرسي العام 1876. وهناك صنع الحاكي (العام 1877) والمصباح الكهربائي (العام 1879) ومئات الإختراعات الأخرى. كان هذا المختبر ورشة إختراع ، عمل المهندسون والكيميائيون فيها على تحويل الفرص التقنية الجديدة إلى منتجات عملية ، والأهم إلى منتجات قابلة للتسويق التجاري.
وعندما تأسست جنرال إليكتريك General Electric في العام 1892 على يد جي بو مورجان بعد دمج شركة أديسون جنرال إلكتريك وكبرى منافساتها شركة تومسون هيموستون إليكتريك ، عملت الشركة الجديدة على تأسيس مختبرها الخاص في مقرها الرئيسي في شينكتادي بنيويورك. وصارت الشركة – على الفور – مثالا يحتذى بعدد من مختبرات البحوث المؤسسية التي سيخرج منها دفق لا ينتهي من الابتكارات والتطبيقات العملية للتقنية الجديد. إن ثمار الفكرة الأم التي جاء بها أديسون لاكساب عملية الابتكار طابعا صناعيا – أي تحويل النبوغ الأمريكي إلى منتج صناعي – لا تحصى. من السلوفان (الورق الشمعي الشفاف) والنايلون والمطاط الصناعي إلى الترانزستور والتيفون والمعالج الصغير microprocessor ليست إلا غيض من فيض أهم الإبتكارات . وفي العام 2003 حصلت شركة أي بي إن IBM وحدها على أكثر من 3400 براءة إختراع.
ومن ابتكارات إديسون الأخرى التي لم تنل حظها من الشهرة نظام الطاقة الكهربائية الذي يمكن به إنارة منتفخ المصباح. إذ أنه انكب – حالما صار منتفخ المصباح قابلا للتشغيل – على إنشاء محطة توليد للكهرباء ومد خطوط الكهرباء في منطقة مساحتها ميل مربع في الضاحية التجارية في منهاتن. وفي العام 1880 حصل عمن المدينة على حق "مد الأنابيب والأسلاك والموصلات والعازلات ونصب أعمدة الإنارة في الشوارع والجادات والحدائق والأماكن العامة في مدينة نيويورك – لتوصيل الكهرباء أو التيار الكهربائي واستخدامه لأغارض الإنارة".
وأنشأ أديسون أول محطة للطاقة في العالم في شارع بيرل ستريت Pearl street ، وأقام فيها ستة من أعظم المولدات على الإطلاق ، يزن كل منها ثلاثين طنا . كان يعمل ليلا لكي لا يعرقل حركة المرور في مدينة نيويورك التي كانت أساسا تعاني إزدحاما كبيرا ، فحفر خنادق لللوحات الرئيسية بلغ طولها الإجمالي خمسين ميلا ، وأرسل عمالا لتوصيل الأسلاك إلى المنازل والمحال التجارية التي كانت أصحابها مستعدين للإشتراك في الخدمة الجديدة.
وكما هو شأن كل تقنية جديدة كان على إديسون أن يخرج بحلول سريعة لمشكلات لا تحصى ولم تدر بخلده قبل أن تظهر. من هذه المشكلات احتمال تسرب التيار تحت طبقة الرصيف لينتقل إلى الأحصنة عبر حدواتها فيهيجها. وكان كثير من الحلول الإرتجالية التي وضعها إديسون يستحق براءة إختراع. وقد تقدم في العام 1882 للحصول على ما لا يقل عن 102 براءة إختراع – وهو أكبر عدد من البراءات في سنة واحدة- في أثناء إنهماكه في إنشاء نظامه الكهربائي.
وأخيرا – عندما كان إديسون واقفا في مكتب جي بي مورجان في الساعة الثالثة ظهرا يوم 4 سبتمبر 1882 - أغلق الدارة وأنيرت 106 مصابيح في مكاتب شركة دركسل ومورجان وشركاهم. واشتعل كثير من هذه المصابيح أيضا في مكاتب صحيفة النيويورك تايمز التي اشتركت في الخدمة التي كانت إديسون يقدمها ، وفي المحال التجارية على طول شارع فلتون. ولم تخلف تلك الأضواء انطباعا يذكر في وضح النهار. لكنها بدت في مساء ذلك اليوم مقدمة حدث ذي شأن. وأوردت صحيفة الهيرالد نيويورك في اليوم التالي أنه "في المتاجر ومكاتب العمل عبر أحياء المدينة السفلية كان ثمة وهج غريب في الليلة الماضية. لقد استبدل بذبالة الغاز الكالحة – التي كانت تتقطع وتكبو بفعل الشوائب – وهج دائم ساطع يبعث على الإرتياح أضاء العتبات الداخلية وسطع عبر النوافذ بإشعاعه المستقر والمتواصل.
وانتشرت الكهرباء في السنوات القليلة التالية عبر الضواحي التجارية والمناطق السكانية الراقية في مدن البلاد ، لكنها ظلت آنذاك عالية التكلفة ، وداوم أكثر الناس على تدبر أمرهم باستخدام مصباح الغاز ، أما أولئك الذين كانوا بعيدين عن محطات الغاز في المدن فقد إستخدموا الكاز (الكيروسين). لكن سكرتير توماس أديسون الأسبق – صموئيل إنسل – سيثبت أنه "هنري فورد" صناعة الكهرباء ، وسيجعل التقنية الجديدة في متناول الشخص العادي ليغير – إلى الأبد – وجه الاقتصاد الأمريكي.
ولد إنسل في لندن في العهام 1859 لعائلة من الطبقة الوسطى الدنيا واشتغل في بيت للمزادات عندما كان له من العمر أربعة عشر عاما ، وواظب على الدراسة ليلا. وعندما بلغ الثامنة عشرة تحول إلى العمل لدى وكيل أديسون في بريطانيا ، الذي انبهر بحماسته وقدراته الإدارية. فأرسله في العام 1881 إلى الولايات المتحدة ليعمل سكرتيرا شخصيا لإديسون – وصار مساعده الذي لا غنى له عنه ، ذلك أن إديسون لم يكن يتمتع ببراعة رجل الأعمال كما تصور في نفسه.
وأسلم إديسون إدارة شركة إديسون جنرال إليكترريك لإنسل ، وكانت الشركة آنذاك في مرحلة صراع على البقاء – فنجح إنسل في إنتشالها . ولكي يستقل بنفسه عن إديسون ، نقل الشركة إلى شينكتادي مبررا ذلك بقوله: "لم نحقق أرباحا تذكر حتى نقلنا المصع مسافة مائة وثمانين ميلا عن السيد إديسون". وفي بضع سنوات زاد إنسل حجم عمل الشركة كثيرا فزادات الأيدي العاملة من مائتين إلى ستة آلاف ، وارتفعت أرباح الشركة كثيرا.
وعندما إنضوت الشركة تحت لواء شركة جنرال إليكتريك بعد الإندماج ، قرر إنسل – الذي ظل يحصل على تعويض مجز آنذاك قدره 36 ألف دولار سنويات – أن يمضي قدما. كان أكثر اهتماما ببناء شبكة للطاقة الكهربائية من مجرد الاكتفاء بتصنيع الأجهزة الكهربائية ، وقبل تولي إدارة إحدى شركات توليد الكهرباء في شيكاغو التي حملت اسم إديسون (تكريما له ، ولم يكن له أي حصة مالية فيها). ولم يتجاوز عدد زبائن الشركة عندما انضم إليها إنسل في العام 1892 خمسة آلاف. وكانت واحدة من ثلاثين شركة توليد كهرباء في تلك المدينة.
كانت التكلفة المرتفعة عائقة يحد من عدد مشتركي خدمة الكهرباء ، إذ كانت إنارة مصباح واحد لساعة واحدة تكلف سنتا واحدا (كان ذلك المصباح لا يولد خمس كمية الضوء الذي ينبعث من مصباح اليوم وعند الإستطاعة الكهربائية نفسها) . وكان عامل المحطة الذي يكسب آنذاك 750 دولار في السنة يعد سعيد الطالع. لذلك كان المصباح الكهربائي من دواعي الرفاهية التي لم يكن يصيبها إلى قلة من الناس.
وكانت ثمة مشكلتان أفضتا إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الكهرباء. أولاهما أن توليد الكهرباء كان عملا يتطلق كثافة كبيرة في رأس المال . أي إن اقتصادات الحجم كانت عنصرا بالغ الأهمية. لكن في أول أيام ظهور الكهرباء ، كانت المولدات صغيرة الحجم نسبيا ، وهكذا فإن كبرى المشاريع التجارية من أمثال متاجر الأقسام والمصانع فضلت بناء مرافق توليد الكهرباء الخاصة بها بدلا من شراء الكهرباء من إحدى شركات المرافق العامة. ولأن عدد المشتركين كان منخفضا ، فقد كان سعر الواط الساعي مرتفعا بالضرورة.
وحاول إنسل أن يخرج بحل لهذه المشكلة . فقد أقام أكبر محطة لتوليد الكهرباء في العالم في شارع هارسيون في شيكاغو ، واعتمد نموذجا جديدا للمولدات يستهلك نصف كمية الفحم المستهلكة في النموذج القديم. كما عمل أيضا على شراء الشركات المنافسة لتوسيع أسواقه. وفي العام 1898 باتت شركته تملك كل مرافق توليد الكهرباء في حدود منطقة التوزيع الخاصة به وضاعفت حجم محطة شارع هاريسون. لكنه عندما شرع في تزويد وسائط النقل العام وخطوط القطارات العلوية ، فإنه كان في حاجة إلى مزيد من الطاقة.
وارتأى إنسل إن يضع رهانه في تقنية جديدة تماما. فحتى ذلك الحين كانت أجهزة التوليد التي تعمل بقوة البخار تستخدم محركات تبادلية ، حيث كانت المكابس فيها تتحرك للأععلى والأسفل لإدارة ذراع التدوير وتوليد الطاقة. كانت تلك المحركات مصدر ضجيج وكانت إذا ما أريد منها العمل بكامل استطاعتها تهتز على نحو خطير ، وبالتالي كانت تحتاج إلى صيانة دائمة. وفي رحلة له إلى إنجلترا شاهد إنسل زورقا سريعا يسير بمحرك بخاري جديد الطراز ابتكره تشارلز بارسون وأطلق عليه اسم العنفة (الطوربين). وبالتالي وبدلا من أن تتحرك أذرع المكبس للأعلى والأسفل كانت العنفة تدور بسلاسة بفعل قوة البخار التي تضرب شفرات مروحة الدفع بسرعة عائلة فتولد طاقة أكبر لكل وحدة من الوقود ولا تتطلب صيانة كثيرة.
واعتد إنسل أن العنفة البخارية تصلح تماما لتوليد الكهرباء ، لكن كان عليه في المقام الأول أن يلتمس من جنرال إليكتريك إنتاج محركات بالحجم الذي يريده ، والذي يتجاوز كثيرا حجم المحركات التي صنعها من قبل. وكان مجلس إدارة الشركة قلقا جدا من الفكرة ، مما اضطر إنسل إلى أن يضمن للشركة بصفة شخصية أي خسائر قد تتولد عن فشل محطة التوليد الجديدة التي تعمل بطاقة العنفات ، والتي خطط لإنشائها في شارع فيسك ، ولما باتت الحطة جاهزة للعمل ، طلب المهندس إلى إنسل التنحي جانبا تحسبا لأي طارئ قد ينتج عن إنفجار العنفات . فأجابه إنسل: "حسنا إذا انفجرت العنفات ، فإن نهايتي إلى دمار في الحالتين ، لذلك سأبقى حيث أنا".
ولم تنفج رالعنفات. وهكذا أطلقت ثورة في صناعة توليد الكهرباء لأغراض تجارية ، فقللت كثيرا من تكاليف الكيلو واط الساعي. واصبحت عنفة البخار سريعا وسيلة شائعة في توليد الكهرباء ، وما زالت حتى يومنا هذا.
لكن كبرى المشكلات التي ظلت مقترنة بتخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء كانت تتلخص في أن الكهرباء – وهي شيء فريد في خصائصه مقارنة بالسلع الضرورية الأخرى – لا يمكن تخزينها. إذ لابد من تولديها لحظة الطلب عليها. لذلك كان لابد أن تكون القدرة التوليدية كبيرة بما يلبي الطلب وقت الذروة ، وحتى وإن أدى ذلك إلى وجود قدرة فائضة مرتفعة التكلفة معظم الوقت (95 في المائة من الوقت) ، وبالتالي كان لابد من توزيع تكاليفها بالنسبة والتناسب على كامل الفترة.
ومرة أخرى – وفي أثناء رحلته إلى إنجلترا – وقع صموئيل إنسل على حل جزئي للمشكلة . إذ كانت ضروب عدادات الكهرباء تقيس كمية الكهرباء المستهلكة بين قراءات العداد ، كما هي حال معظم عدادات الكهرباء المنزلية حتى اليوم (ابتكر توماس إديسون عداد يؤدي مرور تيار كهربائي بسيط فيه إلى انصهار الزنك وتقاطره على صفيحة أسفله ، ويقيس قارئ العداد وزن الصفيحة لتحديد كمية الكهرباء المستهلكة) ، لكن إنسل تحدث في بلدة بريتون – حيث تكثر المنتجعات – التي تقع على الساحل الجنوبي لإنجلترا إلى مبتكر عداد يسجل ليس فقط كمية الكهرباء المستهلكة ، بل – وهذا الأهم – زمن استخدامها.
وهكذا يتغير إستهلاك الكهرباء من فترة إلى أخرى في اليوم تغيرا كبيرا لكن يمكن تقديره ، إذ يبلغ ذروته ما بين الساعة 4 ظهرا و8 مساءا ، ويصل إلى أدنى مستوى له بين الثانية والخامسة صباحا. وأدرك إنسل أن أي كمية قد تقنع المشتركين باستهلاكها في فترات تراجع الاستهلاك تعتبر في واقع الأمر ربحا لا تترتب عليه أي تكاليف تذكر ، أيا كان السعر المحدد على ذلك الاستهلاك ، في حين أن إقناع المشتركين بتقليل استهلاكهم في أوقات الذرة قد خفض تكاليفه الرأسمالية بفضل تقليص القدرة التوليدية التي كان عليها تأمينها والحفاظ علي سويتها. ووضع العداد الجديد في العام الأول قيل الاستخدام في شيكاغو ، فتراجعت أسعار الكهرباء بنسبة 32 في المائة ، وبدأت الطلب يتعاظم كثيرا.
ووصلت الكهرباء أول الأمر إلى المتاجر والمصانع ووكالات الإعلانات ، وفي العام 1910 بات منزل من كل ستة منازل موصولا بشبكة الكهرباء وارتفعت النسبة بمعدلات سريعة منذ ذلك الحين. وفي عشرينيات القرن العشرين شارفت تجارة مصابيح الغاز على الإندثار.
كان الاستخدام المتزايد أبدا للطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة إحدى عجائب القرن العشرين. ففي العام 1902 استهلكت الولايات المتحدة ستة مليارات كيلو واط ساعي من الكهرباء أي ما يعادل 79 كليو واط ساعي للفرد. وفي العام 1929 وصل الاستهلاك إلى 118 مليار كليو واط ساعي بمعدل 960 كيلو واط ساعي للفرد ، أي ما يفوق عشرة أضعاف ما كان عليه. واليوم وصل استهلاك الكهرباء إلى مستويات هائلة ، 3.9 تريليون كيلو واط ساعي ، أي أكثر من 13500 للفرد أو 170 ضعف الاستهلاك الفردي في العام 1902.
لقد كان مصدر هذا الارتفاع الهائل في استهلاك الكهرباء ليس مجرد زيادة أعداد الذين تحولوا إلى استخدام الإنارة بالكهرباء ، ولكن أيضا أن الكهرباء باتت تستخدم في توفير الطاقة لمزيد من الأعمال والصناعات. وقد أثر ذلك في الاقتصاد الأمريكي على صعد شتى. فمن ناحية غيرت الكهرباء من طبيعة المصانع جذريا. فالمحركات البخارية تفتقر كثيرا إلى كفاءة تحويل الطاقة الكامنة في الوقود إلى طاقة حركية . وكلما كان مقدار التحويل صغيرا ، انخفضت درجة الكفاءة. لذلك كانت مصانع القرن التاسع عشر ذات سقوف عالية لتستوعب أكبر حجوم المحركات البخارية في طبقاتها السفلية. وقد كان المحرك يمد بالطاقة أنبوبا يمتد أعلى البناء وتتفرع منه قنوات أفقية عند كل طابق لاستقبال الطاقة. لذا كان من الضروري تقليص أطوال تلك الأنابيب والقنوات إلى أدنى حد ممكن.
لكن المحركات الكهربائية الصغيرة تتمتع بالدرجة نفسها من الكفاءة التي للمحركات الكبيرة (بل إنها تتفوق عليها أحيانا بطريقة أو بأخرى) ، لذلك كان من الحكمة – بعد أن هبط سعر الكهرباء إلى مستوى معقول – أن تزود كل آلة بالطاقة بمفردها ، مما يلغي الحاجة إلى أنابيب وقنوات نقل الطاقة (يسير المحرك الكهربائي على الآلية نفسها التي يعمل بها المولد الكهربائي ، مع فارق وحيد هو أن الآلية متعاكسة. فالأول يستهلك الكهرباء لتوليد الطاقة والثاني يستهلك الطاقة لتوليد الكهرباء). وبدأت المصانع بعد أن تحررت من الحاجة إلى وصل الآلات بالأنبوب العمودي البارز من المحرك البخاري تتوسع أفقيا على مستوى واحد.
لقد رفع استخدام الكهرباء المتزايد من الإنتاجية إلى مستويات كبيرة في عشرينيات القرن العشرين. مما زاد إنتاجية العامل بنسبة 21.8 في المائة في ذلك العقد. وقد ساعد على زيادة الناتج الصناعي بأكثر من 90 في المائة ، ومع أن الكهرباء والمحرك الكهربائي الصغير ظهرا منذ عامين سبقا ، فإن الآثار الكاملة لتوظيفهما في الإنتاج الصناعي لم تتكشف إلا في عشرينيات القرن العشرين. وهذا هو دائما شأن التقنية الجديدة بسبب ما يطلق عليه علماء الاقتصاد "مشكلة القاعدية التقنية القائمة حاليا". فالتقنية الجديدة قائمة وموجودة أصلا وقد بذل ثمن حيازتها في الأساس. لذلك لا مبرر اقتصاديا يدعو إلى استبدالها إلى حين تتقادم. إن قنال إري التي ألغت السكك الحديد الحاجة إليها في خمسينيات القرن التاسع عشر (وجعلتها تقنية متقادمة) ظلت طريقا للشحن حتى العام 1970 . واليوم يعتبر الحاسب الشخصي المصدر الأساسي للمكاسب الهائلة التي تحقق في الإنتاجية في السنوات الأخيرة ، على الرغم من أن الحاسب الشخصي ظهر قبل ربع قرن تقريبا من الآن.
الأهم من ذلك أن المحركات الاقتصادية الصغيرة بدأت تمد بالطاقة عددا متزايدا باطراد من الأجهزة المنزلية في عشرينيات القرن العشرين ، كالثلااجات والمكاوي والمكانس الكهربائية ومجففات الشعر وآلت الغسل وأجهزة المذياع والحاكي ، علي سبيل المثال ، هذه الأجهزة بدأت تحل مكان خدم المنازل على نطاق واسع ، وتحول الخدم إلى أعمال أكثر انتاجية. وانتهى كثير منهم إلى العمل في المصانع لأداء الوظائف التي خلفها الجنود واءهم في الحرب العالمية الأولى ، ولم يتركوا تلك الأعمال والوظائف. وبفضل الأجهزة المنزلية الجديدة بدأت الحاجة إلى الخدم تتراجع باطراد . كما أن المنازل التي لم يعمل فيها الخدم في أداء الأعمال المنزلية بات الحفاظ علة نظافتها (ونظاف غسل سكانيها) أمرا في غاية اليسر والسهولة. وكما كانت الحال في القرن التاسع عشر صارت الطبقة الوسطة قادرة على الاستمتاع بأسلوب حياة كان حكرا على الأغنياء.
هذه الآلالت الجديدة العجيبة – خصوصا السيارات – كانت بالطبع عالية التكلفة ، ولم تكن العائلة متوسطة الدخل قادرة على تأمين متطلبات حيازتها. وفي مطلع القرن العشرين لم تكن إلا لقلة من الأسر حسابات مصرفية ، كما لم يتوافر إلا لقلة منها سبل الإقتراض. ولم يكن المصرفيون – وهم الذين وجدوا لخدمة التجار والأثرياء – يلقون بالا إلى العملاء ذوي الإمكانات المداية المتواضعة ، مع أن ثمة استثناءات بارزة كانت هناك من أمثال إي بي جيانيني الذي أنشأ مصرف أمريكا سان فرانسيسكو الذي سيصبح أكبر مصارف البلاد.
لذلك بدأت مصنعوا الأجهزة الجديدة في تقدريم عروض البيع بالتقسيط الشهري لما يطلق عليه علماء الاقتصاد "السلع المعمرة" أي تلك التي يتجاوز عمرها الاستهلاكي عشر سنوات. وقد أدى هذا إلى زيادة عظيمة في عدد المشتركين بالطبع ، وأدى اتساع السوق إلى انخفاض الأسعار مما زاد بدوره من حجم السوق. لذلك فقد أصبح للأعداد المتزايدة من السكان ذوي الدخول التصرفية (الدخل التصرفي Disposable income: مقدار الدخل المتوافر للأسر بعد دفع ضرائب الدخل الشخصي وأقساط التأمينات الاجتماعية. ويعتبر من المحددات الأساسية لحجم الانفاق الاستهلاكي والمدخرات في الاقتصاد) العالية (الدخول التي تزيد على ما يلبي الضروريات ) تأثير كبير في الاقتصاد الأمريكي في عشرينيات القرن العشرين.
كان ذلك بمنزلة قفزة كبيرة نحو الديموقراطية ، خصوصا الشركات الصناعية العملاقة صارت تلبي مزيدا من حاجات المواطن العادي ورغباته وأيضا تنمي تلك الحاجات والرغبات. وقد تساءل هنري فورد مفسرا فلسففته التجارية وراء اهتمامه بالأسواق الجماهيرية: "لم التردد بانتظار الفرصة التجارية المواتية" فلنخفض التكلفة بالإدارة الرشيدة . فلننزل بالأسعارإلى مستوى القدرة الشرائية".
لكن تلك الأسواق الجماهيرية كانت أكثر من مجرد أسعار رخيصة. وقد استوعبت بعض الشركات هذه الحقيقة أفضل من غيرها من الشركات . ورفض هنري فورد الذي كانت تستحوذ عليه فكرة أن النموضج تي هو النموذج الأمثل أن يعدل تصميم النموذج بعد العام 1908، وركز بدلا من ذلك على إجراء مزيد من التخفيضات السعرية. بل إنه رفض أيضا إضافة مفتاح التشغيل الكهربائي إلى السيارة بعد أن صار متاحا في العام 1912 ، بسبب ثقل المدخرة (البطارية). وأصبح مفتاح التشغيل الكهربائي على الفور ميزة شائعة في السيارات الأخرى ، لأن استخدامه كان أكثر أمانا من ذراع التدوير اليديوة (كان من الممكن أن يكسر ذراع التدوير – وهذا ما وقع في حالات عدة – ذراع السائق سئ الطالع). كما أنه أتاح لكثير من الناس – كالنساء والشيوخ – قيادة السيارات من دون مساعدة. ولم يقدم فورد عرض البيع بالتقسيط كما لم يطل سيارته بغير اللون الأسود (الذي كان يجف على نحو أسرع من الألوان الأخرى ، مما كان يحد من التكلفة).
وفي منتصف العشرينيات من القرن العشرين صار النموذج تي عتيق الطراز من الناحيتين التقنية والتجارية ، لكن فورد رفض التغيير. وبدأ مركزه الذي كان لا يضارع ذات يوم كأكبر مصنع للسيارات في العالم يتقهقهر بعد أن تفوق عليه منافسه الأمريكي شركة جنرال موتورز التي نجحت في استقطاب المستهلك الأمريكي. لقد عد فورد – وفق نموذج الأعمال الذي انتهجه – أن السيارة كانت مجرد وسيلة للنقل. وبالتالي فكلما كانت أقل ثمنا كان ذلك أفضل للمستهلك. لكن ألفرد بي سلون Sloan وكبار أعوانه في جنرال إليكتريك أدركوا أن السيارة لم تعد مجرد وسيلة للنقل ، فقد صارت جزءا من إدراك الأمريكيين لأنفسهم وللآخر. صارت رمزا للمكانة الاجتماعية ووسيلة للتعبير عن الذات. لا تختلف في ذلك عن الملابس في شئ.
وأسست جنرال موتورز شركة جنرال موتورز للتسليف لتمويل شراء منتاجاتها ، مما أتاح للعملاء الإرتقاء في سلم السوق (شراء منتجات أعلى ثمنا). ووفرت بدلا من نموذج واحد سلسلة واسعة من النماذج والعلاامات التجارية ، من شيفروليه إلى كاديلاك . وهذا ما فتح الطريق أمام نموذج أعمال دأبت كليات الأعمال طوال أجيال على تسميته "نموذج الطبقة الجماهيرية" Mass Class Model.
وفي العام 1927 ، وكانت السيارة رقم خمسة عشر مليونا من نموذج تي قد خرجت لفورها من خط التجميع الذي كان ذات يوم ابتكارات ثوريا ، لم يكن أمام هنري فورد وهو يرى سيارات كاسدة تغطي فدادين من الأرض ، إلا أن يغلق المصنع ثمانية عشر شهرا انكب خلالها على تجهيز مصانعه لإنتاج سيارة حديثة هي النموذج (أ). وعندما استنأفت شركة فورد موتورز الإنتاج باتت جنرال موتورز اكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم ، ولا تزال إلى اليوم.
كان مغزى هذا الدرس لا لبس فيه: فقد عجز المالك الحصري لشركة صناعية يعد رأسمالها بمليارات الدولارات وأحد أغنى ستة رجال في العالم عن مقاومة اتجاه السوق الأمريكية الجديدة طويلا ، وصارت مقاليد الاقتصاد الأمريكي في يد المستهلك.
لكن ، حتى إن كان المستهلكون يملكون زمالم السيطرة فهم غير قادرين على تبوؤ مركز القيادة ، ولم يكن الاقتصاد الأمريكي يدار كما ينبغي في عشرينيات القرن العشرين. بل يمكن القول إن لم يكن ثمة من يديره على الإطلاق . ومع نهاية الحرب العالمية الأولى باتت الولايات المتحدة أقوى دول العالم على الصعيدين المالي والاقتصادي ، وأضحت حينها كبرى الدول المقرضة ، وارتفعت حصتها من النالتج الصناعي العالمي من 36 في المائة في العام 1914 إلى 42 في المائة في نهاية عقد العشرينيات. كما أنها كانت كبرى الدول المصدرة في العالم أيضا وثانية كبرى الدول المستوردة (بعد بريطانيا) ، وأكبر مصدر لرؤوس الأموال إلى الدول الأخرى.
لقد خدع ودرو ويلسون في مؤتمر قصر فرساي ، الذي فرض سلما جائرا ومتعسفا على ألمانيا التي كانت تطالب بموجبه بدفع تعويضات حربية كبيرة إلى المنتصرين (لكن ليس للولايات المتحدة التي لم تطالب بأي تعويضات). وقد أكدت اتفاقية السلام أن ألماينا ، وقد كانت أعظم قوة في اوروبا بفضل قوتها الكامنة ، ستعاني أوضاعا اقتصادية صعبة في المستقبل المنظور. بينما كانت بريطانيا وفرنسا وايطاليا مثقلة بديون الحرب الهائلة للولايات المتحدة ، وهذه الدول ليست لديها موارد تذكر لسداد ديونها. كما أن الولايات المتحدة لم تكن مهتمة إطلاقا بإعفاء تلك الديون. واستفسر كالفن كوليدج قائلا: "لقد استأجروا المال ، أليس كذلك؟".
وقد حال دون انضمام الولايات المتحدة إلى عصبة الأمم ، وبالتالي تبوئها زعامة النظام الدولي ، ورفض ودرو ويلسون القاطع تقديم تنازلات سياسية كان لابد منها. بل على العكس ، فقد انتهجت الدبلوماسية الأمريكية على نحو ظاهر سياسة خارجية غير عملية تجاه معاهدات من قبيل معاهدة واشنطن البحرية التي حدت من حجم السن الحربية وحمولة السفن الكلية ، واتفاقية كيلوج – برياند التي نصت على عدم شرعية الحرب كأداة تنتهجها السياسة الوطنية (وقعت عليها اليابان وألمانيا).
وبالإضافة إلى ذلك كانت الولايات المتحدة مصممة على تطبيق تعريفات جمركية مرتفعة لحماية المنتجين الأمريكيين وتحقيق ميزان تجاري رابح. وفي غضون ذلك عاد الاحتياطي الفدرالي إلى اعتماد سياسة أسعار الفائدة المنخفضة في وقت نهجت فيه المصارف المركزي الاوروبية تطبيق أسعار فائدة مرتفعة للحفاظ على أسعار عملاتها. وكانت النتيجة دورة مالية تفاعلت خلف الكواليس آنذاك. فقد قدمت مصارف الاستثمار الأمريكية – بإفراط – قروضا إلى اوروبا. واشترت منها سندات عادت عليها بأرباح كبيرة . ووظفت أوروبوا حصيلة القروض لتمويل وارداتها من الولايات المتحدة. أما ألمانيا فاستخدمتها في دفع التعويضات إلى الحلفاء. أما الحلفاء فوجهوا الأموال الخاصة بالتعويضات لإعادة سداد قروض الحرب المستحقة للولايات المتحدة.
وهكذا عاد رأس المال الأمريكي المصدر سريعا إلى الولايات المتحدة ، ووفر قاعدة لتقديم مزيد من القروض إلى اوروبا. ولما كانت الدورة المالية مستمرة كان كل شيء على ما يرام. لكنها لم تستمر بالطبع ، وكانت النتيجة كارثة اقتصادية عصفت بالعالم كله.
في العام 1928 بدأ صيارفة الاستثمار الأمريكيون التحول إلى سوق أكثر ربحا من سوق القروض الاوروبية ، ألا وهي سوق "القروض تحت الطلب Call Money" في وول ستريت. ويعبر إصطلاح "القروض تحت الطلب" عن الأموال التي تذهب لتمويل مشتريات الأسهم بالهامش (التويل الجزئي). إذ كان للمضارب آنذاك أن يشتري أسهما لقاء 10 في المائة من قيمتها (أي بهامش أو جزء من قيمتها) ويقترض المبلغ الباقي من السمسار. ومادام سعر السهم – الذي كان يستخدم ضمانة على العرض – ينحو إلى الإرتفاع فقد كان كل شيء على ما يرام ، وكان المضارب قادرا على زيادة رأسماله بصورة سريعة. أما عندما يتراجع سعر السهم ، فقد كان عليه أن يؤمن مزيدا من المال وإلا بيعت أسهمه وخسر كل شئ.
كانت سوق "القروض تحت الطلب" رابحة جدا في أواخر عشرينيات القرن العشرين في وقت استهلت فيه وول ستريت واحدة من فترات رواجها الدورية ، كما حدث في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وخمسينياته وسبعينياته. وحالما تعافت من كساد 1920 – 1921 قصير الأجل أظهرت وول ستريت – كما هي حالها دائما – واقع الاقتصاد الأمريكي المتنامي ، وبلغت مستويات كانت تعد مستحيلة قبل سنوات قليلة خلت. لكن وول ستريت في حقيقة الأمر حققت نموا أسرع كثيرا من النمو الذي كان يشهده الاقتصاد الأمريكي ، قياسا على الأقل بمؤشر داو جونز الصناعي. إذ بينما ارتفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 59 في المائة في عقد العشرينيات ، فإن مؤشر داو جونز حقق زيادة بنسبة 400 في المائة.
وفي العام 1928 تدخل الاحتياطي الفدرالي لكبح حركة الاقتصاد ، وكذلك – كما كان يأمل – الطفرة الناشئة في وول ستريت ، التي بدأت تنكشف علامات انفلاتها من عقالها.وفي خريف العام 1928 كان الاحتياطي الفدرالي في نيويورك – تحت رئاسة بنجامين سترونج – قد رفع سعر الخصم من 3.5 في المائة إلى 5 في المائة. وبدأت في تشديد قبضته على عرض النقد في الاقتصاد. وفعلت مصارف الاحتياطي الفدرالي الأحد عشر الأخرى الشي نفسه. وفسر سترونج المشكلة بأ،ها "هي الآن تعديل سياساتنا بما يحول دون انهيار كارثي في سوق الأسهم . وفي الوقت نفسه مساعدة اوروبا على النهوض ثانية ما أمكن ذلك".
كان بنجامين سترونج – وهو الرئيس الأسبق لاتحاد الصيارفة – قد تبوأ منصب محافظ مصرف الاحتياطي الفدرالي في نيويورك منذ تأسيسه في العام 1914 ، وكان رأس النظام من دون منازع. وعملت المصارف اللآخرى ومجلس الإحتياطي في واشنطن بكل اقتراحاته على الدوام. لكن سترونج كان يعاني السل وتوفي في خريف العام 1828 بعد عملية جراحية في رئتيه. وصار الاحتياطي الفدرالي آنذاك من دون رأس يوجهه.
وفي ربيع العام 1929 طرأ تباطؤ ملحوظ على الاقتصاد تجاوبا مع سياسة مصرف الاحتياطي الفدرالي. أما وول ستريت فلم تشهد أي تراجع في الأداء. ومع أنه يعد على العموم مؤشرا سباقا لحركة الاقتصاد – فيسبق الاقتصاد بالهبوط والارتفاع – فإن السوق – مقياسا بمؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر نيويورك تايمز – واصل الارتفاع بينما كان الاقتصاد يسير في طريق الكساد. لكن السوق الأكثر استقطابا للمتابعين – المكونة من آلاف الأسهم الثانوية وغير المدرجة في مؤشرات الأسهم – بدأت تتراجع مع انخفضا أداء الاقتصاد.
وهذه هي القوة الاقتصادية للحالة النفسية (السيكولوجية) للمتداولين والتي لم تلحظها السوق ولا جمهور العامة ، حيث كان جل الاهتمام منصبا على الأسهم المتداولة في البورصات الكبرى. ووقعت السوق تحت رحمة الفورة (فقاة السوق) التي لا يدركها العامة إلى بعد وقوعها.
وظلت القروض تحت الطلب في طور ازدياد مع تصاعد حالة الهياج في وول ستريت ، ومع ذلك فإن المضاربين يشتهرون بلا مبالاتهم بتكلفة الإقتراض في سوق تصاعدية. وحثت المصارف والمؤسسات المالية جهودها لإقراض المال لبيوت السماسرة بمعدل فائدة 12 في المائة ، وأقرضه السماسرة بدورهم إلى عملائهم بمعدل 20 في المائة. وقد كان لشركة بيتلهيم للفولاذ 150 مليون دولار في سوق القروض تحت الطلب في نهاية صيف العام 1929. وكان لشركة كريسلر 60 مليون دولار.
وبدأت المصارف تقترض المال من الاحتياطي الفدرالي عبر ما يعرف بنافذة الخصم بمعدل 5 في المائة وتعيد إقراضة إلى السماسرة. كان باستطاعة الاحتياطي الفدرالي وقف ذلك لحظة يشاء ، ولابد أن بنجامين سترونج كان سيلجأ إلى ذلك حتما. لكن المصرف – وكان من دون رأس يوجهه – لجأ فقط إلى ما يعرف "بالترغيب المعنوي" لحث المصارف التجارية على وقف تلك الممارسات . ولم يجد ذلك نفعا. ذلك أن أي مصرف توافرت لديه سبل الإقراض بمعدل 5 في المائة والإقراض بمعدل 12 في المائة – محققا عائدا قدره 7 في المائة على أموال ليست له – لن يتواني على فعل ذلك.
وفي صيف العام 1929 كانت وول ستريت ومعها ملايين المتعاملين قد فقدت الاتصال بالاقتصاد "الذي يعتبر الأرضية التي تقوم عليها تداولاتها في الأساس – وخيالات الثروة تتراقص في رؤوسهم. واكتظت غرف اجتماع السماسرة بأشخاص راحوا يراقبون الأسعار ، وحتى أولئك الذيبن عرفوا بالرزانة وسعة الأفق وقعوا في شرك هذا السعار. وقد رأى ايرفنج فيشر – وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل وكان ذائع الصيت في طول البلاد وعرضها ، وقد حقق ثروة من الإستعمار في شركة رولوديكس – إن أسعار الأسهم بلغت وفق المعطيات مستوى مرتفعا لا عودة عنه . ونشرت صحيفة "ساتردي إيفيننج" قصيدة ذلك الصيف راقت لمزاج الناس في عموم البلاد:
آه .. اسكتي يا حلوتي .. لقد اشترت مزيدا من الأسهم جدتي ..
وقد مضى أبي .. لملاعبة الثيران والدبب ..
وأمي دون نصيحة لا تشتري .. فأنى لك يا أمي أن تخسري ..
ولابد للطفل أن .. يحظى بحذاء غالي الثمن..
وفي 3 سبتمبر – بعد عيد العمال بيوم واحد – أقفلت بورصة نيويورك وكان مؤشر داو جونز قد بلغ 381.17 نقطة ، وهذا أعلى مستوى يصل إليه. وفي 5 سبتمبر كان أحد محللي السوق المغمورين (روجر بابسون) يخطب في نفر من الأشخاص على مائدة الغداء في إيليزي بماساتشوستس. لقد تجاهلت السوق – التي كانت لا تهتم إلا بالتوقعات المتفائلة – كل التوقعات التشاؤمية التي أطلقها هذا التشاؤمي العنيد. ولم يكن في مقدوره أن يخرج بشئ جديد ذلك اليوم ، باستثناء ما دأب على ترديده: "أكرر ما قلته في مثل هذا الوقت من العام الماضي والعام الذي سبقه ، أن انهيار السوق واقع عاجلا أو آجلا".
كان ذلك اليوم يوما رتيبا ووضعت خدمة داو جونز للأخبار المالية ملاحظة بابسون البدهية على الشريط الإخباري في السعة الثانية ظهرا. وكان الأثر عظيما. ففي آخر الساعات التداول هبطت الأسعار (تراجعت شركة فولاذ أمريكا 9 نقاط وشكري إي تي آند تي 6 نقاط) ، وبلغ حجم التداول في آخر ساعة مستوى مرتفعا: مليوني سهم . كان "فاصل بابسون" صفعة على وجه رجل مسعور ، وتغير مزاج وول ستريت فجأة من أقصى حدود التفاؤل (لا حدود لتفاؤلنا) إلى أقصى حدود التشاؤم (كل شخص مسئول عن نفسه).
وفي الأسابيع الستة التالية سلكت السوق مسارا هبوطيا ، حيث كانت الانخفاضات العرضية تتبع بفترات ارتداد أكثر اعتدالا . ومن ثم في 23 اكتوبر اكتسحت السوق موجة بيع عندما بلغ حجم التداول ثاني أعلى مستوى له ، وألغيت أعداد هائلة من طلبات التغطية وتراكمن أوامر البيع بالآلاف لدى بيوت السمسرة في جميع أنحاء البلاد. وكان اليوم التالي ، الثلاثاء 24 اكتوبر – وبات يعرف بالخميس الأسود – الأكثر سعارا في تاريخ بورصة نيويورك حتى ذلك الحين ، وذلك عندما هبطت أسعار الأسهم وسببت مزيدا من طلبات التغطية فبيع مزيد من الأسهم بما تيسر من الأسعار ، وتراجعت المؤشرات بصورة حادة. وفي هذه الأثناء ، أضاف الباعة على المكشوف (البيع القصير) إلى الضغوط الهبوطية على الأسهم في محاولاتهم اقتناص فرص تراجع الأسعار.
والتقت مجموعة من كبار مصرفيي وول ستريت في مكاتب شركة جي بي مورجان وشركاه ، في الجانب المقابل للبورصة من شارع بورد ستريت للوقوف على ما يمكن عمله. وقد جمعوا مبلغ 20 مليون دولار لإعادة الاستقرار إلى السوق ، وعهدوا به إلى ريتشارد ويتني الرئيس القائم بأعمال البورصة. وفي الساعة 1.30 مضى ويتني إلى المنصة حيث كانت أسهم شركة فولاذ أمريكا تتداول وسأل عن السعر ، وبلغه أن آخر عمليات التداول إنما جرت عند سعر 205 دولارات ، لكن السعر تراجع عدة نقاط بعدها ولم يقبل أحد على الشراء. فقال ويتني بانفعال: "اشتر أسهم فولاذ أمريكا ب10 آلاف دولار عند سعر 205 دولارات ". ثم قصد إلى المنصات الآخرى ليشتري أسهم الشركات الممتازة بكميات كبيرة.
وكان أثر ذلك هو كل ما طمح إليه المصرفيون. وبدأ البائعون على المكشوف يبحثون عن تغطية لمراكزهم الاستثمارية واستقرت السوق .وفي نهاية اليوم أغلقت أسهم فولاذ أمريكا بارتفاع طفيف. لكن حجم التداول وصف إلى مستوى غير مسبوق: 13 مليون سهم.
واستمرت موجة الارتفاع يوم الجمعة ، وبلغ جني الأرباح في جلسة تداول صباح السبت مستوى مقبولا . واستؤنف البيع يوم الاثنين بعد أن ذاعت إشاعات في وول ستريت حول إقدام كبار المضاربين على الانتحار ، وبدأت تتشكل جماعات جديدة من المضاربين على الهبوط. وفي اليوم التالي – الثلاثاء 29 اكتوبر ، وهو الثلاثاء الأسود – لم تتوقف حركة التداول في السوق ، لكنها تراجعت منذ لحظة بدء التداول وظلت في طور انخفاض طول اليوم من دون توقف. وبلغ حجم التداول 16 مليون سهم ، وهو رقم قياسي سيبقى أكبر رقم يصل إليه التداول في السنوات الأربعين التالية. واستمر الشريط الاخباري يدور يتجاوز أربع ساعات ، ولم يعرض آخر سعر إلا نحو الساعة الثامنة من تلك الليلة. وقدر أحدهم أن الشرائط الاخبارية في بورصات البلاد قد استهلكت ذلك اليوم خمسة عشر ألف ميل من الورق. وبلغ متوسط داو جونز في نهاية ذلك اليوم العصيب مستوى أقل بنسبة 23 في المائة من مستوى إقفال يوم السبت و40 في المائة تقريبا دون مستواه في مطلع سبتمبر. ولم يكن أحد يعلم بالطبع أن أعظم الكوارث في تاريخ الأمة قد بدأت.
الكساد الكبير: 1929–1941
 مقالة مفصلة: الكساد الكبير
مقالة مفصلة: الكساد الكبير

لا يجد المؤرخون بدا من تأريخ الأحداث بالإفادة من معيانتها بعد حدوثها وإضفاء لمستهم الخاصة على الأحداث التي يروونها. لذلك ، يبدو التاريخ دائما للقارئ أكثر انتظاما وإثارة من الأحداث التي يرويها أولئك الذين عايشوها يوما بيوم . إن قدر الإنسان أن يعيش مع مستقبل مجهول يلفه دائما ضباب الكينونة المحضة الذي قد يصعب على العين النفاذ عبره كأنه عجاج الحرب. لذلك ، فإن الانحدار الاقتصادي ، الذي استمر طوال فترة النسوات الثلاث ونصف السنة التي سبقت الازدهار الكبير في أواخر صيف العام 1929 الذي انتهى في هاوية الكساد في مطلع شتاء العام 1933 ، يبدو انحدارا تدريجيا سلسا ، وربما اعتبره البعض اليوم أمرا محتوما آنذاك ، ولا يحمل إلا قلة من الناس ذاكرة شخضية مميزة عن تلك الفترة.
وبالنتيجة يرى كثيرون في قصة الكساد الكبير ما يشبه قصة سفينة التايتانيك ، إذ كان انهيار السوق هو جبل الجليد ، كما أن تغيير القبطان في اللحظة الأخيرة أفضى إلى نهايتين مختلفتين. وفي الواقع ، كان انهيار السوق أثرا لقوى كانت تسوق الاقتصاد الأمريكي واقتصادات العالم نحو الكساد ، وليس سببا لها. لقد بذل هربر هوفر كل ما في وسعه – وأكثر مما فعله أي رئيس سابق – في ظل سوء الأحوال الاقتصادية ليعكس الاتجاه الذي سلكه الاقتصاد في تلك السنوات ، ولإصلاح الأضرار التي خلفتها. إذ لم يكن أي رئيس مستعدا للتحرك للوصول إلى حلول جديدة لم تكن واردة في العرف السياسية سابقا إلا بعد أن يدمر الكساد القيود الاقتصادية والتاريخية التي كبلته.
لقد حققت سوق الأسهم ارتفاعات حادة يوم الأربعاء 30 اكتوبر ، وأعلنت البورصة أن السوق ستفتح أبوابها ظهيرة اليوم التالي ثم ستظل مغلقة حتى يوم الإثنين لتوفير الوقت اللازم للسماسرة لمعالجة أكوام الأعمال الورقية التي تراكمت عندما عصفت حال الهلع السوق. وأصبات السوق ارتفاعا في جلسة الخميس المختصرة. واعتقد كثيرون أن الأسوأ قد انقضى ، وكانوا مخطئين في ذلك ، فقد هبطت السوق بشكل حاجة يوم الاثنين 5 نوفمبر وتواصل الهبوط اسبوعين آخرين ، وخسر مؤشر "نيويورك تايمز" كل مكاسبه التي حققها منذ صيف العام 1927.
وبعض النظر عن ذلك ، فإن كل الأسواق – سواء أسواق الهبوط أو أسواق الصعود – تفقد في آخر المطاف زخمها ، ذلك أن الأسهم كانت تنحو صعودا في ديسمبر على الرغم من أن حجم التداولي تراجع كثيرا. ومع نهاية العام ، وبينما نكص كثير من الأسهم التي كانت تبلى بلاءا حسنا ، حققت بعض قطاعات السوق – كصناعة الطائرات ومتاجر الأقسام وشركات الفولاذ – أرباحا في ذلك العام. كان ثمة اعتقاد سائد أن إنهيار السوق إنما كان عملا تصحيحيا شديد الوطأة في سوق أنهكتها عمليات الشراء المفرط. وفي يناير العام 1930 رأت صحيفة نيويورك أن أهم أحداث العام 1929 كان رحلة الأميرال بيرد في القطب الجنوبي.
وعلى الرغم من أن سوق الأسهم كانت الشغل الشاغل على المستوى القومي في العام 1929 ، فإن إنهيارها لم يخلف أثرا مباشرا في كثير من العائلات. وقد أوردت البورصة أن عدد مالكي الأسهم في أمريكا في العام 1928 بلغ عشرين مليونا ، مع أنه في الواقع لم يصل إلى عشر هذا الرقم ، ولم يكن أكثر من 2.5 في المائة من السكان يملكون حسابات مع السامسرة. وبينما خسر كثير من أولئك المضاربين والمشترين بالهامش (بالتمويل الجزئي) استثماراتهم ، فإن كثيرا منهم أيضا قاوموا فترة الهلع وكانوا لا يزالون محتفظين بأسهمهم.
ومن الأسباب التي حملت معظم الناس على الاعتقاد أن الأزمة قد مرت بسلام أن النظام المصرفي لم يبد علامات تأزم خارجة على المألوف. وللدلالة على ذلك فإن 659 مصرفا انتهت إلى الإفلاس في العام 1929 ، لكن ذلك المستوى كان دون معدل فشل المصارف السنوي في ذلك العقد ، ولم تحدث أي انهيارات لمصارف كبر بعد انهيار السوق. ويعزى ذلك إلى أن مصرف الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وسماسرتها اتخذوا إجراءات سريعة. فقد أعلن السامسرة أنهم مستمرون في خدمة الحسابات التي تقل أرصدتها عن متطلبات الهامش ، وهكذ تمت الحيلولة دون مزيد من عمليات البيع بسعر السوق السائد التي كانت ستضغط على الأسعار نحو مزيد من الهبوط.
وقد ساعد مصرف الاحتياط الفدرالي في نيويورك بدوره على تخفيض معدل إعادة الخصم إلى 3.5 في المائة في مارس العام 1930 ، مما ساعد أيضا على تخفيض معدلات الفائدة بشكل عام. وبفضل الإقبال الواسع على شراء الأوراق المالية الصادرة عن مصرف الاحتياطي الفدرالي ، فقد طرأ تحسن كبير على موجودات المصرف من النقد السائل ، كان المصرف قد انخرط في شراء ما لا يزيد على 25 مليون دولار من الاوراق المالية في الأسبوع الواحد ، لكنه اضطر إلى شراء ما قيمته 160 مليون دولار بعد انهيار السوق ، وأكثر من هذا في الأسابيع التالية. وقد سار جورج هاريسون – الذي خلف بنجامين سترونج محافظا لمصرف الاحتياطي الفدرالي في نيويورك – على نصيحة سلفه في التصدي لمثل هذه الحال ، حيث كان سترونج قد أشار إلى "أننا قادرون على التعامل مع هذه الحال الطارئة فورا بإغراق وول ستريت بالمال".
ولم يكن لجورج هاريسون ما يشبه نفوذ سترونج في أوساط مصارف الاحتياطي الفدرالي الأخرى ، وتعرض لنقد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن لتجاوزه صلاحياته ، ومن جملة أمور أخرى. ولم يبدر عن الاحتياطي الفدرالي تحرك جماعي حاسم لضخ السيولة في النظام المصرفي الوطني ، وكان هذا خطأ خطيرا.
لقد شهد شتاء العام 1930 ومطلع ربيعه صحوة في سوق الأسهم ، فكسب نحو 45 في المائة مما خسره في الانهيار الذي وقع في الخريف الماضي. ودعا هوفر إلى إجتماع رجال أعمال في نوفمبر 1929 ، وحثهم على الاستثمار في الإنشاءات الجديدة ، فتعهد عدد منهم بذلك.وأبرق إلى حكام الولايات – كانت حكومات الولايات تمول آنذاك 80 في المائة تقريبا من مشاريع الانشاءات الحكومية – طالبا إليهم الشئ نفسه . واقترح في الربيع ، لحفز الاقتصاد أيضا ، أن يزاد الإنفاق الفدرالي على الإنشاءات بمبلغ 140 مليون دولار. ولم يكن ذلك بالمبلغ اليسير في ميزانية فدرالية كانت تقدر بنحو 3.3 مليار دولار ، أو ما يعادل 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي . وذهب 25 في المائة من الميزانية الفدرالية إلى سداد فوائد الدين، ومعظم النسبة الباقية لتمويل جيش تعداده 139 ألف عنصر ولبحرية يعد طاقمها ب95 ألف عنصر. كان ذلك في الواقع يعادل ما ستنفقه الحكومة الفدرالية في تلك السنة المالية بأي حال ، خصوصا أن مشاريع الإنشاء تحتاج إلى وقت طويل للتسليم قبل استئجار العمال بأعداد كبيرة.
وفي ربيع العام 1930 لم تبد ثمة حاجة إلى المزيد. وفي مايو من ذلك العام أبلغ الرئيس هوفر جماعة دينية كانت قد ناشدته أن يطالب بمزيد من الأشغال العامة بقوله: "لقد جئتم متأخرين ستين يوما ، فقد انتهى الكساد". ولسوء الطالع ، ارتكب الرئيس آنذاك خطأ فظيعا يضاف إلى خطأ الاحتياطي الفدرالي من قبل ، فقد وقع قانون تعريفة "سموت-هاولي".
لقد وعد هوفر – عندما كان مرشحا رئاسيا في العام 1928 – المزارعين الكادحين في البلد بأنه سيدعو إلى جلسة خاصة للكونجرس لمعالجة مسألة كساد الزراعة. وهذا ما فعله في صيف العام 1929 ، وكان من بين اقتراحاته زيادة التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية لحماية السوق الأمريكي بما يضمن مصلحة المزارعين الأمريكيين. لكن بعد تباطؤ الاقتصاد في العام 1929 وانهيار السوق ، تخاطفت المصالح الخاصة اقتراح هوفر حينما تقدمت كل صناعة من صناعات البلاد تقريبا – حتى صانعي شاهدات القبور – إلى الكونجرس تطلب حمايتها من المنافسة الأجنبية "غير العادلة". وهكذا ولأن أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ كانوا حريصين جدا على ألا يخيبوا الصناعات المحلية ، فقد فرضوا تلك التعريفات استجابة للالتماسات المرفوعة واحدا إثر آخر ، وكانت النتيجة أعلى مستوى تبلغه التعريفات الجمركية في التاريخ الأمريكي.
لكن هذا كان من قبيل "الغباء الاقتصادي" ، فالتعريفات الجمركية ضرائب وهي تعتبر دائما – ولا مفر – عبئا على الاقتصاد. كما أن الأسوأ من هذا أن التعريفات المرتفعة تولد تعريفات تصعيدية من قبل الدول الاخرى. إذ لا يمكن لأي بلد أني غلق أسواقه أمام البلدان الأخرى ثم يتوقع منها أن تبقي أسواقها مفتوحة أمام بضائعه. إن الاقتصاديين العارفين ليعلمون هذا بالطبع ، وقد وقع ألف منهم عريضة للرئيس هوفر يطالبونه فيها بأن يستخدم حق النقض ضد مشروع التعريفات الجمركية الذي تقدم به الكونجرس . وكتب تومال لامونت ، الرجل الثاني في مصرف مورجان الإبن "لقد هممت بأن أجثو على ركبتي أمام هربرت هوفر لأتوسل إليه أن يستخدم حق النقض (الفيتو) على مشروع قانون التعريفة الجمركي "هاولي-سموت" الأخرق. لقد اذكى هذا القانون نار النزعة القومية في جميع أنحاء العالم".

وقد أثبت منطق الاقتصاديين صوابه تماما ، وبدأت التجارة العالمية الانحدار. لقد طبقت بريطانيا العظمى – وكانت أكبر حماة التجارة الحرة منذ أربيعينات القرن التاس عشر ، وأكثر دول العالم تجارة – "نظام المعاملة التفضيلية الإمبريالي" ، أي بمعنى آخر سورا من التعريفات الجمركية قصدت منه الإبقاء على التجارة البريطانية داخل حدود الإمبراطورية البريطانية. واعتمدت أمم أخرى قيودا مشابهة. وفي العام 1929 بلغ حجم التجارة العالمية الإجمالي 36 مليار دولار ، أما في العام 1932 فإنه لم يتعد ال12 مليارا ، ووصلت قيمة الصادرات الأمريكية في العام 1929 إلى 5.241 مليار دولار. أما بعد ثلاث سنوات فقط فإنها لم تتجاوز 1.161 مليار دولار. أي ما يعادل تراجعت بنسبة 78 في المائة ، وهذا يقل عن صادرات العام 1896 إذا أخذنا التضخم بعين الإعتبار.
وفور التوقيع على تعريفة "سموت-هاولي" وإصدارها بقانون ، بدأت سوق الأسهم تخسر مكاسبها التي حققتها في الربيع . وفي الخريف بدأت المصارف تعلن إفلاسها بأعداد مطردة. وتجاوز عدد حالات الإفلاس في العام 1930 تلك التي أعلنت في العام 1929 ، لكن الزيادة لم تكن تدعو إلى القلق. ومع ذلك – وفي آخر شهرين من العام – أفلس 600 مصرف دفعة واحدة ، فإرتفع عدد المصارف المفلسة في عام واحد إلى 1352 ، أي ما يزيد على ضعف الرقم المسجل في العام 1929 ، والأسوأ من ذلك أن أكثرها كان من المصارف الصغيرة التي لا أفرع لها، والتي انتشرت في المناطق الريفية وقدمت خدماتها للضواحي الريفية الفقيرة حيث سكن المهاجرون.
أما مصرف الولايات المتحدة فكان شيئا آخر ، إذ كان متعدد الفروع ، وقد اتخذ من عاصمة البلاد المالية – نيويورك – مقرا له. كانت لدى المصارف إيداعات بقيمة 268 مليون دولار يملكها 450 ألف مودع ، أكثرهم من صغار التجار وأبناء الطبقة العاملة اليوهد الذين اشتغلوا في صناعة الملابس واسعة الانتشار في المدينة. وعندما بدأ وضع المصرف يتأزم ، حاولت كل من السلطات المصرفية في ولاية نيويورك ومصرف الاحتياطي الفدرالي جاهدين إنقاذه. وسعوا إلى دمحه مع ثلاثة مصارف أخرى ، لكنهم كانوا في حاجة إلى قرض بقيمة 30 مليون دولار من أكبر بيوت الصرافة في وول ستريت لإنجاح الصفقة. ورفضت وول ستريت مد يد المساعدة. وكتب جوزيف إي برودريك رئيس الرقابة الصمرفية في ولاية نيويورك "أحذرهم! إنهم يركتبون أفدح الأخطاء في تاريخ مصارف نيويورك".
وأغلق مصرف الولايات المتحدة أبوابه في 11 ديسمبر العام 1930 ، وكان هذا اكبر حادث إفلاس مصرفي في تاريخ البلاد حتى ذلك الزمن. وأحدث إنهيار المصرف موجة من الهلع عمت الكيان السياسي الأمريكي وانتقلت إلى اوروبا ، حيث كان ثمة اعقتاد أن المصرف – كما يوحي إسمه – على علاقة رسمية بالحكومة الفدرالية . وإذا كان ممكنا لمصرف بهذا الحكم أن يفضشل ، فأي مصرف سينأى بنفسه عن الإفلاس؟
كما لم يكن ثمة مبرر أو حاجة لوجود هذا المصرف من الأساس. إذ لم تكن شؤون المصرف تصرف على ما يرام (حيث سينتهى الأمر بإثنين من مديريه إلى السجن) ، كما أن ثمة دائما اتهامات بمعادات السامية أثيرت على خلفية رفض مصارف وول ستريت المحافظة تقديم يد المساعدة. أيا يكن ، وإذا كانت تعريفة سموت-هاولي أكبر صنائع الكونجرس التي سببت كسادا كبيرا. فإن رفض وول ستريت مساعدة مصرف الولايات المتحدة كان هو الدور الذي أدته المؤسسة المالية الأمريكية في إحداث الكساد.
ومع ذلك فإن البلد – مع نهاية العام 1930 وفي وقت كان يعاني فيه ويمر بظروف عصيبة – كان لا يزال تحت وطأة كساد "معتدل" ، وليس بأسوأ من الكساد الذي عرفه في العام 192 و1921 ، إذ وصلت آنذاك نسبة البطالة إلى 11.9 في المائة . وفي العام 1930 لم تتجاوز البطالة 9 في المائة. لقد كان العام 1931 هو عام تحول الكساد إلى "الكساد الكبير".
ومرة أخرى ، كما في العام 1930 ، في الأشهر الأولى من العام الجديد ، بدأت البوادر تشير إلى أن الإزدهار – وبلغة تلك الأيام (التي كانت تحمل سخرية متزايدة في طياتها) – "بات وشيكا" بعد أن بلغ الاقتصاد نقطة الحضيض.
وفي هذه الأثناء تدخلت الأحداث التي وقعت في اوروبا . ففي 11 مايو العام 1931 ، أفلس مصرف كريديت أنسالت وهو أكبر مصارف النمسا ومن أكثر المصارف انتشارا في اوروبا. وكان انيهار المصرف أشد وطأة من انهيار مصرف الولايات المتحدة ، وتبعه عدد من المصارف في النمسا وألمانيا فصارت في طي النسيان. وبدأ الاقتصاد الألماني – وكان في الأساس يعاني وطأة ضائقة اقتصادية شديدة نتيجة تعويضات الحرب – الانهيار من الداخل.
واقترح هربرت هوفر – بعد مناشدة توماس لامونت من مصرف مورجان ، أن تعلق أقساط القروض المستحقة للولايات المتحدة على الحلفاء وتعويضات المانيا للحلفاء لمدة عام واحد. كان هذا عملا شجاعا جدا أقدمت عليه القيادة السياسية. وقد أدرك مصرفيو وول ستريت المحنكون من أمثال توماس لا مونت حجم الكارثة المحدقة. وقد اعتبر رجل الشارع الأمريكي أن تعليق أقساط قروض الحلفاء ، لم يكن سوى تحميل دافعي الضرائب الأمريكيين المزيد من تكلفة الحرب الاوروبية ، وحماية لمصالح مصرفيي وول ستريت. ومع تعاقب أيم وسنوات العشرينيات والثلاثينيات بدأ الأمريكييون يرون في قرار ودرو ويسلون بإنهاء عزلة أمريكا عن اوروبا قرارا غير صائب. ولم يكن لدى الأمريكيين أي رغبة في الالتفات إلى شئون اوروبا ومشكلاتها.
وأخر الرفض الفرنسي فبول خطة هوفر ، ولم تستأنف أقساط القروض المستحقة لأمريكا ولا التعويضات الألمانية. وفي 13 يوليو العام 1931 علق مصرف دانات أكبر مصارف ألمانيا عملياته ، ولم يكن أمام الحكومة الألمانية سوى إغلاق بورصة برلين ومصارف المدينة. كان النظام المالي الاوروبي على شفير الهاوية. وامتدت الازمة سريعا فوصلت لندن قلب النظام المالي وأصابت الجنيه الاسترليني أهم عملات العالم بعد الدولار. ومع العجز الكبير الذي أصاب الميزانية بسبب الكساد وقع الجنيه الاسترليني تحت ضغوط متزايدة حينما اندفع التجار إلى التخلص من الجنيه وشراء الذهب الذي بدأ يرشح من مصرف انجلترا بمعدلات خطيرة.
وفي 21 سبتمبر ، وعلى الرغم من حصولها على قروض بقيمة 25 مليون جنيه من الاحتياطي الفدرالي في نيويورك ومصرف فرنسا ، فقد تخلت بريطانيا عن معيار الذهب ، وكانت قد أسسته هي نفسها في العام 1821 ، وانقضى عهد بريطانيا كقوة مالية عظمى. ولأن قدرا كبيرا جدا من التجارة العالمية كان مقوما بالجنية الاسترليني ، ولأن كثيرا من العملات داخل الامبراطورية البريطانية وخارجها كان مربوطا بالجنيه الاسترليني ، فإن عواقب ذلك كانت واسعة النطاق ، ولم يكن أمام كثير من المصارف المركزية من خيار سوى التخلي عن معيار الذهب أيضا.
أما في الولايات المتحدة فقد تحرك مصرف الاحتياطي الفدرالي بقوة لحماية الدولار والحفاظ على معيار الذهب مع انصراف المصارف المركزية الأجنبية والمستثمرين الاجانب إلى إعادة توطين الذهب. وكان ذلك قرارا كارثيا بكل معنى الكلمة ، وربما افدح الاخطاء التي ارتكبت في تلك السنوات. وقد استدعى الحفاظ على معيار الذهب رفع أسعار الفائدة وتقليص عرض النقد ، مما زاد من شدة التضخم الذي بلغ مستويات حادة. واستدعت المصارف قروضها للحفاظ على مستوى من السيولة ، بينما توقف العملاء عن الشراء توقعا لانخفاض الأسعار. وفي السنة والأشهر الستة التالية سيحبس ما يزيد على مليون قرض رهني . أما البطالة فقد تفاقهمت أيضاز واندفع مودوعو المصارف – وقد كانون يعلمون تماما بسلسلة إفلاسات المصارف التي شهدتها البلاد قبل عام – إلى سحب أموالهم من المصارف حفاظا على مصالحهم. وفي أول شهر أعقب تخلي بريطانيا عن معيار الذهب أفلس 522 مصرفا أمريكيا.
ومع نهاية العام 1931 واجهت الولايات المتحدة ظروفا اقتصادية لم تعرفها قبلا على الإطلاق . فقد وصل عدد المصارف المفلسة إلى 2293 في ذلك العام. وكانت كل حادثة إفلاس تعني مأساة ألمت بمئات أو آلاف العائلات التي رأت سندها الوحيد في مواجهة اثر البطالة يتلاشي أمام عيونها. ودبت البطالة بصورة هائلة في أركان الاقتصاد الأمريكي . وهبط الناتج القومي الإجمالي بمعدل 20 في المائة أيضا ، وتراجع إنتاج السيارات من 4.5 مليون في العام 1929 إلى 1.9 مليون في العام 1931 ، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمال ليس فقط من شركات السيارات ولكن من شركات المطاط والزجاج والفولاذ ووكالات السيارات وشركات التأمين أيضا.
وارتفعت البطالة في أواخر العام 1931 إلى 15.9 في المائة. وبدأت شوارع البلاد تكتظ برجال مهلهلي الثياب يبحثون عن عمل ، أي عمل. ولم يكن مستغربا في المناطق الريفية أني قرع أبواب البيوت أشخاص يبحثون عن عمل لقاء وجبة طعام أو قضاء ليلة في الحظيرة. واصطفت في لندن طوابير الخبز على امتداد مجمعات الابنية ، وانتشتر الكتل المتداعية من الأكواخ ومنحدرات السطوح – وكانت تكنى بهوفرفيلز – في المرائب والخلاء ، حيث فزع إليها أولئك الذين فقدوا منازلهم وشققهم السكنية . لقد بدأ النظام الاقتصادي كله يتداعى وينهار. وفسدت المحاصيل الكاسدة (غير المبيعة) في أنحاء البلاد ، وكان البعض في المدن يقصد حاويات القمامة بحثا عما يأكله في بلد كان يعتبر أغنى بلدان العالم.
ومع هبوط متحصلات الضرائب بنحو 900 مليون دولار ، في وقت ارتفعت فيه النفقات الفدرالية بمقدار 200 ملوين دولار ، تردت الميزانية الفدرالية في مهاوي العجز بمقدار نصف مليار دولار في السنة المالية 1931 ومع أن هذا المبلغ ليس كبيرا بأرقام اليوم ، لكنه كان عجزا بمقدار 13 في المائة من حجم الايرادات ، وهو أسوأ عجز زمن الحرب منذ الأيام العصيبة التي شهدها مطلع تسعينيات القرن التاسع عشر.
في ذلك الحين كن ضبط الميازنية على راس اولويات الحكومة الفدرالية وكان من المسلمات التي لا تحتمل نقاشا. ولن يخرج بتفسير كامل لفكرة أن على الحكومات أن تنفق – وإن كانت تعاني عجزا في ميزانيتها – في زمن الأزمة الاقتصادية ، إلا بعد أن ينشر جون مينارد كنيز عمله الطليعي seminal work "النظرية العامة في التوظيف والفائدة والنقوط" في العام 1936.
وفي وقت لم تكن فيه الأسس الفكرية لنظرية كينز معروفة بعد ، لكن فكرة توظيف الإنفاق بالعجز في تحفيز الاقتصاد كانت مطروحة. إذ تبناها هوفر – الذي ربما كان أكثر من تولى منصب الرئاسة إلماما بعلم الاقتصاد – في الاجتماع الوزاري الذي انقعد في مايو 1931 ، وكتب هنري ستيمسون – وزير الخارجية – في مذكراته الشخصية عن أحد الاجتماعات الوزارية قائلا: "لقد شبه الرئيس الحال بزمن الحرب". وقال إنه" لم يخطر ببال أحد تحقيق توازن الموازنة في زمن الحرب. ولحس الطالع فإن في مقدورنا الاقتراض".
ولسوء الطالع فقد عدل هوفر عن رأيه في أواخر العام 1931 وطلب إلى الكونجرس إحداث زيادة ضريبية كبيرة في سبيل تحقيق توازن الميزانية. واكتسب الكونجرس أغلبية ديموقراطية في انتخابات العام 1930. وقد توزع أعضاء الكونجرس بين 267 جمهوريا و167 ديموقراطيا في أول ولاية لهوفر ، لكن نسبة الأعضاء في ولايته الثانية تغيرت إلى 220 ديموقراطيا و214 جمهوريا. وتوزع مجلس الشيوخ بعد العام 1930 بالتساوي تقريبا: 48 جمهوريا و47 ديموقراطيا. لكن كلا المجلسين أقر مشروع الضريبة الذي تقدم به هوفر من دون معارضة تذكر. لقد كان أكثر الأعضاء الديموقراطيين ينحدر من مناطق الجنوب والغرب. وكان تحقيق وزانة متوازنة بالنسبة إليهم شيئا من قبيل الإرادة الإلهية. ولقد سعى المتحدث باسم المجلس جون نانس جارنز من تكساس إلى إضافة ضريبة مبيعات عامة (وطنية) أيضا إلى جانب ازيادات على ضريبة الدخل التي اقترحها هوفر ، وكانت ضريبة المبيعات سيقع أغلبها على الفقراء.
واقترح هوفر ايضا فكرة أفضل كثيرا من الزيادة الضريبية ، على الرغم من تصاعد وقع الكساد ، تمثلت هذه الفكرة في قانون مصارف الإسكان الذي يقضي بإنشاء عدد من مصارف الإسكان المفوضة بتقديم القروض بضمانة محافظة الرهون العقارية لدى المصارف التجارية. لقد حظر قانون الاحتياطي الفدرالي الصادر في العام 1913 على مصرف الاحتياطي الفدرالي تقديم القروض من خلال نافذة الخصم على مثل هذه الضمانات. وكان أثر هذا المنع تجميد مئات الملايين من الدولارات في أصول مصرفية كان يمكن استخدامها في ضخ السيولة إلى النظام الصمرفي. ومع ذلك فقد تباطأ الكونجرس في إصدار التشريع حتى يوليو 1932 ، وزاد من متطلبات الضمان التي طلبها هوفر ، وكان طيف توماس جيفرسون لا يزال ماثلا أمامه.
وقد اقترح هوفر – الذي عارض طويلا تقديم الإعانة الفدرالية إلى الصمارف والشركات الصناعية أو الأفراد – حلا جذريا جديدا للتصدي للمشكلة إلا وهو مؤسسة تمويل وإعادة الإعمار. لقد نظرت كل الأطياف السياسية في أمريكا إلى الإعانة على أنها حالة شاذة مستوردة من اوروبا. لتضع المواطنين تحت وصاية الدولة. لكن هوفر كان يتمتع بالمرونة الفكرية اللازمة لإدراك أن الظروف الاستثنائية تحتاج إلى إجراءات استثنائية. لكن مؤسسة تمويل إعادة الإعمار وقد حدد رأسمالها ب500 مليون دولار بقرار من الكونجرس ، وكانت مخولة إصدار ما لا يزيد عن ملياري دولار من السندات المعفاة من الضريبة – لم تقدم إعانات مباشرة إلى الأفراد. بل كانت في الواقع تقعد قروض طوارئ إلى المصارف وشركات التأمين على الحياة واتحادات الرهون الزراعية وسكك الحديد التي كانت ستنتهي إلى الإنهيار لولا هذه المعونات . وأقر هوفر المشروع في قانون صدر في 2 فبراير العام 1932.
ولأن هذه الإعانة أفضت من دون شك إلى إنقاذ حملة أسهم الشركات التي حصلت عليها ، فإن كثيرين من أمثال فيوريلو إتش لا جارديا أطلق عليها اسم "إعانة المليونير" ، لكنها أدت إيضا إلى إنقاذ موظفي تلك الشركات وجمهور المودعين ، وحلما زال ما يعيق تقديم المعونة الفدرالية إلى الشركات ، هل كان من اللائق إغفال المعونة الفدرالية المباشرة للأفراد؟ في الواقع إنها لم تغفل ، لكنها حجبت بورقة تين . ففي يوليو ، أجاز قانون الأشغال الإعانة وإعادة الإعمار لمؤسسة تمويل إعادة الإعمال بتمويل الأشغال العاةم بمبلغ أقصاه 1.5 مليار دولار لتوفير فرص العمل. وبتقديم ما لا يزيد على 300 مليون دولار للولايات – وكثير منها كان معارضا للقيود التي فرضها الدستور على الإنفاق والإقتراض – بحيث يتسنى للولايات تقديم العون المباشر.
وفي غضون ستة أشهر ، أقرضت مؤسسة تمويل إعادة الإعمار 1.5 مليار دولار ، أي ما يعادل النفقات الفدرالية الإجمالية ذلك العام. وسيتبين أن هذه المؤسسة ستكون مثالات يحتذى به في كثير من مراحل البرنامج الجديد New Deal. لكن الفضل في هذه الفكرة لن ينسب إلى هوفر ، بل إن أوائل مؤرخي ذلك الزمن لن يروا غضاضة في الإفادة من إسمه في إعلاء شأن خليفته . لقد اشتهر جون إفن كينيدي ذات مرة بمقولته: "الحياة غير عادلة" . وسيكون كيندي أول من يقر بأن التاريخ يخلو من العدالة والإنصاف.
كان الاوان قد فات آنذاك لتغيير مصير هربرت هوفر السياسي ، إن لم يكن مصيره التاريخي أيضا . ففي أواخر مايو تظاهر نحو ألف رجل شاركوا في الحرب العالمية الأولى في واشنطن للمطالبة بالحصول آنذاك على منحة لهم تستحق في العام 1945 ، وصدر عن الكونجرس مشروع قانون بطبع 2.4 مليار دولار من النقد القانوني (من دون تغطية ذهبية) لسداد تلك المنحة ، لكن مجلس الشيوخ رفض المشروع. وفي غضون ذلك زاد عديد "قوة المطالبة بالمنحة" (حملة المنحة) ليبلغ سبعة عشر ألفا في منتصف يونيو ، أكثرها كان في مخيمات أناكوسشيافلاتس Anacostia Flats في ضواحي ولاية العاصمة. وأقام البعض أكواخا في أراضي الحكومة قرب الكابيتول واحتلوا عددا من المباني الحكومية في شارع بنسلفانيا.
وأجاز الكونجرس أن يدفع للمحاربين القدماء المال اللازم لإعادتهم إلى مناطقهم ، واندلعت أعمال العنف عندما حاولت شرطة العاصمة طردهم بالقوة. وقتل في الحادث اثنان من المحاربين القدماء وشرطيان . واستدعي هوفر الجيش بقيادة رئيس الأركان دوجلاس ماك آرثر لإجلائهم عن أراضي الحكومة وحصر تجمعهم في أناكوسشيا فلاتس.
وفي 28 يوليو قاد ماك آرثر نفسه – كديك مختال – فرقة من الخيالة والمدفعية بكامل عتادها واستعدادها تتبعها ست دبابات لإخلاء المباني الحكومية . لكنه حينها – وفي انتهاك واضح لأوامر الرئيس – أجلى أيضا المساكن وأحرق الأكواخ التي نصبت هناك ، مبددا بقايا "جيش المنحة" Bonus army. كان على هوفر أن يقيل ماك آرثر على الفور للمخالفة الصارخة للأوامر . لكن آثر بدلا من ذلك أن يتحمل كام المسئولية ، وتكبد ثمنا سياسيا باهظا من جراء ذلك بعد أن هزت الأمريكيين صور الخيالة على صهوات الجواد وقد مشقت سيوفها في إثر العاطلين عن العمل في شوارع العاصمة.
وراحت افتتاحيات الصحف ورسومها الكاريكاتورية تصور الرئيس آنذاك في هيئة تكنوفراطي غير مكترث بآلام الشعب الأمريكي ومعاناته ، هذه المعاناة التي كانت تلمس عند كل زوايا الشوارع وأزقة الأرياف. ولم يبد أن ثمة شيئا سيحول دون إنجراف الاقتصاد الأمريكي نحو لجة الكساد الكبير.
لقد بلغ عجز الميزانية الحزمية في العام 1932 – على الرغم من الزيادات الضريبية التي استحدثها هوفر – 2.7 مليار دولار. ولم تتجاوز الإيرادات الحكويمة 1.9 مليار دولار. كان ذلك أسوأ عجز في ميزانية الحكومة زمن السلم في تاريخ البلاد. وكان الناتج القومي الإجمالي ذلك العام 58 مليار دولار ، أي ما لا يتجاوز 56 في المائة مما كان عليه قبل سنوات ثلاث. ووصلت نسبة البطالة إلى مستوى غير مسبوق على الإطلاق: 23.6 في المائة. لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. ذلك أن الملايين أيضا كانوا يعملون بدوام جزئي أم بأجور بخسة. لقد قل عدد ساعات العمل في العام 1932 بنسبة 40 في المائة عنه في العام 1929 ، وانتهى 1453 مصرفا إلى الإفلاس. وبذلك بلغ عدد المصارف المفلسة في سنوات الكساد مستوى كبير جدا : 5096 ، وفي العام 1929 بلغت إيداعات الأمريكيين الصمرفية 11 دولارا مقابل كل دولار في التداول ، كعملة ورقية أو معدنية. ووصلت هذه النسبة في العام 1932 إلى خمسة مقابل واحد ، بسبب انهيار كثير من المصارف وانعدام الثقة في كثير من البقية الباقية. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي إلى 41.22 نقطة ، أي بانخفاض 90 في المائة عن المستوى الذي كان عليه قبل سنوات ثلاث ، وأعلى بنقطة واحدة من مستواه في اليوم الذي بدأ فيه حساب هذا المتوسط في العام 1896.
وليس ثمة ما ينم عن الحالة الحرجة التي بات عليها الاقتصاد في خريف ذلك العام مثل تحول معدل افائدة على أذونات الخزانة إلى معدل سالب ، إن أذونات الخزانة – التي تقل آجال استحقاقها عن سنة واحدة – تباع بخصم على قيمتها الاسمية ، وترد ف يتاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الاسمية. ومع حلول خريف العام 1932 سعي كثير ممن كانوا يحوزون موجودات استثمارية لتوظيفها في أكثر الاستثمارات المتاحة أمانا ، وهي الالتزامات قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومات الوطنية (الإصدارات السيادية) التي يزيد سعرها على قيمتها الإسمية.
كان منافس هوفر على الرئاسة القادمة ذلك العام – فرانكلين روزفلت – يناقضة في كثير من الناحي عدا التوجه السياسية. لقد ولد هوفر لعائلة متوسطة الدخل واصبح يتيما بعد ولادته بمدة لم تطل. أما روزفلت فقد ولد لأسرة غنية أحاطت إبنها الوحيد بكل ضروب الحب والرعاية . كان هوفر حييا ، عنيدا أحيانا ، وكان وجوده وسط الجماعات الصغيرة يجعله في أفضل مزاج. أما روزفلت فكان لا يعرف التحفظ إطلاقا ، متحمسا أبدا ، وواثقا بنفسه أشد الثقة. كان هوفر ايضا حاد الذكاء ثاقب الفكر (وهما خصلتان تنمان بالضرورة عن الشئ ذاته) بعقل مهندس ، يجمع المنطق والانتظام. أما روزفلت فالبكاد قرأ كتابا عندما كان يافعا ، وكان يعول كثيرا على حدسه.
لكن ، إن كان لروزفلت فكر من الدرجة الثانية – كما لاحظ القاضي وينديل هولمز واعتقد – فإنه كان ذا مزاج من الدرجة الأولى ، كان سحره لا ينكر ولا سبيل إلى مقاومته. كوكانت روحه التفاؤلية الصادقة تنتقل إلى الآخرين بالعدوى.
ولم يتحدد مسار انتخابات العام 1923 بالقضايا المطروحة ، إذ لم يكن ثمة اختلاف يذكر بين الرجلين فيما سعيا من خلاله إلى التصدي للأزمة ، ووجه روزفلت انتقادات شديدة إلى هوفر لإخفاقه في تحقيق توازن الميزانية الحكومية. لكن ما حدد مسار تلك الانتخابات حقيقة كان عامل الشخصية. وهكذا فإن هوفر – الذي أرهقته سنوات أربع من الكوارث الاقتصادية المتفاقمة – عدم كل فرص النجاح. ففي العام 1928 نجح في استنهاض أربعين ولاية في مواجهة آل سميث. وفي العام 1932 تفوق على رزوفلت بست ولايات . لقد علقت الأمة – في نكبتها – كل آمالها المتقلقة على رجل واحد ، رجل كانت أعظم ملكاته أنه لم يشك يوما في أنه الرجل الأصلح لهذه المهمة.
وفي فترة الفراغ الرئاسية الطويلة ما بين انتخابات نوفمبر وتنصيب الرئيس الجديد في 4 مارس (وهي الأخيرة قبل أن يعدل التاريخ إلى 20 يناير) واصل الوضع الاقتصادي تدهوره بمعدلات خطيرة . وتساءل رايموند مولي – أحد مستشاري روزفلت المقربين – إذا ما كانت الإدارة الجديدة ستواجه ثورة شعبية عند أدائها القسم.
لكن الشعب الامريكي – بالمقارنة مع الاوروبيين تحديدا – لم يحتج ، وهذا مدعاة للعجب ، على الحال التي وجده نفسه فيها. كانت الاشتراكية – بوعودها بالمساواة والأمن – قد باتت منذ زمن طويل قوة سياسية مؤثرة في كل الدول الاوروبية الكبرى. غير أنه حتى في نوفمبر 1932 – في وقت بدا فيه الاقتصاد الأمريكي على حافة الانهيار – لم يكسب نورمان توماس المرشح الاشتراكي أكثر من 2.2 في المائة من الأصوات.
وفي أسوأ شتاء تعيشه البلاد منذ أن أقام الجيش القاري معسكره في وادي فورج ، انتظر الشعب الأمريكي نهاية رئاسة هوفر ووصل أرستقراطي نهر هدسون – الذي انتخبوه بأغلبية ساحقة – إلى البيت الأبيض.
لكن الأحوال ازدادت سوءا في فترة الإنتظار ، فقد هبط مؤشر الناتج الصناعي بين ديسمبر ومارس بنسبة 12.5 في المائ من 65 إلى 56 ، وكان هذا انخفاضا غير مسبوق. وواصل الذهب تسربه إلى خارج البلاد بكميات هائلة بلغت أحيانا 100 مليون دولار في الأسبوع الواحد ، وبلغ معدل حبس الرهن ألفين في الشهر الواحد . وفي 14 فبراير في العام 1933 أمر حاكم ميتشجان كل المصارف العاملة في الولاية بإغلاق لمدة ثمانية أيام للحيلولة دون أن يذهب هلع المودعين سريع الإنتشار بما تبقى من النظام المصرفي للولاية.
وفي اليوم التالي تلاشت آخر الأمال التي تعلق بها الشعب الأمريكي. فقد أنفق روزفلت عدة أيام مبحرا في مياه فلوريدا على متن يخت كبير يملكه جار له في دوتشس كاونتي هو فنسانت آستور ، واستقل في طريق عودته سيارة سياسيحة مكشوفة إلى حديقة ميامي ، حيث ألقى هناك خطبة قصيرة من مقعد السيارة الخلفي. وعندما فرغ من خطبته قدم إليه أنتوت سيرماك عمدة شيكاغو ليتبادل معه محادثة قصيرة. وأز الرصاص وترنح العمدة سيرماك ساقطا من الطلقات التي أصابته. وكانت موجهة أساسا إلى المرشح الرئاسي. ووضع روزفلت – وكان يشتهر بشجاعة ورزانة كبيرتين من جملة خصاله الأخرى – العمدة المصاب بجروج بالغة في المقعد المحاذي له وهرع إلى أحد المشافي. ولم يصب روزفلت بسوء.
لقد انتشر الهلع المصرفي الذي اندلع في متيشجان – وهي من أهم الولايات الصناعية – كالنار في الهشيم عبر البلاد. وحوصرت المصارف في كل مكان بالمودعين المروعين صارخين مطالبين بأموالهم. وخذت ولاية إثر أخرى حذو ميتشجان بإصدار أوامر تغلق بموجبها المصارف. ومع حلول 4 مارس كانت المصارف قد أغلقت كلها في اثنتين وثلاثية ولاية ، كما أغلقت معظم المصارف في الولايات الستة الأخرى. ووضع حكام الولايات قيودا صارمة على حجم المبالغ المسحوبة في الولايات العشر التي لم تغلق فهيا المصارف أبوابها. وفي تكساس حدد مبلغ السحب اليومي بعشرة دولارات. وفي يوم تنصيب الرئيس ، أعلنت بورصة نيويورك أنها لن تفتح أبوابها ذلك الصباح ، ولم تعلن موعد استنئاف التداول.
وعليه – وبعد أن أغلقت مصارف البلاد وبورصتها الرئيسية – شارف قلب الاقتصاد الأمريكي على التوقف.
| Table 2: Depression Data[2] | 1929 | 1931 | 1933 | 1937 | 1938 | 1940 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Gross National Product (GNP) 1 | 101.4 | 84.3 | 68.3 | 103.9 | 103.7 | 113.0 |
| Consumer Price Index 2 | 122.5 | 108.7 | 92.4 | 102.7 | 99.4 | 100.2 |
| Index of Industrial Production 2 | 109 | 75 | 69 | 112 | 89 | 126 |
| Money Supply M2 ($ billions) | 46.6 | 42.7 | 32.2 | 45.7 | 49.3 | 55.2 |
| Exports ($ billions) | 5.24 | 2.42 | 1.67 | 3.35 | 3.18 | 4.02 |
| Unemployment (% of civilian work force) | 3.1 | 16.1 | 25.2 | 13.8 | 16.5 | 13.9 |
1 in 1929 dollars
2 1935–39 = 100
الفصل السابع عشر: تحويل الإنكفاء إلى تقدم
تحويل الإنكفاء إلى تقدم
لو كان ثمة شك في مكانة العامل النفسي البشري كقوة محركة في عالم الاقتصاد ، فما على المرء إلى أن يتمعن في الأيام القلائل الاولى من إدارة فرانكلين روزفلت ، ليجد الدليل الدامغ على هذه المكانة. ففي يوم السبت 4 مارس ، وبينما كانت الملايين مصغية إلى المذياع ، ألقى روزفلت واحدة من قلائل خطب التنصيب التي لم تبرح ذاكرة الناس. لقد قدمت لنا فقرتها الأولى عبارة باتت على الفور جزءا من النسيج السياسي الأمريكي. "وإذن ، وبادئ ذي بدء ، إسمحوا لي بأن أؤكد إيماني الراسخ بان الشئ الوحيد الذي يجب أن نخشاه هو الخوف نفسه ، الهلع الذي لا يعرف اسما ولا منطقا ولا مبررا والذي يعرقل الجهود اللازمة لقلب الانكفاء إلى تقدم". وخلفت الخطبة أثرا كالسحر في الشعب الأمريكي. وفي أول اسبوع من الخطبة ، تسلم البيت الأبيض 450 ألف خطاب وبطاقة. ولم يكن هوفر يحتاج إلى أكثر من موظف واحد للإشراف على بريد البيت الأبيض. أما روزفلت فكان في حاجة إلى سبعين موظفا.
وفي اليوم التالي دعا الكونجرس إلى الانعقاد في جلسة خاصة في يوم الخميس التالي ، وأصدر أمرا إداريا – بموجب نص قانون "التجارة مع العدو" الذي يدعو إلى الريبة ، والذي أقر زمن الحرب العالمية الأولى – بإغلاق كل مصارف البلاد إلى حين يفرغ الكونجرس من جلسته ، وعقد اجتماعات طارئة للمصارف الكبرى. وعملت وزارة الخزانة – التي كان لا يزال معظم موظفيها من فريق إدارة الرئيس هوفر – مع المصارف بجد وحماس في الأيام القليلة التالية لإعداد قانون الإعانة الطارئة للمصارف.
وفي يوم الأربعاء 8 مارس عقد روزفلت أول مؤتمر صحافي له ، حيث احتشد 1256 صحافيا في المكتب البيضاوي. وعندما فرغ من عرض ملاحظاته ، التي أعدها مسبقا ، طفق الصحافيون – ولمرة واحدة ربما في التاريخ – بالتصفيق الجماعي. لقد أراد الشعب الأمريكي – ومنه الصحافيون – النجاح لروزفلت ، ولهذا بالتحديد نجح روزفلت في مساعيه.
لقد عرض مشروع المصارف على الكونجرس في الساعة الواحدة من يوم الخميس ، فأقره من دون تلاوته ، بتصفيق تهليلي بعد ثمان وثلاثين دقيقة. وأقره مجلس الشيوخ بمعارض سبعة أعضاء فقط (وكلهم من أعضاء الولايات الريفية) ، ووقعه الرئيس قانوانا في الساعة 8.36 مساء ذلك اليوم.
وقد أجاز القانون ما فعله روزفلت قبلا ، ومنحه صلاحيات واسعة جديدة لتنظيم عمل النظام المصرفي والصرف الأجنبي في المستقبل. وحدد يوم الاثنين 13 مارس موعدا تعيد فيه المصارف – التي أعلنت ملاءتها المالية – فتح أبوابها. وفي يوم الأحد 12 مارس ألقى أول خطبة إذاعية له من داخل البيت الأبيض. وفي نبرة ارستقراطية أبوية ، واعظة ومواسية ، أبلغ الجمهور أنه عندما تعيد المصارف فتح أبوابها غدا سيكون "إيداع أموالكم في مصرف أعاد فتح أبوابه أكثر أمانا من تركها تحت الحشية".
وصدقه الناس ، وبدأ المال والذهب يتدفقان في اليوم التالي إلى النظام المصرفي.وعاد قلب الاقتصاد الأمريكي ينبض من جديد. ونقل عن ريموند مولي قوله – باعتداد بالنفس له ما يبرره – إن "الرأسمالية أنقذت في ثمانية أيام".
لقد قسم دستور الجمهورية الرومانية – وكان مواطنوها يخشون السلطة التنفيذية بعد سقوط الأباطرة – هذه السلطة بين حاكمين يشغلان المنصب عاما واحدا ويتناوبان يوميا على إدارة الحكومة والجيش. وأدرك الرومان أن هذا النظام لا يؤدي الغاية منه في أوقات الطوارئ والأزمات. لذلك أجاز الدستور – إذا دعت الضرورة – أن يتقلد الحاكم سلطة مطلقة لستة أشهر . كان يطلق على هذا الحاكم الوقتي اسم الديكتاتور (الحاكم المطلق).
لقد كان فرانكلين روزفلت في الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسته ، أو الأيام المائة كما أطلق عليها ، الديكتاتور الأمريكي باشد ما تنطوي عليه هذه التسمية.
إن مجموعة التشريعات التي أصدرت وأقرت في قوانين لهي مدعاة إلى الدهشة والعجب:
1 9 مارس: وقع الرئيس روزفلت قانون الإعانة الطارئة للمصارف. 2 20 مارس: وقع الرئيس روزفلت قانون الاقتصاد الذي يقضي بإعادة تنظيم الحكومة وخفض الرواتب ومعاشات تقاعد المحاربين القدماء – كان هؤلاء ربما أعظم قوة ضغط في واشنطن العاصمة آنذاك – لتقليص النفقات الحكومية بمبلغ 500 مليون دولار. 3 21 مارس: وقع روزفلت قانون المعونة لأعمال التحريج والفرق المدنية لحماية البيئة ، لتوفير العمل لنحو 250 ألف شاب في مشاريع الإعمار وحماية البيئة. 4 22 مارس: وقع روزفلت قانون إيرادات البيرة والخمور ، الذي أجاز تجارة البيرة والخمور التي تقل فيها نسبة الكحول عن 4 في المائة ، وفرض عليها ضرائب ثقيلة لزيادة إيرادات الحكومة. 5 19 ابريل: أبطل روزفلت التعامل بمعيار الذهب ، وأخرج الذهب من التداول النقدي ، وذلك بحظر استخدام المسكوكات الذهبية كعملة قانونية وإعادتها إلى الخزانة. وحظر على المواطنين حيازة السبائك الذهبية . وفي العام التالي خفض قيمة الدولار من 20.66 دولار لأوقية الذهب الواحدة إلى 35 دولار للأوقية. 6 12 مايو: وقع روزفلت قانون المعونة المالية الفدرالية الطارئة لتقديم منح تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار إلى الحكومات لتمويل المساعدات المالية للعاطلين عن العمل. 7 12 مايو: وقع روزفلت قانون تنظيم الزراعة لتقديم المعونة المالية للمزارعين ، مع وضع إجراءات لزيادة أسعار المنتجات الزراعية وتقنين الإنتاج وإعادة تمويل الرهونات الزراعية. 8 18 مايو: وقع روزفلت مشروع قانون يسمح بإنشاء هيئة وادي تينسي لتطوير وادي نهر تينيسي ببناء السدود التي ستمد سبع ولايات بالطاقة الكهربائية. 9 27 مايو: وقع روزفلت قانون الأوراق المالية الفدرالي الذي فرض على الشركات الإفصاح الكامل عن المعلومات المالية اللازمة للمستثمرين. وكان هذا أول الضوابط الفدرالية التي تنظم تداول الأوراق المالية. 10 5 يوينو: ألغى الكونجرس بقرار مشترك من مجلسيه الفقرات التعاقدية التي توجب الدفع بالذهب. 11 6 يونيو: وقع روزفلت قانون التوظيف الوطني الذي أسست بموجبه مصلحة التوظيف الأمريكية للعمل مع وكالات التوظيف على مساعدة العاطلين لإيجاد فرص العمل. 12 13 يونيو: وقع روزفلت قانون إعادة تمويل ملاك المساكن الذي تأسست بموجبه مؤسسة تسليف ملاك المساكن والتي خولت إصدار سندات بقيمة ملياري دولار لمساعدة ملاك المساكن غير الزراعية على الاحتفاظ بأملاكهم. 13 16 يونيو: وقع روزفلت قانون المصارف للعام 1933 الذي عرف بقانون جلاس-ستيجال ، وعما عضوا الكونجرس للذان تقدما بمشروع القانون. وقد شكل هذا القانون حافزا كبيرا للقطاع المصرفي الأمريكي. 14 16 يونيو: وقع روزفلت قانون التسليف الزراعي لإعادة تمويل القروض الرهنية الزراعية. 15 16 يونيو: وقع روزفلت قانون النقل بالسكك الحديد لتعزيز الضوابط الفدرالية على شركات السكك الحديد وشركاتها القابضة. 16 16 يونيو: وقع روزفلت قانون إنعاش الصناعة الوطنية الذي يقضي بإنشاء إدارة الإنعاش الوطني (أو الNRA كما ياتتتعرف في خضم ذلك الخليط الألفبائي الذي اشتهر به البرنامج الجديد) ، والتي أسست عددا من اتحادات الكارتل الصناعية "للحد من المنافسة الشديدة".
إن الكساد – بالتعريف – هو فترة يمر الاقتصاد فيها بحالة انكماش. وقد جلبت الأيام المائة لروزفلت نهاية هذا الانكماش الذي بدأ في مطلع العام 1929. وظهرت بوادر تعافي الاقتصاد مع تجدد ثقة الشعب الأمريكي بالاقتصاد والدولة ، بفضل قوة شخصية الرئيس وإجراءاته الحاسمة وروحه التفاؤلية التي لا تلين. وسيكون العام 1933 من أفضل أعوام القرن العشرين بالنسبة إلى وول ستريت ، التي كانت بدورها تتعافى من آثار التراجع الحاد في أدائها . إذ ارتفع مؤشر داو جونز ذلك العام بنسبة 60 في المائة تقريبا وبدأت بعض شركات السمسرة إعادة تشغيل موظفيها.
كانت لا تزال أمام البلد أشواط طويلة لبلوغ الازدهار ، لكن خط الصعود الذي انتهجه كان الطريق الصحيحة. ذلك أن الناتج القومي الإجمالي لم يتجاوز 55.6 مليار دولار في العام 1933 – وهذا أدنى مستوى له منذ العام 1916 – من دون احتساب أثر التضخم. وفي العام التالي ارتفع هذا الناتج إلى 65.1 مليار دولار. ووصل في العام 1937 90.5 مليار دولار. كما ارتفع عرض النقد وأسعار الجملة أيضا بمعدل تتراح بين 10 في المائة و12 في المائة سنويات في السنوات الأربع بعد العام 1933. ومع ذلك فقد ظلت البطالة مرتفعة – ولم تبد أي نزعة للانخفاض – ولم تتراجع إلا إلى 14.3 في المائة في العام 1937 . وكان جزء كبير من النشاط الاقتصادي المتجدد يقوم على جهد عمال اشتغلوا بدوام جزئي في وظائف تتطلب دواما كاملا ، مما أخر الحاجة إلى توظيف عمال جدد.
(كان من النتائج المغفلة ، ولكن إجيابية الأثر ، للبطالة المستحكمة في ثلاثينيات القرن العشرين حقيقة أن الأطفال باتوا يمكثون في المدارس طويلا ، وتضاعف عدد الحاصلين على دبلومات عالية في ذلك العقد ، وازداد عدد الذين نالوا شهادات جامعية بنسبة 50 في المائة. وفي العام 1940 كان 8.1 في المائة ممن بلغوا سن الثالثة والعشرين يحملون شهادات برتبة الإجازة الجامعية).
لن يحدث البرنامج الجديد في أول عهده أثرا في الاقتصاد الأمريكي أعظم من الأثر الذي خلفه في القطاع المصرفي ، وهو القطاع الوحيد الذي شارف على الانهيار التام مع تفاقم حدة الكساد. لقد عزز قانون جلاس-ستيجال رقابة الاحتياطي الفدرالي على النظام المصرفي للدولة ، وسمح لفئات أخرى من المصارف – كمصارف الإدخار – بالانضمام إلى عضويته – كما أعطى الاحتياطي الفدرالي الصلاحية لضبط المضاربة في وول ستريت عبر تحديد متطلبات الهامش رسميا.
وفي العام 1935 زاد قانون الاحتياطي الفدرالي صلاحيات مصرف الاحتياطي ومركزيتها. وأسبغت على رؤساء مصارف الاحتياطي الفدرالي الإقليمية – الذين أطلقوا عليهم اسم "حاكم (محافظ)" ، وهو يحمل في طياته سلطة كبيرة في عمل المصرف المركزي – مسميات جديدة ، واصبح مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن مجلس المحافظين (من محافظ المصرف المركزي) ، حيث استقر رأس السلطة منذ ذلك الحين. وكان كل عضو يعين لفترة أربع عشرة سنة ويعين رئيس المجلس من بين الأعضاء لفترة أربع سنوات. ولضمان استقلاله عن التجاذبات السياسية – وقد رأى ألكساندر هاملتتون في ذلك ضرورة لازمة قبل 150 عاما – فلم يكن ممكنا عزل أعضاء مجلس المحافظين إلا لأسباب موجبة.
وحصرت صلاحيات عمليات السوق المتفوحة – وهي أداة أساسية لتنظيم عمل النظام المصرفي وأسعار الفائدة – بيد لجنة السوق المفتوحة الفدرالية في واشنطن ، بدلا من ترك تصريفها للمصارف الإثنى عشر في المناطق الإقليمية. هذه اللجنة كانت تتألف من سبعة أعضاء من مجلس المحافظين وخمسة أعضاء يعينيهم الإحتياطي الفدرالية في نيويورك. كما أعطي الاحتياطي الفدرالي صلاحيات تحديد متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الأعضاء ، وهي أداة أخرى فعالة في ضبط أسعار الفائدة وعرض النقد.
ولأول مرة في تسع وتسعين سنة ، منذ أن قوض الرئيس أندرو جاكسون ، المصرف الثاني للولايات المتحدة ، صادر للدولة مصرف مركزي يمارس وظائفه كاملة ويتمتع بالصلاحيات اللازمة. لقد تكبدت البدلا ثمنا باهظا لإفتقارها إلى مصرف مركزي في تلك السنوات ، ولأنها عدمت الخبرة الواسعة في حقل تخصص فريد من نوعه هو الصيرفة المركزية.
كما أنشأ قانون جلاس-ستيجال مؤسسة تأمين إيداعات المصارف الفدرالية ، التي قدمت ضمانات على إيداعات المصارف الأعضاء في النظام (لم يكن يطلب الانضمام إلى النظام إلا من المصارف الأعضاء في الاحتياطي الفدرلي) ، التي لا يزيد حدها الأعلى على 5 آلاف دولار للحساب الواحد. وعند الأزمة ، صار نزيف إيداعات المصارف – وهو كابوس عاشه الاقتصاد الأمريكي مرارا منذ أولى حوادث نزيف الإيداعات في العام 1809 – شيئا من الماضي ، لقد ساورت روزفلت مخاوف من "المخاطر المعنوية" التي خلقها النظام الذي أزاج عن كاهل المصرفيين مخاوفهم من خسارة أموال المودعين. لكنه إرتأى أن العمل على مكافحة نزيف إيداعات المصارف يستحق المحاولة والجهد. ولم يقع نزيف يذكر في الإيداعات المصرفية منذ ذلك الحين ، لكن الأحداث التي وقعت بعد وفاته بزمن طويل ستبرهن أن روزفلت كان مصيبا في مخاوفه.
لقد قوى قانون جلاس-ستيجال كثيرا المصارف الوطنية بعد أن أجاز لها افتتاح فروع لها في الولايات التي تتخذ منها مقرا رئيسيا لها ، إذا سمحت الولاية المعنية بافتتاح فروع للمصرف. وقد أتاح هذا لتلك المصارف تنويع عملياتها عبر منطقة جغرافية واسعة ، وبالتالي أن تنأى بنفسها عن التقلبات الاقتصادية المحلية ، كتسريح شركة محلية كبرى العمال بأعداد كبيرة. ولسوء الطالع لم يبلغ الإصلاح الحد المطلوب ، وظل الحظر قائما على افتتاح فروع للمصارف بين الولاايت ، وهذا ما حد من حجم المصارف ومواردها.
لقكن قانون جلاس-ستيجال ساهم كثيرا في إضعاف المصارف الكبرى المتنفذة بإجبار المصارف التي تقدم خدمتي حساب الإيداع وحساب الاستثمار معا على إختيار خدمة واحدة من بينهما. لقد ظلت شركة جي بي مورجان وشركاه – على سبيل المثال – مصرفا للإيداع وتفرعت عنها شركة مورجان وستانلي وشركاهما.
ومع نمو الشركات حجما وربحية في العقود الأولى من القرن العشرين ، تراجع اعتمادها على مصارف وول ستريت في تمويل توسعاتها واستحواذاتها ، موظفة فيالمقابل أرباحها المستبقاة (المتحجزة) ، مستفيدة من سوق الأوراق التجارية. لذلك لم يعد مورجان يتمتع بذلك النفوذ الواسع في الاقتصاد الأمريكي ، الذي كان له في مطلع القرن العشرين. لكن قانون جلاس-ستيجال أضعف مصرف مورجان والمصارف المماثلة أكثر فأكثر.
لقد كانت ثمة حاجة إلى الفصل بين وظيفتي قبول الإيداعات والاستثمار في شركات مستقلة غير متداخلة ، لأن مزاولة العملين تحت الإدارة نفسها كان – وفق الاعتقاد السائد – مصدر صراع محتوم في المصالح سبب تفاقم أزمة المصارف في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين. وفي الواقع لم يكن ثمة دليل كاف على ذلك ، وفي غضون سنتين أدرك عضو مجلس الشيوخ كارتر جلاس نفسه – وهو الذي تقدم بمشروع القانون (وكان صاحب فكرة نظام الاحتياطي الفدرالي نفسه قبل عشرين عاما خلت) – أن هذا الفصل بين وظيفتي قبول الايداعات والاستثمار في المصارف لم يكن صائبا.
كان القانون الصارم يقضي بأن إقرار مشروع جديد أيسر وأسهل كثيرا من إبطال العمل بقانون قد صدر ، وسيتطلب تعديل تلك الفقرة من قانون جلاس-ستيجال أكثر من ستين عاما مقبلة ، وتحت ظروف اقتصادية مغايرة لتلك التي صدر في ظلها القانون. وفي ذلك الحين فقط سيسمح للمصارف أخيرا بأن تفتح فروعا لها في أكثر من ولاية.
وبعد الاصلاحات في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين استقر النظام المصرفي الأمريكي ، وصار قادرا على الوفاء بمتطلبات الاقتصاد والدولة. لكنه سيظل – مع ذلك – أكثر الأنظمة المصرفية في العالم تعقيدا واستعصاء على الفهم ، بسبب تداخل عمل الهيئات الإشرافية على مستوى الولاية والمستوى الفدرالي ، كما ستنشأ فيه مصارف جديدة على الدوام. وعلى الرغم من عمليات الإندماج ، فستظل في الولايات المتحدة – العام 2003 – أكثر من سبعة آلاف مصرف مستقل قانونيا ، أي ما يتجاوز عدد المصارف مجتمعة في جميع بلدان العالم المتقدم.
لقد طرأت تغيرات جذرية على وول ستريت في تلك الأعوام ، مع أنها أبدا مقاومة أشد لتلك التغيرات مما أبدته الصناعة المصرفية. وقد قاد هذه المقاومة ريتشارد ويتني بطل الخميس الأسود ، الذي تبوأ منصب رئيس بورصة نيويورك عن جدارة واستحقاق في العام 1930. لقد كشفت سلسلة من جلسات الكونجرس – وصارت تعرف باسم رئيسها المستشار القانوني فرديناند جي بيكورا – كثيرا من الجوانب التي لا سبيل إلى إنكارها في آلية عمل وول ستريت.
كانت بورصة نيويورك مؤسسة خاصة يملكها أصحاب مقاعد العضوية فيها. وعلى الرغم من أن البورصة كانت ، فترة طويلة ، آلية حيوية في النظام المالي للدولة ، فإنها ظلت أداة لمصلحة أصحاب تلك المقاعد حصرا. وكان الأعضاء المتخصصون – وهم أعضاء البورصة الذين يقع على عاتقهم تأمين الأداء المنتظم للصوق في عدد من الأسهم المدرجة – في مرز يؤهلهم إلى معرفة الأداء المحتمل لتلك الأسهم في المستقبل القريب. إن تجار الصالة هم أيضا أعضاء في البورصة ، لكنهم يتداولون فقط لحسابهم الخاص. وبفضل قدرتهم على الوصول إلى قاعة التداول ، فإنهم أيضا قادرون على الحصول على معلومات لا تتوافر إلى للمطلعين. وقد تلاعب الاختصاصيون وتجار الصالة طوال سنوات الطفةر الاقتصادية في عشرينيات القرن العشرين بالأسهم عبر تشكيل تجمعات التلاعب بالأسهم (أو ما كان يعرف بلغة تلك الأيام بعبارة "خذهو بيدك") للكسب على حساب المتداولين غير المطلعين.
ومع الطفرة التي عرفها تداول الأسهم عموما ، لم تكن ثمة مطالب كثيرة لإصلاح آلية عمل البورصات. لكن وبعد انهيار السوق ، تصاعدت حدة الضغوط المنادية بالإصلاح في ظل الخروقات الجديدة التي كانت ترتكب يوميا. ورحب كثير من المتداولين في وول ستريت بهذه الإجراءات بل إن منهم من عمل لأجل الإصلاح وخاصة السماسرة الذين يمتهنون شراء الأسهم وبيعها "بالمفرق" ، وكانوا بالتالي يعولون في كسب رزقهم على ثقة الجمهور.
أما من أفاد من الحالة الراهنة ، كالمتخصصين وكبار المضاربين بالطبع ، فقد قاوموا الإصلاح بضراوة. كان الوضع في ثلاثينيات القرن العشرين مشابها جدا للحالة التي كانت سائدة في حقبة ما بعد الحرب الأهلية مباشرة. لقد أشار ريتشارد ويتني – قائد ما يعرف بالحرس القديم – إلى أن "البورص مؤسسة مثالي" لكنه أقر ضمنا بأنها لم تكن ذلك عندما أجرى عددا من الإصلاحات منها منع المتخصصين من إمتلاك حقوق إختيار الأسهم التي يباشرون في تداولها (يخلقون سوقها) وتقديم المعلومات المتاحة لهم بحكم عملهم وإطلاعهم إلى معارفهم وأصدقائهم.
واعتزم روزفلت إحداث إصلاحات شاملة أوسع من ذلك. وفي العام 1934 أنشأ الكونجرس لجنة الأوراق المالية والبورصة لتضطلع بالرقابة على هذا القطاع. وكان جوزيف بي كينيدي أول رئيس لهذه اللجنة – وكان اختياره لهذا المنصب منافيا للمنطق تماما – نظرا إلى أن كينيدي كان من أنجح المضاربين وأكفئهم في فترة العشرينيات التي ازدهرت فيها الأسواق ، وكتبت مجلة "نيوزويك" متهكمة آنذاك ، أن "السيد كينيدي – وهو مضارب سابق ورئيس لأحد تجمعات التلاعب بالأسهم – سيكبح المضاربة الآن ويحظر تجمعات التلاعب بالأسهم". وأخر مجلس الشيوخ – الذي كان حذرا من تعيين ثعلب حارسا للحم الدجاج – تعيينه ستة أشهر ريثما يتأكد من سلوك كنينيدي وأدائه.
كان كينيدي حاد الذكاء – وبالغ الثراء – وهذا ما حال بينه وبين محاولة التكسب من منصبه ، وأبلى مبلاء حسنا في النهوض بلجنة الأوراق المالية والبورصة مما جعل مجلس الشيوخ يصدق على تعيينه من دون تردد أو اعترضا. وكان كينيدي ، الذي يعرف جيدا مكامن المخالفات والأعمال غير المشروعة في وول ستريت ، يعتبر مهتمه الأولى هي القضاء على ما يعرف "إحجام رأس المال Strike of Capital" ، أي رفض المصارف مديرة الإصدارات – التي هزتها الصدمة كثيرا – تعهد أي إصدارات جديدة ، بغض النظر عن جودتها.
واستقال كينيدي بعد ستة عشر شهرا ، وهكذا صار ثالث رئيس للجنة – ويليام أو دوجلاس (وسيتبوأ منصب قاضي في المحكمة العليا فيما بعد ، يبقى فيه لما يزيد على ثلاثين عاما) – يطالب بإحداث إصلاحات جذرية في وول ستريت . ولقد تقاعد ويتني من منصب رئيس بورصة نيويورك في العام 1935 ، لكن ظل يشغل منصبه في مجلس المحافظين وكان أشهر سماسرة وول ستريت على الإطلاق. وقد حدث خليفته في المنصب قائلا: "إن ملايين الناس ترى البورصة مجسدة في شخصي".
عاش ويتني حياة الترف ، حيث كان له منزل ريفي في الشارع الثاني والسبعين شرقا ، ومزرعة كبيرة في نيوجيرسي اعتاد فيها أن يمارس صيد الثعالب – وهي من أكثر الرياضات البرية تكلفة – وكان عضوا في كثير من الأندية. كما كان ينفق 5 آلاف دولار في الشهر في وقت كان فيه متوسط الدخل الفردي السنوي لا يزيد على 700 دولار. لكنه لسوء حظه لم يكن قادرا على تأمين الموارد اللازمة لهذا الإنفاق. إذ إن شركة السمسرة التي يملكها – وكان مصرف مورجان من عملائها (وهذا ما أسبغ عليها سمعة ذائعة ، على الرغم من قلة أعمالها) – لم تكن تحقق دخلا كبيرا ، كما منيت كل استثماراته بالخسارة. فكان يؤمن مصروفاته بالاقتراض من الأصدقاء والمعارف ، وخصوصا من شقيقه الأكبر جورج ويتني الذي كان شريكت في جي بي مورجان وشركاه.
وبدأت يده تمتد – بعد أن لم تكفه موارده – إلى حسابات عملائه وأنديته ، بل حتى إلى حساب الاستثمار الذي ائتمنته عليه زوجته. وكما هو مصير المختلس دائما ، فقد تفاقمت حاله ، وفي 7 مارس 1938 أوقفت بورصة نيويورك التداول لتعلن تعليق عمل شركة ريتشارد ويتني وشركاه بسبب "تصرفات غير قانونية ومنافية لمبادئ التداول النزيه".
وعمت الصدمة الكبرى مؤسسة وول ستريت فكتبت صحيفة "الأمة" (ناشن) – وهي صحيفة سياسية يسارية – بنبرة يغلبها الإبتهاتج: "إن وول ستريت في موقف حرج جدا .. وما كانت لتشعر بحرج كهذا لو أن جي بي مورجان وجد يتسول على باب كاتدرائية القديس يوحنا.
واحتشد ستة آلاف شخص في محطة قطار جراند سنترال في 12 ابريل لمشاهدة ريتشارد ويتني – مصفدا في الأغلال – يستقل قطارا سينقله إلى سجن سنج سانج . وفي غضون ذلك ، تحرك ويليام أو دوجلاس سريعا لاغتنام حال الارتباك العام التي ألمت بحرس وول ستريت القديم. وقبل نهاية العام ، اعتمدت البورصة نظاما داخليا جديدا ، يضع مسئولياتها العامة قيد المساءلة . وصار الرئيس موظفا مأجورا وليس عضوا. كما صار لزاما على الشركات الخضوع لمزيد من عمليات التدقيق الحسابي الخارجي ، ولم يعد يسمح للأعضاء بشراء الأسهم يتمويل جزئي (الشراء بالهامش) إذا كانوا يقدمون خدماتهم لعملائهم. وخفضت النسبة القانونيو للدين إلى رأس المال ، مما جعل شركات السمسرة أكثر استقرارا وقدرة على مواجهو فترات التراجع في أداء السوق.
والأهم من هذا ، لم تعد عمليات البيع على المشكوف (البيع القصير) جائزة إلا صعودا ، أي عند سعر يزيد على سعر البيع السابق. وقد قطع ذلك الطريق على إحدى الأدوات الأساسية التي كان بها المضاربون على الهبوط بقوضون استقرار السوق في عشرينيات القرن العشرين. وساعدت على الحد من شدة موجات الهلع التي عرفتها هذه السوق في العام 1929. وفي نهاية الثلاثينيات باتت وول ستريت مؤهلة للإفادة من الثورة التي سيشهدها تداول الأسهم في العقد التالي.
وستنكب المحكمة العليا على ابطال الكثير مما جاء به البرنامج الجديد الأول ، في وقات شهدت فيه السياسة الأمريكية تحولا جذريا. فمن ناحية ، بات الحزب الديموقراطي حزب الأغلبية ، وبقيادة واحد من أبرع السياسييين الأمريكيين فيمختلف العصور. ففي السنوات الاثنتين والستين التي تلت انتخابات العام 1932 سيهيمن الديموقراطيين على مجلس النواب ، باستثناء سنوات أربع هي 1947 – 1948 – 1953 – 1954. وبعد انتخابات العام 1936 عندما كسب روزفلت – في أكبر فوز ساحق في التاريخ الأمريكي حتى تلك اللحظة – ستا وأربعين ولاية ، ولن يكون للحزب الجمهوري إلا ستة عشر عضوا في مجلس الشيوخ وتسعة وثمانون عضوا في الكونجرس.
بدأت قيمة الناتج القومي الإجمالي المتدفق سنويا في شرايين الحكومة الفدرالية تحقق زيادة مطردة. كان الانفاق الحكومي في العام 1929 يمثل نحو 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وفي العام 1940 تجاوز 9 في المائة. ومن جانب آخر ، ارتفعت نسبة الدين القومي إلى الناتج القومي الإجمالي من 16 في المائة إلى أكثر من 50 في المائة ، وهذا يعتبر أعلى إرتفاع زمن السلم حتى ذلك التاريخ. كانت الغاية تتمثل في جعل ميزانية الحكومة الفدرالية ضربا من "دولاب التوازن" المالي بحيث يزود النظام في أوقات تراجع الطلب بالمحفز الاقتصادي اللازم ويحول دون الانجراف في دوامة هبوطية تعزز نفسها بنفسها كتلك التي وقعت في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين. ومنذ الحرب العالمية الثانية لم ترتفع نسبة البطالة إلا مرة واحدة = ولمدة لم تطل – فوق حاجز 10 في المائة.
لقد طرأت تغير جذري مستدام على الأولويات المالية الوطنية. فقبل كارثة الكساد الكبير كان تحقيق توازن الميزانية وسداد أقساط الدين القومي على رأس المسؤوليات المالية الواقعة على عاتق الحكومة الفدرالية. وبعد العام 1933 ، صارت الحيلولة دون تكرار "الكساد الكبير" أولى مسؤوليات الحكومة لا بل أحيانا مسؤولياتها الوحيدة. كما بات ينظر إلى الحكومة كملاذ أخير – على الأقل – لتوفير موجبات الحياة الكريمة.
كان معنى ذلك ولا ريب أن دور الحكومة في الاقتصاد يجب أن يتعاظم أيضا. ولن يخفض الدين القومي – مرة أخرى – وبنسبة كبيرة بلعغة الوحدة النقدية (من دون مراعاة أثر التضخم) (على الرغم من أنه سيشهد تغيرات كبيرة بالنسبة إلى الناتج القومي الإجمالي). وستحقق الموازنة العامة – التي كاتنت لثلثي الفترة السابقة للعام 1933 ذات فائض – فائضا في 16 في المائة من الفترة التي أعقبت ذلك التاريخ.
والأهم من هذا أن البرنامج الجديد أصاب بمجمله نجاحا باهرا ، على الرغم من إخفاق كثير من برامجه وقصر نظر عدد من مبادئه الاقتصادية. وقد باتت الولايات المتحدة – منذ عهد البرنامج الجديد – مجتمعا أغنى وأكثر أمنا من الناحية الاقتصادية وأقرب إلى العدالة. وقد صاترت منذ ذلك الحين بلدات هو الأعظم في فرصه المتاحة للجميع وبالتالي الأكثر قدرة على خلق الثروة وإنتاجها. ولم تبذل أي جهود سياسية جادة لمقاومة البرنامج الجديد ، على الرغم من أن أسوأ أسسه الفكرية – مثل انتشار الكارتلات في مختلف أركان الاقتصاد الأمريكي – قد طرحت جانبا وأدخلت إصلاحات على كثير منها ، ذلك أن الديموقراطية هي صيرورة إصلاحية لا تتوقف. إننا جميعا = وبكل ما تعنيه الكلمة – ووفق تعبير ريتشاد نيكسون – "جيل البرنامج الجديد".
وبعد أن أبطلت المحكمة العليا معظم البرنامج الجديد الأول (إذ لم تكن بعض برامجه وخصوصا إدارة الإنعاش الوطني NRA تؤدي المطلوب منها بأي حال) فإن إدارة الرئيس روزفلت – التي لم تنقصها الروح البراجماتية إطلاقات – عكفت على تجريب برامج جديدة . وفي العام 1935 أطلقت ما بات يعرف بالرنامج الجديد الثاني ، وقد دعا هذا البرنامج إلى "الضمان الاجتماعي" وإحداث إصلاحات مصرفية واسعة وتطبيق برامنج أشغال أكثر شمولا (ومنهات إدارة مشاريع الأشغال العامة) وزيادة الضرائب على الدخول المرتفعة والمواريث ، و(ومنها ما يعرف باسم ضريبة الثروة على العقارات التي تزيد قيمتها على 50 مليون دولار ، وهذه العتبة من الثراء لم تتخطها سوى أسر معدودة) ، وإيلاء العمل المنظم رعاية خاصة ليسهل على الاتحادات تنظيم العمال في صفوفها.
لقد أحدث هذا تغييرا جذريا في بيئة العمل في الولايات المتحدة ، وخصوصا في حقل التصنيع الذي كان قلب الاقتصاد الأمريكي آنذاك. كان إصلاح علاقات العمل في الولايات المتحدة – وكثير من التحسينات التي عزيت إلى البرنامج الجديد – قد استهل في زمن رئاسة هوفر. وقد أبطل قانون موريس لاجارديا للعام 1932 عقود إذعان العامل – التي يتعهد العامل بموجبها بعدم الإنضمام إلى اتحادات العمال – بحكم القانون وحظر الأوامر القضائية الزاجرة للإضطرابات والاعتصامات العمالية. لكن الكساد خلف أثرا سلبيا بالغا في العمل المنظم. ففي العام 1933 لم تتعد عضوية اتحاد العمال الأمريكي 2.3 مليون عامل ، وهذا هو ما كان عليه تقريبا منذ مطلع القرن.
وفي العام 1935 أقر قانون علاقات العمل الوطني (الذي بات يعرف بقانون واجنر ، على اسم واضع مشروعه عضو الكونجرس روبرت واجنر من نيويورك). وكان هذا القانون يعرف أيضا باسم الوثيقة العظمى للعمل المنظمن في الولايات المتحدة. وقد كفل حق العمال بالانضمام إلى الاتحادات التي يشائون وممارسة التفاوض الجماعي مع رب العمل. كما جاء بقائمة طويلة عدد فيها "الممارسات المجحفة بحق العمال" التي حظر على الشركات اللجوء إليها (لكنها لم تورد الممارسات التي يحظر على الاتحادات إتيانهات). وقد أسس مجلس علاقات العمل الوطني للرقابة على سوق العمل والإشراف على الانتخابات . وأصدر معظم الولايات الصناعية الرئيسية قوانين اتخذت قانون واجنر مرجعا لها.
إن الحكومة الأمريكية – التي طالما كانت إلى جانب رب العمل (الإدارة) – صارت الآن نصيرا متحمسا للعمال. صحيح أن أعمال العنف كانت تندلع كلما افتتح مصنع أو معمل جديد ، لكنها كانت أقل خطرا من الاشتباكات العمالية التي وقعهت في أواخر القرن التاسع عشر. حتى هنري فورد – وقد تقدم به العمر ، وهو من رجالات القرن التاسع عشر أساسا الذي عارض بشدة ظاهرة الاتحادات – لم يكن من خيار أمامه إلى التفاوض مع والتر روثر واتحاد عمال صناعة السيارات في العهام 1939.
وفي السنوات الست التي أعقبت صدور القانون ارتعفت عضوية الاتحادات العمالية بأكثر من الضعف. وستمثل الاتحادات العمالية في مطلع خمسينيات القرن العشرين نحو 35 في المائة من العمالة الأمريكية . وتطورت عضوية النقابات الحرفية التابعة لاتحاد العمال الأمريكي كثيرا ، لكن المكاسب الكبرى كانت من نصيب العمال غير المهرة ونصف المهرة الذين كانوا في حاجة أكثر من غيرهم إلى اتحاداتت عمالية تدافع عن حقوقهم ومصالحهم. لقد ضم كونجرس المؤسسات الصناعية – الذي تأسس كمنظمة عمالية مستقلة برئاسة جون لويس من اتحاد عمال المناجم في العام 1937 – نحو 2.7 مليون عضو في العام 1941.
وكان من الجوانب المهمة جدا في البرنامج الجديد الثاني التحرك لإيصال الكهرباء إلى مناطق واسعة من البلاد لم يبلغها التيار الكهربائي . إن تكلفة توصيل الكهرباء إلى منطقة ما – من حيث بناء مرافق التوليد – ومد أسلاك – لا تختلف تقريبا بين منطقة مكتظة بالكسان ومنطقة غير مكتظة. لكن انخفاض الكثافة السكانية في منطقة ما عن مستوى معين يجعل تشغيل المرافق عملا مكلفا جدا على أساس الفرد الواحد. وإن انتشار التلفاز الكابلي في العقود الأخيرة سار تماما على أساس التوزيع النقطي نفسه وللأسباب الاقتصادية ذاتها تماما.
ولأن القطاع الخاص كان عاجزا عن توصيل الكهرباء إلى كثير من المناطق الريفية. فقد أنشأ روزفلت إدارة كهربية لإنجاز هذا العمل. وقد عملت هذه المصلحة على تأسيس تعاونيات كهربائية غير ربحية تتبع نظام الملكية العامة لتزويد الطاقة الكهربائية للمناطق التي لا تصلها الكهرباء. وعندما أسست إدارة كهربة الأرياف في العام 1935 لم تكن الكهرباء تصل إلا إلى مزرعتين من كل عشر مزارع في الولايات المتحدة. وبعد عقد ونيف ارتفعت النسبة إلى ثمان من كل عشر ، ولم يحدث ذلك زيادات هائلة في إنتاجية تلك المزارع ، (وبالتالي ارتفاع عدد العمال الذين تركوا أعمال المزارع والتحقوا بقطاعات الاقتصاد الأخرى) ، لكنه أدى بالمثل إلى ارتفاع مستويات المعيشة في المناطق الريفية ، وقرب وشائج العلاقة بين سكانها وسكان المناطق الأخرى عموما بفضل وسائل مثل المذياع والهاتف الذي ستمد أسلاكه على الا‘مدة نفساه التي مدت عليها أسلاك الكهرباء.
لقد بدأت الاحتنياطي الفدرالي في العام 1937 – بالاستفادة من الصلاحيات التي منحت له أخيرا – في رفع متطلبات الاحتياطي لدى الصمارف لجملة من الأسباب الموجبة. وفي الوقت نفسه بدأت إدارة روزفلت تقلص الانفاق على الأشغال العاتمة بغية الوصول بالميزانية إلى نقطة التوازن. لكن ذلك أحدث كسادات جديدا. فارتفعت البطالة إلى سابق عهدها عند 19 في المائة في العام التالين ، وهبط الناتج القومي الإجمالي بنسبة 6.3 في المائة . ولأول مرة في تاريخ الاقتصاد الأمريكي ، ولأخر مرة حتى ذلك الحين تتراجع ذروة الدورة التجارية عن ذروة الدورة السابقة ، حيث كان أعلى مستوى بلغته الدورة التجارية في العام 1937 يقل كثيرا عن ذلك المسجل في العام 1929.
صحيح أن الاقتصاد كان يمر – بلغة الاقتصاد – بفترة إنتعاش لسنوات أربع ، فإن كلمة "كساد" في التعبير الشائع كانت تطلق على عقد الثلاثينيات برمته. لذلك فقد أطلق الاقتصاديون على هذا الكساد الجديد الذي وقع في فترة كساد سابقة اسم "الركود". ومنذ ذلك الحين باتت هذه الكلمة تستخدم في وصف تراجع الأداء الاقتصادي ، وصارت كلمة كساد تكتب باللغة الانجليزية بحرف كبير Depression لتغني حصرا عن فترة عقد الثلاثينيات.
وبدأت الانتعاش من جديد في العام 1938 ، لكن البطالة ظلعت عند مستوياتها الحادةو إذ بلغت 14.6 في الماتئة في العام 1940. وإذا لم يكن البرنامج الجديد – بموجز القول – هو الحل الشافي للاقتصاد الأمريكي العليل ، فقد كانت لاحرب هي السبيل إلى تعافي الاقتصاد. فالسلام الرهيب الذي أقر في فرساي في العام 1919 ثبت أنه لم يكن سلاما على الإطلاق ، بل مجرد هدنة استمرت عشرين عاما ، فترة فاصلة بين أسوأ حرب في تاريخ البشرية وحرب ستفوقها فظاعة من حيث عدد الضحايا والأموار المبددة.
وكما كانت أول حرب كبرى عرفها القرن العشرين الغارق في الدماء ، عندما توقف هطل القنابل ، فإن القوة الجيوسياسية سيعاد ترتيبها لما فيه مصلحة الولايات المتحدة.
الجزء الخامس: ثورة اقتصادية جديدة
ضوابط زمن الحرب: 1941-1945
استخدم فرانلكين روزفلت – في إحدى خطبه في الإذاعة المسائية في 29 ديسمبر – لأول مرة عبارة ستبقى في ذاكرة التاريخ ، عندما طالب الولايات المتحدة بأن تتحول إلى "ترسانة الديموقراطية العظيمة".
لقد اندلعت الحرب في اوروبا في 1 سبتمبر 1939 ، بعد أن اجتاحت القوات الألمانية بولندا ، وهبت فرنسا وبريطانيا ، وفاء بعهودهما – إلى ندجدة بولندا. وكان قليل من الأمريكيين عارفا بحقيقة الانحطاط الفكري الذي انحدر إليها النازيون ، لكن الرأي العام في الولايات المتحدة كان مجمعا على الباقي إلى جانب الحياد في هذا الصراع . كما أن كثيرا من الصحف – من "ألديلي ووركر Faily Worker" الشيوعية ، إلى تلك التي يملكها ويليام راندولف هيرست – التزم الحياد . هذه الانعزاتلية كانت جلية في القوانين أيضا، وبصور شتى. ففي العام 1934 وقع عضو مجلس الشيوخ حيرام جونسون من كاليفورنا مشروع قانون يحظر على الخزانة تقديم قروض لكل الدول التي تلكأت في سداد مستحقات قروضها السابقة. وقد اشتمل هذا بالطبع على بريطانيا وفرنسا. وفي 4 نوفمبر 1939 أقر الكونجرس قانون الحياد الذي سمح بشراء الذخيرة من الولايات المتحدة على أساس الدفع النقدي والتسلم الفوري.
بعد ذلك بسبعة أشهر سقطت فرنسا في أيدي النازيين ، وظلت انجلترا وحدها. وقد ثبت في العام 1940 عجز أملانيا عن إلحاق الهزيمة بالقوة الجوية الملكية (البريطانية) في معركة بريطانيا ، وهكذا كسبت بريطانيا التفوق الجوي اللازم لإحباط تقدم القوات الألمانية عبر القتال الإنجليزي. لذلك حاولت ألمانيا أن تكره بريطانيا على الاستسلام بهجوم خاطف وقطع خطوطها التجاترية عبر الأطلسي. وأوشك ذلك أن يحقق الغاية المنشودة. وقد لخط هذا الوضع ردياترد كيبلنج قبل عقود خلت بقوله:
إن الخبز الذي تأكله ، والبسكويت والحلويات التي تقضم ، واللحم الذي تلوك. نأتيك بها كل يوم ، نحن البواخر العظيمة. وإن سد علينات أحد طريقنا. فإنكم جميعا ستتضورون جوعا!
وبينما كانت البحرية الملكية تفوق في حمولتها الملكية الكلية حمولة البحرية الألمانية ، فإنها لم تكن تضاهيها في عدد المراكب الحامية التي كانت تواكب السفن وتحميها من هجمات الغواصات الألمانية. وفي 15 مايو 1940 تحدث رئيس الوزراء الجديد – وينستون تشرشل – بصراحة تعوزها اللياقة الدبلوماسية عن متطلبات بريطانيا من الولايات المتحدة إذا ما أريد لبريطانيا ألا تخسر الحرب ، ودون المتطلبات العاجلة وهي: "أولا ، إعارتنا أربعين أو خمسين مدمراتكم القديمة. ثانيا: نحتاج إلى عدة مئات من أحدث الطائرات. ثالثا: أجهزة وزخيرة مضادة للطائرات. رابعا: نحتاج إلى شراء الفولاذ من الولايات المتحدة. ويسري ذلك على الأعتدة الأخرى. وسندفع مالا بقدر استطاعتنا ، لكن يجب أن تعطوني ضمانات كافية بأنكم ستزودوننا بما نحتاج إليه وبالشروط نفسها حتى إذا عجزنا عن دفع المال إليكم".
لقد أدرك روزفلت التحديات الكامنة التي ستواجه أمن أمريكا نفسها ، كان يعلم أن ألمانيا لم تكن تمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة ، التي تقبع آمنة خلف مياه المحيط الأطلسي الشاسع ، لكنه أدرك أيضا أن انتصار الدولة النازية وتبوؤها زعامة العالم القديم لتضع يدها على موارده الاقتصادية والبشرية كلها سيفرض تهديدا بالغ الخطورة على أمن العالم الجديد وحريته في المستقبل القريب. وشعر الرئيس بضرورة أن تظل بريطانيا منيعة لمدة كافية لكي تذب النازيين عن الولايات المتحدة العزلاء ، وقد نجح في تعريف الشعب الأمريكي كلمه بمكامن مصلحته الحقيقية.
ومثل الرئيس – في اليوم التالي من تسلم خطاب تشرشل – أمام جلسة مشتركة للكونجرس وطلب تخصيص مبلغ إضافي قدره 1.3 مليار دولار لميزانية الدفاع ، ويعتبر ذلك زيادة كبيرة جدا في الموازنة الفدرالية الإجمالية لذلك العام. كما طلب إنتاج 50 ألف طائرة سنويا.
كانت القوات العسكرية آنذاك متواضعة عددا وعدة. ولم يكن الجيش يضم أكثر من ثلاثمائة ألف مقاتل – أصغر من جيش يوغسلافيا – وكان يعاني نقصا كبيرا في الأسلحة ، حيث كان المجندون الجدد يضطرون إلى الحفر بعصى المكانس بدلا من البنادق. كما كان عتاد الجيش قديما جدا مما حمل رئيس الأركان اللواء جورج سي مارشال على اعتبار الجيش أسوأ حالا من "جيش قوة عظمى من الدرجة الثالثة". كما أن البحرية – التي كانت تضارع البحرية البريطانية حجما – كانت تفتقر إلى الذخيرة اللازمة لمواصلة القتال ، وكان كثير من عتادها متقادما أو لا يعول عليه.
وفي 16 سبتمبر 1940 وافق الكونجرس على أول تجنيد إجباري زمن السلم في التاريخ الأمريكي ، وسجل 16.4 مليون رجل تتراوح أعمارهم بين العشرين والخامسة والثلاثين. ودعا القانون الصادر إلى تدريب 1.2 مليون جندي و800 ألف جندي إحتياطي في العام التالي. لكنه نص أيضا على ألا تؤدى الخدمة العسكرية خارج منطقة نصف الكرة الغعربي ، وألا تزيد مدة الخدمة على اثنى عشر شهرا.
كان كسب موافقة الكونجرس والشعب على اتخاذ إجراءات هادفة إلى رفع مستوى الأهمية العسكرية للبلاد أسهل من تأمين الموافقة على تقديم العون إلى بريطانيا. لقد وافق روزفلت – على الرغم من المخاطرة السياسية التي كانت ستحيق به، خصوصات أن أشهرا معدودات كانت تفصله عن انتخابات العام 1940 – على إرسال خمسين مدمرة إلى بريطانيا العظمى مقابل تأجير بريطانيا للولايات المتحدة عددا من القواعد على أراضيها التابعة لها في العالم الجديد لمدة خمسين عاما. والأهم من ذلك ، فقد بدأ روزفلت صياغة استراتيجية "المساعدة بل خوض الحرب" ، قدمها للشعب كأفضل سبيل لتجنب الإنخراط في الحرب.
وحتى قبل حديث روزفلت عن "ترسانة الديموقراطية" كانت الأحوال المالية لبريطانيا تزداد حرجا . فقد شارفت احتياطيات بريطاينا من الدولار والذهب على النفاد. وفي طريق عودته من بريطانيا في 23 نوفمبر بدا سفير بريطانيا – اللورد لوثيان – خارجا عن الأصول الدبلوماسية – ولنقلها بلهجة مهذبة – بصورة فظة عندما أبلغ الصحافين الذين استقبلوه عند الطائرة: "حسنا يا شباب ، لقد أفلست بريطانيا ، إننا نبغي أموالكم". وفي خطابة عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس في 6 يناير 1941 ، أعلن روزفلت أن سياساته منصبة على حماية الحريات الإنسانية الأساسية: حرية التعبير والدين والأمن من الخوف والفاقة. واقترح ما بات يعرف بقانون "الإعارة والتأجير". وبعد شهر من ذلك التاريخ سيصف تشرشل بألمعية ودعاء اقتراح قانون "الإعارة والتأجير" بأنه مسألة" أعطنا الأدوات اللازمة .. وسننهي العمل بأنفسنا". كان تشرشل قد تحدث عن ذلك قبل أيام قلائل بكلمات أقرب قليلا إلى الواقع ، لكنها لم تقل دهاء ، حيث مثل بإقراض جاره الذي يحترق منزله خرطوم إطفاء ، ليعيده بعد أن يخمد الحريق.
وأقر الكونجرس – بعد جدل كبير – قانون "الإعارة والتأجير" في 11 مارس بتخصيص مبلغ 7 مليارات دولار. وفي نهاية الحرب ، ستصل قيمة تخصيصات الإعارة والتأجير إلى 50.226.845.387 دولارا. وقد نعته عملا قصد منه تحقيق المصلحة الشخصية لبلد كان واعيا تماما بما أقدم عليه. إذ لم يساعد على هذا الصنيع الحلفاء على الإنتصار في مقارعة ألمانيا واليابان فقط ، ولكن لم يترتب عليه أيضا دين هائل يستحيل أداؤه وقد يعيث حركة أمريكا في عالم ما بعد الحرب ، كما كانت حال ديون الحرب العالمية الأولى في العقود السابقة.
كانت بريطانيا لا تزال تعاني نقصا حادا في السفن الحامية ، وقد تكشفت في معركة الأطلسي عن بوادر رجحان كفة ألمانيا في العام 1941 ، وبعد أن حاصره الرأي العام والقيود التي اعتمدها الكونجرس ، عمل روزفلت على الالتفاف حولها والمناورة. إذ بما أن السفن الحربية الأمريكية لم تهاجم الغواصات الألمانية ، فإن الاستطلاعات العسكرية الأمريكية – بالطائرات والسفن – كانت ترسل تقاريرها إلى البريطانيين. وفي مناورة سياسية بارعة – وإن كان مشكوكا فيها من المنظور الجغرافي – التف روزفلت حول القيود التي أعاقت نشر القوات العسكرية الأمريكية خارج نصف الكرة الغربي بإعلانه أن جرينلاند وآيسلاند جزء من نصف الكرة الغربي ، فاقام قاعدة جوية للمراقبة فيها.
ورويدا رويدا انخرطت الولايات المتحدة في دوريات الأمن التي هدفت إلى حماية المعابر البحرية في المحيط الأطلسي ، وتعرضت المدمرة الأمريكية يو إس إس جرير للهجوم في مياه آيسلاند في 4 سبتمبر ، وأغرقت المدمرة روبين جيمس بطوربيد ألماني في 30 اكتوبر . وظلت سياسة الحياد نهجا أساسيا للسياسة الأمريكية . وفي 18 اغسطس أجاز الكونجرس تمديد قانون الخدمة الاختيارية بأغلبية صوت واحد فقط (203 أصوات مقابل 202).
لقد غابت سياسة الحياد والإنعزالية عن العرف السياسي الأمريكي صبيحة يوم الأحد 7 ديسمبر 1941 ، عندما أغارت الطائرات اليابانية على الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي في قاعدة بيرل هاربور وحولتها إلى أنقاض. وفي اليوم التالي أعلن الكونجرس الحرب على اليابان. وفي يوم الخميس 11 ديسمبر أعلنت ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة.
وعاثن القوات المسلحة اليابانية فسادا في المحيط الهادي طوال الأشهر الستة التالية. فاستولت على هونج كونج والفلبين ومالايو وسنغافورة وجزر سليمان والهند الشرقية الهولندية وبورما ، وتوعدت أستراليا والهند بتهديداتها. وفي المحيط الأطلسي ، أغرقت الغواصات الألمانية عددا من البواخر الأمريكي قبالة الساحل الشرقي (مستخدمة الأضواء الكاشفة على طول خط الساحل لإبهار الضحايا المستهدفين ، قبل أن تفرض ضوابط التعتيم الشامل). وفي شمال أفريقيا ، دحرت القوات الألمانية القوات البريطانية حتى قناة السويس ، التي كانت نقطة استراتيجية حيوية تسهل بها السيطرة على البحر المتوسط وقطع إمدادات نفط الشرق الأوسط عن النازيين. وفي الاتحاد السوفيتي ، توغتل القوات الألمانية عميقا في الأراضي الروسية.
لقد وفر المخزون البشري الهائل لدى الولايات المتحدة وروسيا والإمبراطورية البريطانية كل حاجة الجيوش من المقاتلين . وإن انتصار الولايات المتحدة وحلفائها – الواقعيين تحت ضغوط هائلة – سيعني أن أمريكا ستكون حقا "ترسانة الديموقراطية".
وهذا ما كان ، في واحدة من أعجب المآثير في التاريخ الاقتصادي ، ففي الأشهر الستة الأولى من العام 1942 ، منحت الحكومة عقودا عسكرية تجاوزت قيمتها 100 ملوين دولار ، أي ما يزيد على الناتج القومي الإجمالي للعام 1942 كله. وفي سنوات الحرب ، أنتجت الصناعة الأمريكية 6500 سفينة حربية ، و296400 طائرة ، و86330 دبابة و65546 صندل إنزال و3.5 مليون سيارة جيب وشاحنة وناقلة أفراد ، و53 مليون طن ساكن من ناقلات الشحنت ، و12 مليون بندقية وقربينة ومدفع رشاش ، و47 مليون طن من قذائف المدفعية ، إضافة إلى ملايين الأطنان من البذل والأحذية العسكرية والمواد الطبية والخيام ، وكثير من المعدات الأخرى اللازمة للحرب الحديثة.
وأنتجت شركة فورد موتورز وحدها من الذخائر الحربية أكثر مما أنتجه الاقتصاد الإيطالي كله. وبحلول العام 1944 كانت مصانع الشركة تنتج قاذفات بي 24 ، بمعدل واحدة كل ثلاث وستين دقيقة. إن هنري جيه كايسر – الذي لم يعرف بادئ الأمر كثيرا عن السفن ، حيث كان يسمي مقدمة السفينة ومؤخرتها: الواجهة والخلفية – سينقل تقنيات الإنتاج الجماهيري المطبقة في صناعة السيارات ليوظفها في صناع السفن . وقد قلص الزمن اللازم لبناء سفينة ليبرتي (وهي سفينة شحن قياسية قادرة على حمل سبعة آلاف ومائتي طن و30 ألف قطعة من 224 يوما إلى 42 يوما). وبلغد عدد السفن الإجمالي المنتج زمن الحرب 2710 سفن كانت كل منها على حد وصف روزفلت "عونا للذود عن حرية شعوب العالم الحرة".
وفي مؤتمر طهران ، الذي انعقد في العام 1943 ، قدم جوزيف ستالين – من بين كل الحاضرين – نخب احتفاء ب"الانتاج الصناعي الأمريكي" ، الذي لولاه لخسرنا الحرب".
لقد أنجزت الولايات المتحدة هذه المرة المأثرة الصناعية "الملحمية" بتحويل أكبر اقتصادات العالم الرأسمالي إلى اقتصاد مخطط مركزيا ، بين عشية وضحاها ، إذا جاز القول. لقد ثبت عدم نجاعة التخطيط المركزي على الإطلاق في إنتاج السلع والخدمات الاستهلاكية (وذلك في المقام الأول لأنه ليس للمستهلكين من اعتبار في تحديد ماهية المنتج وشكله) ، لكن التخطيط المركزي أعطى نتائج أفضل في إنتاج العتاد الحربي.
وعندما تحرك الرئيس أول مرة لينتقل بالاقتصاد إلى حالة الحرب ، اعتمد على خليط ألفبائي من الأسماء التي اشتهر بها البرنامج الجديد. لقد ظهر في العام 1941 إلى حيز الوجود اللجنة الاستثمارية للدفاعه الوطني NDAC ومكتب إدارة الإنتاج OPM ومجلس الاعتمادات المالية والأولويات والتخصيص SPAB ، لكن هذه المؤسسات افتقرت إلى التنسيق اللازم بعضها مع بعض. كما أن البحرية والجيش (وظلت القوات الجوية تابعة له حتى العام 1947) ظلا يعتمدان إدارات تموين مستقلة ، وسارا أحيانا على أهداف متعارضة ، وقاوما بشدة كل تدخل خارجي في شؤونهما من هيئات الحكومة الأخرى. وبدخول الاقتصاد الأمريكي آخر المطاف في طور الازدهار من جديد (تراجعت البطالة إلى ما دون 10 في المائة في العام 1941 لأول مرة منذ العام 1931 ، وظلت تتراجع معدلات سريعة طوال العام) لم تكن الشركات الأمريكية تلقي بالا للاستجابة لإملاءات الحكومة في واشنطن.
وبعد حادثة بيرل هاربور أدرك الرئيس أن ثمة حاجة إلى انتهاج مسار جديد. وفي مطلعه يناير 1942 استدعى دونالد نيلسون ، الذي كان يشغل منصب مدير أولويات الإنتاج في مكتب إدارة الإنتاج . وقد عمل نيلسون قبل ذلك نائبا للرئيس التنفيذي لشركة سيرز روبيك Sears Roebuck ، وكان يحقق دخلا سنويات قدره 70 ألف دولار. وانتقل نيلسون إلى العمل الحكومي لقاء دخل سنوي لا يتجاوز 15 ألف دولار. ونقل روزفلت إلى نيلسون أنه يعهد إليه بتنظيم الإنتاج الحربي ، فكان جوابه: "سأفعل إن عينت رئيسا له" ، وتعهد الئيس له بالقول: "فوضتك أن تفعل ما تشاء".
واستعرض نيلسون والرئيس ونائب الرئيس – هنري والاس – شكل الوكالة الجديدة التي ستضطلع بوظائف ومهما الوكالات السابقة. واقترح نيلسون تسميتها "إدارة الإنتاج الحربي War Production Administration ، لكن روزفلت أدرك فجأة أن حروف اسمها الأولى ستكون WPA فارتأى استخدام اسم بديل هو "مجلس الإنتاج الحربي WPB".
وقفل نيلسون عائدا إلى مكتبه وحرر أمرا إداريا قضى بتشكيل مجلس الإنتاج الحربي وتخويله الصلاحيات التي رأى أـنها ضرورية لجعل الاقتصاد الأمريكي "آلة حرب" ، ومنحه بصفته رئيسا للمجلس السلطات اللازمة لتحقيق الكفاءة والفعالية البيروقراطية (المكتبية) لهذا المجلس. ووقع الرئيس الأمر وبات دونالد نيلسون – بقليل من المبالغة – "الرئيس التنفيذي الأول" للاقتصاد الأمريكي.
وكان خير رجل لهذا المنصب. لقد حصل نيلسون – الذي ولد في العام 1888 في هنيبال بيمسوري – على إجازة الهندسة الكيميائية ، وسعى إلى نيل درجة دكتوراه فلسفة في هذا التخصص، لكنه انتقل إلى العمل كيميائيا لدى سيرز روبك ، وبقى في عمله هذا على مدى ثلاثين عهاما. ثم انتقل بعدها ليعمل في المجال الإداري وشرع في ارتقاء السلم باطراد.
وفي عقد الثلاثينيات من القرن العشرين ، ملاأت شركة "سيرز" مخازنها محالها بأكثر من مائة ألف صنف من البضائع ، وكان البيع يتم عبر كتيبات القوائم (الكتالوجات). بدءا من دبابيس القبعات إلى البيوت مسبقة الصنع. إحدى الطرق التي تروى عن فرانلكين روزفلت قوله إن السبيل إلى إقناع الاتحاد السوفيتي بتفوق النظام الرأسمالي هو إغراقه بكتالوجات سيرز روبك. كانت مهمة نيسلون في سيرز طوال سنوات أن يقف على الأصناع المطلوبة في تجارة التجزئة والبيع بالكتالوج ، وتحديد باعتها أو صانعيها بأفضل الأسعار ، والتأكد من أن السلعة انتهت إلى حيث الطلب عليها في وقت الحاجة إليها. كان هذا أفضل فرص التدرب على عمله الجديد كرئيس لمجلس الإنتاج الحري ، ذلك أنه اكتسب معرفة لا تضاهى بحجم الصناعة الأمريكية وعمقها ونطاقها.
كان لنيسلون في عمله في مجلس الإنتاج الحربي ثلاث أولويات أساسية ، أولا، أن يتعرف من المصالح الخدمية ومن الحلفاء على المتطلبات اللازمة لكسب الحرب. ثانيا، كان عليه تحزين المواد الأولية التي كانت بيد الدولة ، إضافة إلى المصادر الصناعية فهيا. أخيرا، الخروج بالطرائق الكفيلة بردم أي هوة قد تنشأ بين العرض والطلب.
وقد كان أكبر نقص حاد في فترة الحرب هو نقص مادة المطاط. إذ أن أكثر ما يعرض منه يأتي من المزارع التي تقع في مستعمرات بريطانيا في جنوب شرق آسيا. لكن هذه الحال انقلبت كلية بعد الزحف الياباني في آسيا. وهكذا أحييت صناعة المطاط البري ، وكان موطنه الأصلي غابات الأمازون المطرية – وهي صناعة دمرت في مطلع القرن بفعل انتشار المزارع – وزرع في الولايات المتحدة كثير من النباتات المنتجة للاتكس (اللثي) الصالحة للزراعة في أراضيها. وهكذا حل المطاط الصناعي "مشكلة النقص الحاد في المطاط". وفي العام 1939 لم تنتج الولايات المتحدة سوى القليل جدا من هذه المادة. أما في العام 1945 فقد أنتجت شركة دوبون وشركات أخرى 820 ألف طن. ومع أن هذه الكميات لبت المتطلبات الماسة للحرب ، لكن لم يبق إلا القليل منها للاستخدامات المدنية ، إذ ما كان المطاط متوافرا تقريبا. وستبقى سنوات الحرب طويلا في الذاكرة على أنها العصر الذهبي لإطارات المشقوقة وأنابيب الإطارات المطاطية المرقعة.
كانت الإطارات أول منتج يجرى تقنين تجارته ، بعد ثلاثة أسابيع من حادثة بيرل هاربور ، حيث خلت الأسواق من بعض المنتجات المطاطية على مدى فترة الحرب. وكان هذا أيضا حال معظم السلع الصناعية ، مثل الثلادات والسيارات. وبالفعل فقد أنتجت صناعة السيارات الأمريكية بين العامين 1943 و1945 سبعا وثلاثين سيارة فقط. وبنهاية الحرب ، وضع ثلاثة عشر برنامجا لتقنين الاستهلاك قيد التنفيذ ، اشتملت على السلع كالبنزين والسكر والبن والزبدة والدهون والزيوت واللحم الاحمر والأحذية. لكن هذا التقنين لم بالشدة التي كان عليها في بريطانيا ، وقد كانت مضطرة إلى استيراد كثير من السلع – إلى جانب تلك التي تقدمت – عبر خطوط إمداداتها في المحيط الأطلسي.
كان أصعب عمل واجه دونالد ديلسون من الناحية السياسية تحديد أولويات الإنتاج: ما يجب إنتاجه أولا وما يمكن تأخير إنتاجه إلى المستقبل. كانت القوات الجوية ترغب في الحصول على نوع معين من الطائرات ، بينما كانت القوات البحرية تحبذ نوعا آخر ، وكلاهما كان في حاجة إلى الطائرات "فورا". ولم يكن ثمة ما يكفي من الألومونيوم في أيام الحرب لإنتاج الطائرات المطلوبة. وكان نيلسون مسؤولا عن الاختيار بين من يقدم ومن يؤخر.
وكان مجلس الإنتاج الحربي مكونا من عدة "فروع صناعية" كل منها مسؤول معني بصناعة ما ، ومكلفا بمعرفة حجم إنتاج كل مصنع في ذلك الفرع الصناعي بدقة ، والصنف قيد التصنيع والتزامات الإنتاج المستقبلية ، وحجم المخزون لدى كل فرع. كانت هذه المعلومات ترسل إلى أقسام مجلس الإنتاج الحربي المعنية بكل قرارات إدارة المواد والتخصيصات والإنتاج والشراء. عند هذا المستوى الإداري كانت المفاضلة تتم بين طلبيات المعدات والذخائر والموافقة عليها وإعطائها الأولوية اللازمة وإرسالها إلى المصنع المكلف بإنتاجها مشفوعة بما تحتاج إليه من المواد الأولية المطلوبة. ومع نهاية العام 1942 صار مجلس الإنتاج الحربي أكبر الإدارات البيروقراطية في واشنطن زمن الحرب ، إذ بلغ عدد موظفيه خمسة عشر ألفا. وكان يستهلك في اليوم الواحد من الورق ما يعادل ما تحتاج إليه دار للصحافة متوسطة الحجم.
بلغ الإنتاج القومي الإجمالي في العام 1940 نحو 99.7 مليار دولار. وفي العام 1942 ارتفع إلى 211.9 مليار دولار. وعليه ، وحتى إن أخذنا أثر التضخم (وقدره 25 في المائة) زمن الحرب بعين الإعتبار (بقى التضخم تحت السيطرة بفضل قيود وضوابط الأجور والأسعار زمن الحرب) فقد حقق الناتج القومي الإجمالي نموا بنسبة 56.3 في المائة.
في غضون ذلك ، اختفت البطالة تقريبا. ذلك أن انخراط 20 في المائة من المواطنين الذكور في الحرب ، أدى أن شغلت النساء ملايين الأعمال الصناعية ، وصرن يعرفن بمجموعهن باسم "روزي عاملة البرشمة Rosie the riveter". وفي نهاية الحرب باتت النساء بشكلن ثلث اليد العاملة الأمريكية ، ولم يكن ثمة عمل لم تشغله المرأة ، بدءا من عمل رعاة البقر إلى الحطابين (كان يطلق عليهن تندرا اسم الحطابات ). واستجابة لبعض الضغوط الحكومية أول الأمر ، وفرت الشركات الصناعية للنساء تدريبا ، وهن على رأس عملهن في اختصاصات كانت حكرا في السابق على الرجال ، مثل أعمال اللحام وتشغيل الرافعات.
كما أذكت الحرب كثيرا من هجرة عائلات السود من الجنوب إلى المناطق الصناعية الشمالية ، التي بدأت خلال فترة الحرب العالمية الأولى. وستخلف هاتات الظاهرتان – وهما من تبعات الضرورة الاقتصادية للحرب – أثرا كبيرا في الاقتصاد الأمريكي ، وستتطلب إزالة هذا الأثر عقودا . لكنهما أحدثتا تغييرات جذرية في أوضاع هذه البلاد وأفضيتا – مرة أخرى – إلى تعظيم الفرص الاقتصادية التي باتت متاحة لشرائح واسعة من السكان.
وكشأن جميع الحروب الكبرى التي خاضتها البلاد ، ارتفعت إيرادات الحكومة ونفقاتها إلى مستويات هائلة ومزمنة. إذ لم يسبق أن تجاوت نفقات الحكومة 18.5 مليار دولار في عام واحد (1919) قبل الحرب العالمية الأولى. ومنذ الحرب لم تقل نفقات الحكومة عن 33 مليار دولار (ولم يتراجع الإنفاق الحكومي عن 60 مليار دولار في جميع سنوات أواخر الأربعينيات ومطلع الخمسينيات باستثناء خمس منها).
وارتفع الدين القومي كثيرا مع زيادة النفقات الحكومية ، إذ بلغ قبل الحرب 43 مليار دولار. وفي العام 1946 وصل إلى 269.4 مليار دولار ، أي ما يعادل 130 في المائة من الناتج القومي الإجمالي ، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ ذلك التاريخ وما قبله. ومن جديد اعتمدت حملات إصدار السندات على نطاق واسع وسيلة لتمويل الحرب. ولم يكتتب المواطنون – مع ذلك – إلا على ربع هذه السندات تقريبا . أما البقية فاشترتها المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى. وقد حازت المصارف التجارية أقل من مليار دولار من الأوراق المالية الصادرة عن الخزانة في العام 1941 ، وفي العام 1945 وصلت مشترياتها من هذه الأوراق المالية إلى نحو 24 مليار دولار.
لقد استطاعت الولايات المتحدة تمويل 45 في المائة تقريبا من كلفة الحرب عبر الضرائب ، وهي نسبة تتجاوز كثيرا نسبة التمويل بالضريبة زمن الحرب العالمية الأولى أو في فترة الحرب الأهلية . لقد أحدث قانون الإيرادات الضريبية للعام 1942 تحولات جذرية في النظام الضريبي الفدرالية ، فقبل العام 1942 كانت ضريبة الدخل تصيب الطبقة الوسطى وطبقة الأغنياء أساسا. وفي ذلك العام لم يتجاوز عدد المكلفين في الولايات المتحدة أرعبة ملايين إطلاقا. وفي العام التالي ، وبعد تخفيض الحد الأدنى للإعفاء الضريبي الشخصي من 1231 دولارا إلى 624 دولارا وصل عدد المكلفين إلى سبعة عشر مليونا ، حيث كانت تلك الضرائب تجبى "إبتداء من ضواحي النوادي الريفية وانتهاء بالتجمتعات المحيطة بخطوط السكك الحديد ، ثم إلى الجانب الآخر من تلك الخطوط". وفي نهاية الحرب ، وحصول أعداد متزايدة من الأمريكيين على وظائف دائمة ، وصل عدد المكلفين الأمريكيين إلى 42.6 مليون. ورفعت في غضون ذلك معدلات الضريبة على الدخول المرتفعة وبنسب كبيرة وصلت إلى 94 في المائة. ولأول مرة زادت متحصلات ضريبة الدخل الشخصية على متحصلات ضرائب دخل الشركات ، وبمقدار الضعف في نهاية الحرب.
وجلب قانون الإيرادات الضريبية للعام 1942 تحولا آخر كبيرا ومستداما في مجال ضريبة الدخل. كان هذا التحول الجديد هو الاقتطاع الضريبي. فحتى ذلك الحين ، كان الأفراد الذين تترتب ضرائب الدخل بذمتهم يرجئون سدادها إلى آخر العام. أما في ذلك الوقت فصارت الضرائب – بعد تقديرها – تقتطع من الراتب ، وهذا ما رفع كثيرا من سلاسة حركة التدفقات النقدية الداخلة إلى الخزانة ، وساعد أيضا – حالما بات الاقتطاع مألوفا – على تخليص الشعب من "حرقة الضريبة Tax bite".
وعلى الرغم من الزيادة العظيمة في الضرائب الفدرالية وأنظمة الرقابة الصارمة على الأجور والأسعار ، فقد كان المواطنون يعيشون فترة ازدهار اقتصادي غير مسبوق ، لكن توجيه قطاع كبير من الاقتصاد إلى الإنتاج الحربي ، لم يخلف سوى القليل مما يمكن شراؤه بعد تأمين ضروريات العيش . كان فائض الدخل يذهب إلى الإدخار. وبلغت المدخرات الشخصية في العام 1940 نحو 4.2 مليار دولار. وهذا ما كانت عليه أيضا في العام 1929 ، وفي السنوات الخمس التالية ، ارتفع حجم المدخرات الشخصية الإجمالي إلى مستوى قياسي 137.5 مليار دولار ، وانتهت هذه المدخرات إلى حسابات التوفير ووثائق (يوليصات) التأمين والسندات الحكومية ومدفوعات القروض. وإذا أنفق شيء من هذه المدخرات فكان يذهب إلى وول ستريت ، على الرغم من النمو الهائل في ارباح الشركات . وكانت ذكريات العام 1929 ومطلع الثلاثينيات لا تزال ماثلة في الأذهان.
ولولا تطبيق أنظمة ضبط الأجور والأسعار لكانت الشركات – نظرا إلى حاجتها الماسة إلى العمال – تنافست على اليد العالمة المتاحة من خلال إحداذ زيادات كبيرة في الأجور. ولأنها لم تكن قادرة على ذلك ، فقد تنافست فيما بينها في تقديم تعويضات عينية كان من أهمها على الأجل الطويل ، تأمين الاستشفاء.
ولم يكن التأمين الصحي معروفا من قبل إطلاقا ، ولقد وضع أول برنامج استشفائي في العام 1929 ، بعد أن وافق مشفى جامعة بايلور في ولاس – سعيا إلى رفع درجة سلاسة تدفقاته النقدية – على تقديم واحد وعشرين يوما كحدا أعلى من الرعاية الصحية للمرضى المقيمين ، وذلك لمجموعة من خمسائة معلم لقاء قسط تأمين سنوي قدره 6 دولارات. وانتشرهذا الشكل من التأمين سريعا ، وتحول بعد فترة قصيرة إلى برنامجي الصليب الأزرق (بلو كروس) والدرع الأزرق (بلو شيلد) اللذين سيهيمنان على أعمال التأمين الصحي لعقود مقبلة.
لكن هذا النموذج كان ينطوي على مشكلات عظيمة ، فمن ناحية انحصرت مزاياه في أوله ، كما يقال . أي إن تعويضاته تذهب إلى أولى نفقات الرعاية الصحية أو نفقات الإستشفاء وليس غلى آهر تلك النفقات. هذا البرنامج – بكلمة أخرى – كان يغطي تكاليف الأمراض العارضة (قصيرة الأجل) ، أما الأمراض المزمنة فلم تكن مشمولة به. كان هذا الشكل من التأمين شبيها بالتأمين على المسكن الذي تستحق تعيوضاته على نافذة مكسورة ولا تذهب إلى سقف خر من العاصفة. وفي العام 1929 - مع ذلك كانت الإقامة في المشفى واحدا وعشرين يوما تعد فترة طويلة جدا ، كما أن التكلفة اليومية للإقامة في المشفى تظل نفسها تقريبا مهما كانت شدة المرض. إلى ذلك ، فإن وثائق التأمين تلك وتعويضاتها تلبي متطلبات علاج الأمراض لا الوقاية منها.
وعلى العكس من التأمين العادي ، كان هذا النوع من التأمين يعوض المؤمن عليه عن قيمة "فاتورة" العلاج – مهما بلغت – بدلا من أن يدفع إليه شيكا بهذه القيمة ويترك له أن يختار بنفسه أفضل طرائق العلاج. وهذا ما جعل المرضى المؤمن عليهم غير مكترثين بالتكلفة المترتبة على العلاج ، التي تعتبر عنصرا مهما جدا في سوق حرة أريد لها أن تحقق أداء حسنا. كما أن هذه الوثائق (البوليصات) لم تكن تمنح التعويض ما لم يحصل المريض على العلاج من أحد المشافي ، وهذا أعلى ضروب الرعاية الصحية. لذلك وجد الأطباء أنفسهم تحت ضغوط اضطرتهم إلى قبول المرضى في المشافي بغض النظر عن إمكان علاجهم في العيادة أو المنزل وبتكلفة جد قليلة.
ولم يكن التأمين الصحي شائعا إطلاقا عشية الحرب ، لكنه بات من منافع العمل بالنسبة إلى ملايين العمال عند نهاية الحرب. وبعد الحرب ، حاولت مصلحة الضرائب فرض ضريبة على هذه المنافع الجمة (غير القليلة) ، لكن الكونجرس تدخل سريعا وطلب إلى مصلحة لاضرائب أن تعدها من جملة مصروفات الشركة المعفاة من الضريبة والمستقطعة من الدخل الخاضع للضريبة. مع ذلك فإن التأمين الصحي الذي يشترط فيه الأفراد لا يمنح مثل هذه الميزة الضريبية ، وبالتالي فقد كان ذلك خللا جسيما في سوق العمل ، في وقت كانت فيه أعداد متزايدة تتحول إلى العمل الحرب. وفي العام 1948 قضى مجلس علاقات العمل الونطي بأن المنافع والمزايا الصحية ستخضع للتفاوض الجماعي (بين العمال والإداري) ، وانتشر التأمين الصحي سريعا في قطاعات الاقتصاد الامريكي. وفي العام 1950 بلغ عدد المؤمن عليهم في برامج التأمين الصحي التي يتحمل تكاليفها رب العمل نحو 54.5 مليون شخص ، وهذا يتجاوز ثلث عدد السكان الإجمالي.
ومع انقشاع خطر الكارثة الاقتصادية ، ساعد التأمين الصحي كثيرا على تحسين مستوى حياة المؤمن عليهم. لكن نظرا إلى ظروف نشأتها الخاصة ، في وقت اقترنت فيه ولادة التأمين الصحي الأمريكي بالثورة الحاصلة في مجال الرعاية الصحية ، التي كانت تكتسب زخما متزايدا منذ ثلاثينيات القرن العشرين ، وانطلقت على أشدها في العقود التالية للحرب العالمية الثانية ، فإن مفرزاتها ستتبلور في مشكلة اقتصادية كبرى تحيق بالبلاد.
وفي 1 سبتمبر 1945 دخلت المدمرة يو إس إس ميسوري خليج طوكيو ، واستسلمت اليابان رسميا للحلفاء في اليوم التالي. ووضعت الحرب بذلك أوزارها. لقد تجاوز عدد ضحايا الحرب خمسين مليون إنسان ، ليسوا من القوات المتحاربة فقط ، بل – لأول مرة في تاريخ الحروب المعاصرة – من المدنيين ، وبأعداد فاقت كثيرا أعداد الضحايا العسكرييين. وكانت تكاليف الحرب أكبر من أن تحصى. لكنها لم تتوزع بالتساوي على القوى الكبرى المتحاربة.
وغرقت ألمانيا واليابان في حال من الدمار الواسع. وقد أطلق عليها هاري هوبكينز مساعد الرئيس ، وكان يحلق فوق برلين عقب الحرب مباشرة : "إنها قرطاجة هذا الزمان" . وتكبد الاتحاد السوفيتي – مع أنه قوي مركزه الجيوسياسي كثيرا – أكبر الخسائر البشرية ، وتحولت كثير من مراكزه الإنتاجية إلى قيعات خاوية بسبب الحرب . واستنزفت موارد بريطانيا وفرنسا العسكرية والمالية (ويشير أحد التقديرات إلى أن بريطانيا أنفقت ربع ثروتها القومية على الحرب). وستخسر فرنسا وإنجلترا إمبراطوريتهما الاستعمارية بعد حين.
أما الولايات المتحدة فإن أراضيها الشاسعة وقاعدتها الصناعية ظلتا مع ذلك بعديتين عن كل سوء. وقد تزايدت طاقتهما الانتجاية بمعدلات كبيرة ، وأصاب سكاتها الغنى والثراء. وبات اقتصادها آنذاك – وهو أكبر اقتصاديات العالم منذ ما قبل الحرب – ينتج 50 في المائة من الناتج العالمي الإجمالي. كان لدى الولايات المتحدة 80 في المائة من النقد الذهبي ، أما النسبة الباقية فكانت بمعظمها محفظوظة في خزائن أسفل مصرف الاحتياطي الفدرالي في نيويرك. وبموجب اتفاقية بريتون وودز ، التي أبرمت في العام 1944 ، سيغدو الدولار – وكان قابلا للتحويل إلى ذهب لدى المصارف المركزية – عملة الاحتياطي الأولى في العالم ومحور التجارة العالمية في المستقبل.
وصار الجيش الأمريكي أقوى جيوش العالم عدة وعتادا وثاني أكبر الجيوش بعد الجيش السوفيتي ، أما البحرية والقوة الجوية فكانتا تفوقان حجما ما لدول العالم كلها من قوات بحرية وجوية. وباتت تحتكر أخطر أسلحة الحرب التي يمكن أن يتخيلها البشر: القنبةل الذرية. ولم يسبق لأي بلد في التاريخ أن امتلك هذا التفوق العسكري والاقتصادي.
لكن الأهم من ذلك ، أن الحرب قد شحنت عزيمة الشعب الأمريكي ، تماما كشأنهم زمن الصراع المروع الذي انطوت عليه الحرب الأهلية قبل ثمانين عاما. وقد تسنى لهذا الشعب - الذي تكبد خسائر وصلت إلى 300 مليار دولار وأربعمائة ألف قتيل – أن يصون حريته وحريات أمم لا تحصى ، وأن يجلب الحرية لملايين البشر لأول مرة.
لقد اختفى من مفردات السياسة الأمريكية ذلك الخوف الذي دمر معنويات الأمة بعد أن جثم على صدرها في العام 1933 ، كما زالت النزعة الانعزالية والحيادية وباتت طي الماضي. وقد سلمت الولايات المتحدة آنذاك بالامر الواقع – أن قدرها قيادة العالم – لأنه لا أحد سواها قادر على ذلك ، وسيعتمد الأمن الأمريكي في المستقبل القريب على موقعها هذا في قيادة العالم.
الفصل الثامن عشر: الازدهار الكبير بعد الحرب
كانت لدى الاقتصاديين وأرباب التجارة تنبؤات عريضة بأن الاقتصاد الأمريكي ما بعد الحرب مقبل على مراحل كساد متعاقبة. وأن النفقات الحكومية الفدرالية ستتراجع بشدة (وقد تراجعت في الواقع بنحو الثلثين في السنوات الثلاث السابقة) ، وأن معظم الرجال والنساء العاملين في الخدمة العسكرية – وكانوا يعدون اثني عشر مليونا – سيندفعون إلى سوق العمل ويدفعون الأجور نحو الانخفاض ، والبطالة نحو الارتفاع. وقد ثبت أن للاقتصاديين كرات سحرية محجوبة عن الرؤية تماما ، إذ كانت أطول فترات ازدهار التاريخ الأمريكي على الأبواب.
وكانت الحكومة قلقة جدا من احتمال عودة الكساد. فتحركت في العام 1944 للحيلولة دون ذلك. وفي 22 يونيو من ذلك العام وقع الرئيس روزفلت مشروع حقوق المحاربي القدماء (وعرف رسميا بتعويض العسكريين) الذي أجازه الكونجرس بالإجماع. كان الغرض منه – من دون شك – مكافأة المحاربين القدماء نظير شجاعتهم وتضحياتهم التي كان لها الفضل في هزيمة ألمانيا واليابان. وفي الواقع ، كانت الغاية السياسية من هذا القانون إبطاء عودة المحاربين القدماء إلى سوق العمل. لقد قدم قانون حقوق المحاربين القدماء معونات سخية لكل المحاربين القدماء الذين سرحوا من الخدمة بشرف ، وكانت هذه المساعدات تشتمل على التعليم وتوفير المسكن في مرحلة الدراسة والمساعدة على شراء منزل ، وافتتاح مشروع تجاري خاص بعد انتهاء التعليم والدراسة.
ويحضرنا هنا "ناموس العواقب غير المقصودة" لتفسير النتائج الكارثية التي ترتبت على عمل تشريعي ، مثل قانون حظر المشروبات الكحولية Prohibition act – الذي اتخذ بحسن نية. لكن مشروع قانون المحاربين القدماء ، وربما كان ذا أثر لا بأس به في التخفيف من تدفق المحاربين إلى قطاعات الاقتصاد الأمريكي ، لم يفض في الواقع إلا إلى "عواقب غير مقصودة" ، وكان كل منها – إذا جاز القول – ذا أثر جد إيجابي في البلاد.
لقد سمح مشروع القانون لما لا يقل عن ثمانية ملايين من المحاربين القدماء بالحصول على المزيد من فرص التعليم في الكليات والمدارس الفنية ، وما كانوا لولا ذلك ليحصلوا عليها. فقد زاد كثيرا من نسبة السكان الحاصلين على شهادة جامعية. وفي العام 1950 منحت 496 ألف شهادة جامعية ، أي أكثر من ضعف عدد الشهادات الممنوحة قبل عقد من الزمان.
وبين العامين 1945و1952 أنفقت الحكومة الفدرالية 14 مليار دولار على الإعانات التعليمية للمحاربين القدماء ، ولكنها حققت مكاسب أكبر من بناء رأس المال البشري الذي سيمد اقتصاد ما بعد الحرب بالطاقات المحفزة. لقد ثبت أن مشروع قانون المحاربين القدماء – الذي عد من جملة قوانين الأشغال العامة – كان بمنزلة قنال إري للاقتصاد ما بعد الصناعي الجديد الذي إن كانت ملامحه لم تتضح آنذاك ، فدق اجتاز مرحلة النشوء والتشكل.
كما أطلق ذلك المشروع ثورة اجتماعية. فقد فتح الباب للوصول إلى وظائف رفيعة أمام كثير من شرائح الشعب الذي ما عرف مثل هذه الوظائف إلا نادرا ، وبذلك توسعت النخبة الاقتصادية في البلاد وتنوعت كثيرا ، بعد أن هيمنت عليها حملة الأسماء البريطانية أو الشمال غرب أوروبية. ولأن الأطفال في هذا البلد حصلوا – مع تعاقب السنين – على ضعف سنوات الدراسة التي عرفها أباؤهم ، فقد تواصلت هذه المكاسب جيلا بعد جيل. لا بل إن مزايا مشروع القانون المذكور قد طالت أيضا المحاربين القدماء الذين اشتركوا في حروب متعاقبة ، ومنها الحرب الباردة. وقد شكل هذا محركا لا يتوقف عن إنتاج رأس المال البشري والقدرة التكنولوجية طوال السنوات الستين الأخيرة ، وهذا ما أتاح لهذا البلد التربع على عرش اقتصاد المعلومات الجديد تماما ، كما هيمن ذات يوم على الاقتصاد الصناعي في العقود السابقة.
كما أحدث هذا القانون ثورة في قطاع الإسكان ، إذ كان الإسكان مشكلة تزداد تفاقهما في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين ، عندما لم تلب مشاريع الإنشاء الجديدة حاجة العائلات الجديدة إلى المساكن ، بمقدار ستمائة ألف وحدة سكنية. فالحرب قد جمدت أعمال الإنشاءات السكنية. وبنهاية الحرب عاد ملايين المحاربين وتزوجوا وأحدثوا طفرة في المواليد ، وصارت الحاجة إلى مساكن جديدة أكثر شدة وإلحاحا.
لقد تخيل كثير من أبناء جيل البرنامج الجديد أن المساكن التي ستقيمها الحكومة أو تشرف على بنائها في مجمعات الشقق السكنية ، إنما ستقام في مناطق أحياء الأكواخ المزالة كما كان شأن باركشستر في قطاع برونكس داخل نيويورك أو المساكن الخاصة التي شيدت بدعم حكومي مثل ستويفسانت تاون في مانهاتن ، التي ملكتها وأنشأتها شكرة ميتروبوليتان الأمريكية في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية ، لكنها لن تحقق ما كان مرجوا منها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، حيث ستتحول سريعا إلى أحياء أكواخ "سامقة" كانت أسوأ حالا من أحياء الأكواخ التي حلت محلها.
ونص قانون حقوق المحاربين القدماء على تقديم قروض عقارية باسم إدارة المحاربين القدماء ضمنت بموجبها إدارة المحاربين القدماء – أول الأمر – نصف قمية القرض العقاري بسقف لا يتعدى ألفي دولار. وعدل هذا السقف فورا مما أفسح المجال بضمان ما يصل إلى 25 ألف دولار أو 60 في المائة من قيمة القرض ، أيهما أقل. ولأن مخاطر الخسارة المترتبة على التخلف عن السداد لم تكن قائمة ، فقد رغب كثير من المصارف في تقديم قروض – من دون دفعات مقدمة – إلى المحاربين القدماء ، الذين ما كان عليهم إلا شراء المسكن فقط.
وقد ساعد هذا على ظهور مقاولين من أمثال ويليام ليفيت. عمل ليفيت مقاولا قبل الحرب ، فكان يشيد المساكن الواحد بعد الآخر ، كما كان شأن تشييد مسكن العائلة الواحدة دائما. لكنه رأى في القروض العقارية التي قدمتها إدارة المحاربين القدماء فرصة سانحة . وروي عنه فيما بعد قوله: "إن ثمة طلبا ، أما التمويل فتقدمه الحكومة ، فأين الخسارة بعد ذلك!؟".
واشترى 7.3 ميل مربع من حقول البطاطا في لونج آيلاند من ضواحي ناساو كاونتي. ووضع شقيقه ألفريد تصميمين ورئيسييين للمساكن: تصميم "مساكن المزرعة" وتصميم المسكان مثلثة السقوف Cape Code. وشيد في خمس سنوات 17500 واحدة سكنية لمساكن منفصلة (مساكن العائلة الواحدة) ، بعد أن أضفى على عملية التشييد طابعا صناعيا. ووفق ليفين فإن "ذلك لم يتطلب سوى قلب خط التجميع الذي عرفت به ديترويت. ففي خط التجميع ذاك كانت السيارة تتحرك بينما يقف العمال في أماكن عملهم ، أما في إنشاء مساكننا ، فإن العمال هم العنصر المتحرك ، حيث يؤدون العمل نفسه في مواقع مختلفة".
وهكذا أجرت أول دفعة من المساكن المشيدة لقاء 65 دولارا في الشهر ، وكان المسكن يباع بنحو 6900 دولار ، ثم ارتفع هذا السعر سريعا إلى 7990 دولار . وفي العام 1949 كان نصف تلك المساكن معروضا للبيع فقط. وكانت العائلة الواحدة تحصل ضمن مساحة قدرها "60X100 قدم" على منزل من حجرتين قائمة على بلاطة أسمنتية واحدة ، إلى جانب غرفة المعيشة والمطبخ والحمام. أما الحي فكان يضم مئات وآلاف المسكان القياسية . وكانت تلك المساكن – أول الأمر – خالية من الأشجار.
وكان المثقفون – بما عرف عنهم من عجرفة وتعال - راعبين خائفين. فقد وضع الناقد الاجتماعي جون كيتز كتابا – بات من أكثر الكتب مبيعا – بعنوان "صدع في النافذة الزجاجية". ندب فيه حقيقة أن سكان هذه الضواحي الجدية التي بدأت تنتشر في محيط المدن الأمريكية ، على غرار ليفيتاون ، "لم تكن لتعرف – ولن تعرف – كرامة العيش الرغيد الذي ألفه آباؤهم في مساكن العائلة الكبيرة المكونة من طابقين أو ثلاثة ، والتي كانت على ارتداد جيد – تفترشه "مرجات" خضراء – من شاروع تظللها الأشجار".
وبالطبع فإن أكثر الناس الذين انتقلوا للعيش في ليفيتاون وآلاف المدن الأخرى لم يعرفوا شيئا من قبيل ذلك ، وهم الذين ترعرعوا في شقق مكتظة داخل أبنية لا مصاعد فيها ، في ضواح لم تكن فيها سوى قلة من مرائب السيارات النائبة بعضها عن بعض. كانت هذه الضواحي الجديدة بالنسبة إلى هؤلاء "جنة تناسب إمكاناتهم المادية".
أما الأهم من الناحية الاقتصادية ، فهو أن هذا النمط الجديد من المساكن قد أتاح لملاييين العائلات الجديدة أن تحقق ما عجز عنه أسلافها: إمتلاك المساكن. فبدلا من دفع بدل الإيجار ، كانوا يؤسسون لشي يملكونه ، ومع ارتفاع دخل الأسرة مع الزمن واكتساب خبرة جديدة ، صار في مقدور تلك الأسر "المقايضة ودفع الفرق" مستفيدة من ملكيتها للمساكن القديمة في دفع مقدم المسكن الجديد. وهكذا ساعد القانون السابق ملايين الأسر على إمتلاك مساكن أفضل مما حلف به أسلافها ، إلى جانب عنصر آخر هو رأس المال ، أي الأصول أو الموجودات المالية التي باتت السمة المميزة للطبقة الوسطى في هذا البلد.
كما أن امتلاك الأسرة أصولا مالية سهل عليها سب الاقتراض. إذ كانت القروض المصرفية والحسابات القيدية حكرا على الأغنياء قبل الحرب العالمية الثانية ، أما الآن فقد باتت – وعلى نطاق واسع – من مسلمات الحياة اليومية. وفي العام 1951 خرج مصرفي يدعى ويليام بويل – وكان قد عمل لدى مصرف فرانكلين الوطني ، ومقره في قلب ضواحي لونج آيلاند العامرة – بفكرة بطاقة الائتمان. لقد أزال عن كاه التجار عبء ونفقات إدارة حساباتهم القيدية ، وأتاح للناس العاديين دفع ثمن مشترياتهم في متاجر ومحلات كثيرة ، ووفر للمصارف المصدرة أرباحا جيدة من خلال الفائدة التي تجنيها من الأرصدة غير المسددة.
وكشأن الأفكار اللامعة دائما ، انتشرت هذه الفكرة سريعا وأصبحت بطاقة الائتمان في الستينيات أمرا شائعا. وفي السبعينيات أسبغت ماستر كارد وفيزا على بطاقات الائتمان بعدا وطنيا ، ومن ثم – وسريعا – بعدا عالميا. وقد حلت اليوم بطاقات الإئتمان – وما تفرع منها ، أي بطقات الحسم الفوري – محل النقد في معظم المعاملات التجارية . وقد حقق الائتمان انتشارا هائلا واتكسب أهمية متعاظمة في الحياة اليومية ، حتى بات معظم الأمريكيين يحرصون كثيرا على الحصول على تقويم ائتماني جيد. إن انقطاع الائتمان عن المرء وما يعنيه من خسارة السبل الموصلة إلى السوق ، لا يختلف كثيرا اليوم عما كان يعرف في القرون الوسطى بالحرمان الكنسي.
وبالانتشار الواسع للضواحي الجديدة تناقصت أعداد السكان في كثير من المدن التي تحلقت حولها تلك الضواحي. وباستثناء نيويورك ، فقد تراجع عدد السكان في كل المدن التي خرجت منها أكبر فرق دوري كرة القاعدة (بيسبول) في العام 1950 ، أي تلك المدن التي تقبع في الزامية الشمالية الشرقية من البلاد ، وأحيانا بنسب وصلت إلى 50 في المائة في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. كانت أغلبية السكان الباقية من الفقراء والأقليات الذين تجاوزت حاجتهم إلى الخدمات قدرة المدن عن توفيرها. وفي بضعة عقود ، تجاوز عدد سكان الضواحي عدد سكان المدن في البلاد ، وأصحبت محط رجال السياسية الأمريكية.
وشرع المحاربون القدماء العائدون من الجبهة وعائلاتهم – وإن يكان بوقع بطئ أول الأمر – في الاستمثار في الأوراق المالية والعقارات.
وشهدت وول ستريت تراجعا حادا في التداول مقارنة بما عرفته أيام مجدها في أواخر العشرينيات ، فقد كان متوسط حجم التداول في العام 1929 يبلغ 2.5 مليون سهم في اليوم الواحد . وفي العام 1939 هبط دون مستوى مليون سهم. ولم تشهد وول ستريت حوادث هلع عن اندلاع الحرب في سبتمبر من ذلك العام ، بل – كما في أي موضع آخر – شهدت قبولا مترددا. وفي العام 1942 بلغ متوسط التداول مستوى مخيبا ، 455 ألف سهم ، بعد أن هبط مؤشر داو جونز الصناعي إلى ما دون 100 نقطة ، بينما تبين أنه سيكون المرة الأخيرة ، في ابريل من ذلك العام ، حتى في وقت كانت فيه أرباح الشركات تحلق ارتفاعا بعفضل طلبيات الحرب.
وبعد الحرب أيضا ترنحت الأسعار في وول ستريت دون مستوى النمو السريع الذي كان يحققه الاقتصاد. وفي 31 ديسمبر 1949 وصل مؤشر داو جونز إلى 200 نقطة ، أي ضعف ما كان عليه في العام 1940 ، على الرغم من أن الاقتصاد حقق نموا بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا ، وارتفعت أرباح الشركات بمعدلات أعلى. كانت بعض أسهم "الشركات الممتازة" تباع بأسعار لا تتجاوز أربعة أضعاف إيراداتها وتعود بأرباح موزعة أكثر من 8 في المائة. لكن ثورة في وول ستريت كانت تحت الرماد ، ثورة ستقلب وجه تجارة السماسرة والاقتصاد الأمريكي أيضا.
لقد دخل تشارلز ميريل – وهو من الجنوب – إلى وول ستريت في الثانية والعشرين من العمر ، في وقت قدر له أن يعيش أحداث هلع العام 1907. وأسس شركته في العام 1914، ودمج بعد عامين في شركة يمكلها إدموند لينش ليؤسس شركة ميريل لينش وشركاهما ، وأغفلت وثائق الشراكة "الفراغ" الفاصل بين الإسمين عرضا ، ومنذ ذلك الحين صار الفراغ الفاصل يغفل عمدا. وفي عشرينيات القرن العشرين شهد الحوادث التي ألمت بوول ستريت ، وحث زبائنه على الخروج من السوق وكان هو نفسه قد خرج من السوق كلية عندما وقع الانهيار.
وقد باع كرسيه في البورصة بعد أن تنبأ ، وكان صائبا ، بأن الكساد الذي بدأت يستشري في العام 1930 سيدون سنوات طويلة ، كما باع شركته إلى أحد بيوت السمسرة - إي إيي بيرس وشركاهم – وصار فيها شريكا محدود المسؤولية من دون دور فاعل في إدارتها. وأنفق معظم فترة الثلاثينيات في التقديم الاستشارات لعدد من متاجر السلاسل التي ساعد في الاكتتاب على أسهمها ، مثل ويسترن أوتو أند سيفواي Weastern Auto & Safe Way ، وبدأ يفكر في تطبيق تنقينات متاجر السلاسل في أعمال السمسرة.
كانت أكثر ركات السمسرة في وول ستريت آنذاك صغيرة وعائلية ، ولا تكترث بالعملاء الصغار. وكانت أعمال البحوث – وهذه حالتها – تفتقر إلى الطابع الرسمي النظامي في أحسن صورها ، ولم تكن سوى تجميع للشائعات من هنا وهناك . وفي العام 1940 صار ميريل شريكا أول في شركة إي إيي بيرس ، وهكذا وجد اسم ميريل لينش طريقه في وول ستريت. وشرع ميريل على الفور في إيجاد صيغة جديدة لأعمال السمسرة. وقد حصل طاقم علاقات العملاء في شركته (وبات يطلق عليهم ، الوكلاء المعتمدون) على تدريب شامل وزودوا بمعلومات كانت تجمع على يد قسم كبير للبحوث.
وبدأ في العام 1948 بنشر الإعلانات – وكان هذا عملا غير مسبوق في وول ستريت – لتعريف رجل الشارع بوول ستريت والفرص التي يمكن الوقوع عليها هناك. وقد عرضت الإعلانات كيفية شراء الأسهم وبيعها والمخاطر المترتبة على ذلك. كما كانت الإعلانات تأخذ أحيانا وجها سياسيا رزينا. فعندما أشار الرئيس ترومان – وكان مرشحا لفترة رئاسة ثانية في العام 1948 – بنبرة ديما غوجية إلى "صيارفة المال" رد ميريل بنشر إعلان. واعترف قائلا: "لقد أزعجنا أحد تكتيتكات الحملات الانتخابية.. كان ذلك عندما عرض على الملأ صورة غول أشعث يمثل أحد أباطرة المال في وول ستريت .. ويعلم ترومان كالآخرين أن ليس ثمة وول ستريت .. إنها أسطورة. فوول ستريت هي مونتجومري في سان فرانسيسكو .. والجادة السابعة في دنفر .. وشارع مارييتا في أطلنطا .. وفدرال ستريت في بوسطن .. ومين ستريت في واكو بتكساس .. وهي أي ركن في إندبدندنس وميسوري – المدنة التي ينحد منها ترومان – حيث يمضي أصحاب المدخرات لتوظيف أموالهم وشراء الأوراق المالية وبيعها".
وقد ألفحت فكرة ميريل في نقل نموذج وول ستريت إلى مين ستريت. ففي العام 1950 باتت شركة ميريل لينش اكبر بيوت السمسرة في الولايات المتحدة وتجاوز حجمها في العام 1960 أربعة أضعاف أقرب منافساتها ، فبلغ عدد حسابات العملاء لديها 540 ألفا ، وكانت تعرف في وول ستريت – برهبة يشوبها الحسد = "بالحشد الهادر". ولم يكن أمام بيوت السمسرة الأخرى من خيار آخر سوى تقليد نموذج عمل ميريل لينش. وبدأت الشركة العائلية – التي كانت تقدم خدماتها لقلة من العملاء الأثرياء – الانحسار عن وول ستريت.
وبينما ظل أولئك الذين استثمروا أموالهم مباشرة في الأسهم زمرة صغيرة نسبيا ، فقد زاد سريعا عدد أولئك الذين وظفوا استثمارات غير مباشرة. القرن العشرين (كانت شركة سيرز روبك استثناء عن القاعدة). لكن قانون واجنر أتاح لاتحادات العمال أن تتمسك بها في مفاوضاتها مع أرباب العمل ، واستحسن الفكرة عدد متزايد من إدارات الشكرات ، وبدأت تشيع سريعا في أوساط الشركات الأمريكية في أربعينيات القرن العشرين.
ونقل إلى علم تشارلز ويلسون – رئيس شركة جنرال موتورز – في عقد الأربعينيات (ثم وزير الدفاع في إدارة إيزنهاور) أن أموال تلك البرامج لو استثمرت في سوق الأسهم لأصبح العمال ملاكا لمشاريع الأعمال الأمريكية في بضعة عقود . فكان جوابه: "هذا تماما ما يجب أن يكون".
وفي عقد الخمسينيات صارت صناديق التقاعد – التي تسيطر عليها الشركات واتحادات العمال – طرفا رئيسيا في وول ستريت. وفي العام 1961 – عندما كانت الميزانلية الفدرالية لا تتجاوز 100 مليار دولار – حازت صناديق التقاعد غير الخاضعة للتأمين أسهما بقيمة 1704 مليار دولار ، وكانت توظف استثمارات جديدة بمعدل مليار دولار في العام. كما بدأت صناديق الاستثمار – التي ظهرت أول مرة في العام 1924 – تكتسب اهمية متزايدة في وول ستريت ، مع التفات الناس إلى الاستثمار في الأسهم العادية من دون أن يضطروا إلى اختيار الأسهم التي ينوون شراءها بأنفسهم. ولم تتعد قيمة الاستثمارات في هذه الصناديق 500 مليار دولار في العام 1940 ، ومع ذلك فقد تضاعفت قيمتها خمس مرات في عضون عقد واحد ، ووصلت في العام 1960 إلى 17 مليار دولار ، أي خمسة أضعاف قيمتها ايضا.
أخيرا ، بدأت السوق – وكانت قد هبطت كثيرا عن قيمتها الفعلية – في الارتفاع . وبلغت أعلى مستوى لها بعد الكساد في 13 فبراير عندما أغلقت عند 294.3 نقطة ، وهذا أعلى مستوى لها منذ ابريل 1930 ،وفي يونيووصلت إلى 330 نقطة. وفي آخر الماف ، تجاوزت في ديسمبر المستوى الذي بلغته في 3 سبتمبر 1929 عند 381.17 نقطة بعد أكثر من خمس وعشرين سنة ، وهي أطول فترة بين ارتفاعين قياسيين في مؤشر داو جونز منذ تأسيسه قبل 108 سنوات . وبذلك انتهى الكساد الكبير بشقيه النفسي والاقتصادي.
وقد ثبت أن كبرى المشكلات التي لازمت الاقتصاد في فترة ما بعد الحرب لم تكن البطالة بل التضخم. وعلى الرغم من الانخفاض في الناتج القومي الإجمالي في العام 1946 ، بعد تراجع الطلبيات العسكرية السنوية من 100 مليار دولار في مطلع العام 1945 إلى 35 مليار دولار بعد عام واحد ، فإن هذا الناتج عاد إلى الارتفاع في نهاية العام وحقق معدلات نمو قوية منذ ذلك الحين.
كان السبب – الذي يتضح بجلاء باستحضاره ومعاينته – الطلب الكبير الكامن على السلع المعمرة الذي ولدته الحرب. إذ لم تصنع في زمن الحرب أي سيارات أو أدوات منزلية ، ولم تشيد مساكن جديدة . كانت تلك المستعملة قد قاربت نهاية عمرها الإنتاجي ، أما الطلب فقد كان يفوق كثيرا ذلك المستوى. كما أن كتلة المدخرات الشخصية الهائلة التي تراكمت في زمن الحرب كانت توفر ثمن السلع المطلوبة.
لكن البلاد كانت تتطلب وقتا للانتقال من الإنتاج الحربي إلى إنتاج السلع الاستهلاكية ، في وقت أدى فيه الضغط السياسية ، الذي لا ينثني ، إلى وقف العمل بأنظمة ضبط الأجور والأسعار قبل أوانه في العام 1946 ، وأدى ذلك إلى تضخم جامح ، وكان أعلى مستوى تبلغه البلاد في تاريخها زمن السلم حتى ذلك الحين ، وذلك مع زيادة الإنفاق الحكومية بنسبة 40 في المائة من دون حدوث ارتفاع مقابل في عرض السلع . وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 12 في المائة في شهر واحد ، وفي نهاية الحرب كانت قد تجاوزت نسبة 30 في المائة. ووصل عدد السيارات المنتجة – بعد أن توقف إنتاجها منذ العام 1942 – إلى 2.148.600 سيارة (مليونين ومائة وثمانية وأربعين ألفا وستمائة) في العام 1946 ، لكن هذا الانتاج سيبقى دون مستوى إنتاج العام 1929 حتى العام 1949.
وارتفعت أرابح الشركات في ظل سوق البائعين بنسبة 20 في المائة ، وطالبت الاتحادات العمالية بزيادات كبيرة في أجور العمل الساعي وامتيازاته. وعمت الإضرابات على نحو يبنئ بالخطر بعد أن رفع الخظر الذي فرض عليها زمن الحرب. وفي يناير 1946 أضرب 3 في المائة من العمال خصوصا في صناعات السيارات والفولاذ والكهرباء وتعليب اللحوم. ولم يحدث منذ ذلك الحين أن أضرب مثل هذا العدد الكبير من العمال ، واعتقد كثيرون أن العمال اكتسبوا قوة كبيرة وأن قانون واجنر إنما رجح كفة العمل كثيرا.
وقد وقع على الرئيس الجديد – هاري ترومان – كثير من اللوم بسبب حالة الخلل التي أملت بالاقتصاد في فترة ما بعد الحرب ، وصارت عبارة "أن تخطئ يعني ترومان" تترد تندرا في كل أنحاء البلاد. وفي حملة السنة السابقة لانتخابات العام 1946 رفع الجمهوريون شعار "لقد طفح الكيل؟" ، وحققوا لأول مرة منذ العام 1928 أغلبية في مجلس الكونجرس ، وقد أطلق ترومان وصفه الشهير لهذا الكونجرس بقوله "الكونجرس الثمانون العاطل عن العمل" ، لكنه مع ذلك أصدر تشريعا مهما هو قانون تافت – هارتلي Taft-Hartley ، الذي أتاح – بخلاف قانون واجنر – لأربا العمل إخطار عمالهم بتفاصيل موقف الشركة من مسألة الاعتراف بأي اتحاد عمالي عن طريق الانتخابات ما داموا لا يلجأون إلى التهديد. كما أتاح للإدارة الدعوة إلى الانتهابات من طرف واحد إذا استخدم العمال وسائل التهديد ، وحظر على الاتحادات إكراه العمال أو الإحجام عن التفاوض باسمهم ، على غرار ما حظر قانون واجنر على الإدارة فعله.
كما حظر القانون تنظيم المقاطعات الثانوية (أو غير المباشرة – وكانت سلاحا فعالا من جملة الأسلحة المتوافرة بأيدي العمال – تماما كما منع إغلاق المحال التجارية (إذ أن على العمال أن يكتسبوا عضوية الاتحاد ليحصلوا على العمل). أما المتاجر الخاضعة لأحكام الاتحاد Union Shops – حيث كان لزاما على العمال الانضمام إلى الاتحاد بعد تشغليهم – فكانت تستدعي تصويت العمال. وسمح للولايات بحظر هذه المتاج. كما أعطى قانون تافت- هارتلي – وكان ذلك هو الجانب الأكثر جلاء في القانون – الرئيس صلاحية قطع الإضراب بالدعوة إلى فترة تهدئة من ثمانين يوما يسعى خلالها وسطاء حكوميون إلى التسوية.
وبالطبع فقد قاوم العمال قانون تافت-هارتلي بكل ما اوتوا من قوة ، أما الرئيس ترومان فقد نقضه (بالفيتو) ووصفه بقوله "مروع ، يسئ إلى العمل وإلى الإدارة وإلى البلاد". وتجاوز الكونجرس نقض الرئيس ، لكن المشكلة التي قصد من التشريع التصدي لها – أي الزيادة المتعاظمة في عدد الإضرابات عقب الحرب مباشرة – كانت تحل نفسها بنفسها ، كما هي الحال غالبا. ففي العام 1946 وصل عدد أيام العمل التي ضاعت بسبب الإضرابات إلى 125 مليون يوم عمل ، أما في كل عام من الأعوام الثلاثة التالية فقد تراجع ذلك العدد إلى 40 مليون يوم عمل.
وكان ترومان مخطئا: فقد ثبن أن قانون تافت-هارتلي إنما كان في مصلحة البلاد. وبفضل التشريعات الاقرب للعدالة والازدهار العظيم آنذاك ، تعلم العمال والإدارة الحد من التصعيد وبذل المزيد في سبيل الوصول إلى التوزيع العادل للثروة التي كانت تخلقها الشركات والأيدي العاملة فيها. وفي العام 1992 ، مع التوسع الهائل في الاقتصاد وحجم القوة العاملة ، لم يتجاوز عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات 4 ملايين يوم عمل. وبينما كان قانون تافت-هارتلي يفعل بين الفينة والأخرى لإنهاء الإضرابات في العقدين اللذين أعقبا صدوره – وعلى أيدي الرؤساء الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء – لم يعمل بهذا القانون إلا مرة واحدة في ربع القرن المنصرم.
وفي العام 1992 – بالطبع – بدأت تلك البيئة الاقتصادية التي خلقت الحركة العالمية المعاصرة تتلاشى سريعا. لقد وصلت نسبة قوة العمل المنظمة في اتحادات عمالية إلى مستويات غير مسبوقة في العام 1945 عند 35.6 في المائة ، وظلت في طور تراجع منذ ذلك الحين. وفي العام 1960 لم تتجاوز تلك النسبة 27.4 في المائة عن قوة العمل غير الزراعية. كما أنها لا تزيد على 14 في المائة. وكانت ستقل عن مستواها في العام 1900 لولا إنتشار الحركة النقابية في أوساط موظفي الحكومة ، التي لم تبدأ إلا في ستينيات القرن العشرين.
كان جوهر الحركة النقابية القديمة يتمثل في الأعمال الصناعية ، إذ نشأت بين عمال خطوط التجميع الذين كان يكررون الاعمال نفسها. وتماما كشأن الزراعة – أكبر قطاعات الاقتصاد – التي حققت ناتجا متزايدا باطراد باستخدام أعداد متناقصة أبدا من قوة العمل ، فإن ثاني أعظم القطاعات الاقتصادية – التصنيع – كان يسلك المسار نفسه. وظل سعي الأمريكيين منذ القدم إلى زيادة الإنتاجية والحد من تكاليف العمل لا يعرف نهاية.
وعلى الرغم من أن كثيرا من محالج القطن في نيوإنجلاند قد انتقل إلى منطقة بيدمونت بعد مطلع القرن العشرين للإفادة من رخص اليد العاملة في تلك المنطقة ، فقد ظل الجنوب ذا طابع زراعي خالص في منتصف القرن ، ولم يكن للاتحادات العمالية أي نفوذ يذكر في هذه المنطقة. لقد حظر كثير من ولايات الجنوب – وقد أجاز لها قانون تافت-هارتلي ذلك – المتاجر الخاضعة لأحكام الاتحاد لتضمن إبقاء الحركة النقابية ضعيفة نسبيا.
وبدأت الششركات – وكانت تتطلع دائما إلى الحد من نفقات العمالة – ببناء المزيد من المصانع في تلك المناطق. لكن النمو الاقتصادي في الجنوب ظل مقيدا بعاملين اثنين: مناخه الحار ، الذي كان من الصعب على غير سكانه الأصليين التأقلم معه ، ومخلفات العنصرية البغيضة التي أبت الزوال.
وقد حلت المشكلة الأولى بتكييف الهواء . حيث وضع نظام تكييف بدائي – لكنه لا يفتقر إلى العملية – في العام 1842 في أبالاتشيكولا بفلوريدا ، لتبريد أحد المشافي. وفي مطلع القرن العشرين طور ستيوارت كرامر وويليس كاريير – كل على حدة – نظاما عمليا لتبريد الهواء يمكن إنتاجه على نطاق صناعي. وبدأ استخدام النظاميين في الأبنية التجارية الكبيرة ، كالمسارح ومحلات الأقسام ، في مطلع عشرينيات القرن العشرين. وبظهور غاز الفريون – وهو مادة مبردة تجمع بين الكفاءة والاستقرار – في العام 1920 تقلصت كثيرا تكلفة تشغيل نظام التكييف وصار واسع الإنتشار.
وبعد الحرب العالمية الثانية كانت مخططات معظم المباني العامة والمكتبية تشتمل على أنظمة تكييف الهواء ، كما صممت وحدا تبريد صغيرة كتلك المستخدمة في عربات القطارات لتلائم الاستعمال المنزلي ولتكييف السيارات . وفي ستينيات القنر صار نظام تكييف الهواء من التجهيزات الملازمة لمساكن الطبقة الوسطى في الجنوب ، وكان ينتشر سريعا في جميع المناطق الحارة في البلاد.
أما العنصرية فكانت مشكلة مستعصية على الحل. ولم يبذل فرانكلين روزفلت – الذي كان في حاجة إلى أصوات المناطق الجنوبية في إقرار برامجه الاقتصادية وبرامج السياسة الخارجية – سوى القليل لاستئصال التمييز العرفي ضد الزنوج. لكن خلفه هاري ترومان استهل المعركة لأجل المساواة في الحقوق في العام 1946 بإصدار أمر يدعو إلى دمج القوات المسلحة. وفي العام 1954 أبطلت المحكمة العليا بالإجماع مبدأ الفصل على أساس المساواة الذي أجاز التمييز العنصري ، وأمر ايضا بدمج المدارس وغيرها من مرافق الدولة "بالسرعة الكلية".
وفي غضون ذلك ، بدأت إحدى أشهر الحركات السياسية في التاريخ الأمريكي – التي تجسدت في شخص القس مارتن لوثر كينج الإبن – التظاهر السلمي لوقف التمييز العنصري على صعيد العمل والقوانين. وقد استغرق الأمر عشرة أعوام من التظاهرات الحاشدة والبسالة في مواجهة القمع الهمجي أحيانا. وفي نهاية المطاف ، في العام 1964 ، أقر التعديل الرابع والعشرون الذي أبطل ضريبة الرأس ، كما صدر قانون الحقوق المدنية ، وأقر الكونجرس في العام التالي قانون حقوق التصويت أيضا . وهكذا وقفت الحكومة الفدرالية الأمه جمعاء بحزم دعما لمبدأ المساواة العرقية.
وقد سحمت المعركة في وقت بدا فيه أن الكفاح لأجل المساواة في الحقوق كان قد بدأ من فوره. ومع التنامي السريع للقوة السياسية للسكان السود في الجنوب ، بدأ السياسيون – حتى أشد مناصري الفصل العنصري من أمثال جورج والاس وستروم ثورمان – يتجاوبون مع مصالحهم. وفي غضون عقد ، صار التمييز العنصري مجرد ذكرى مقيتة. وهكذا نبذ أحد كثر وجوه الحياة الأمريكية مثارا للانقسام ومدعاة للخزي والصغار من كيان الأمة ، ومن ثم – سريعا – من أفئدة الأمريكيين وعقولهم.
وشرع الجنوب – بفضل ميزاته الاقتصادي الجمة خصوصا انخفاض تكاليف الأرض والعمل – في التطور والتحديث بوقع سريع. ومع النمو والتطور السريعيين في اقتصاده زمن الحرب العالمية الأولى ، فقد شهد نموا سكانيا أيضا ، وتعاظم نفوذه السياسي على الصعيد الوطني بالنتيجة. وفي العام 1940 صار لإحدى عشرة ولاية انضوت في الماضي تحت لواء الكونفدرالية القديمة 25 في المائة من الأصوات الانتخابية. أما اليوم فلا تقل هذه النسبة عن 35 في المائة . وهكذا انتهت الحرب الأهلية في آخر المطاف.
إن نشوة العالم بيوم النصر في اوروبا (8 مايو 1945) ويوم النصر في اليابان (15 اغسطس 1945) ، والتي هللت لعودة السلم في اوروبا وآسيا ، لم تدم طويلا فقد بات واضحا – وحتى قبل نهاية الحرب – ان الاتحاد السوفيتي ما كان يعتزم احترام التزاماته حول اوروبا ما بعد الحرب. ففي 30 ابريل 1945 يوم انتحر هتلر – استدعى الرئيس ترومان ، ولم يكن قد انتقل بعد إلى البيت الأبيض ، وزير الخارجية السوفيتي فلاشيسلاف مولوتوف ، وكان آنذاك في واشنطن ، للاجتماع به. وأبلغه بنبرة حادة أن على الاتحاد السوفيتي الوفاء بالتزاماته بخصوص بولندا وتحديدا البند الخاص بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفوجئ مولوتوف بهذه النبرة الحادة ، لكنها لم تؤثر فهي. ففي أواخر العام ، باتت القوات الروسية تحكم سيطرتها على معظم أوروبا الشرقية ، ولكن لم تنوي من دون شك الانسحاب منها.
وبدأت الاتحاد السوفيتي حالا بالضغط على تركيا لتقديم تنازلات ، وعدم حركات العصابات الشيوعية في اليونان وما سواها.
وفي مطلع ربيع العام 1946 تبين أن التحالف الذي أبرم زمن الحرب بين الديموقراطيات الغربية والاتحاد السوفيتي لم يكن – في أحسن الأحوال – سوى مسألة "عدو عدوي صديقي". وبسقوط ألمانيا النازية ، انهار التحالف أيضا. وفي 15 مارس 1946 في فلتون بميسوري ، ألقى وينستون تشرشل خطابه الشهير "عن الستار الحديدي" بحضور الرئيس ترومان . ولقد كان جليات أن المواجهة الجديدة بين القوى العظمى قد بدأت تخيم بظلالها وأن عهد السلام الجديد لم يدم أكثر من عام واحد ، بالمقارنة بعشرين عاما من السلم فصلت الحرب العالمية الأولى عن الثانية. أما الأسوأ فكان الخطر الحقيقي بنشوب حرب ذرية وشيكة ، وهي حرب لا رابح فيها.
كان الاستبداد الشيوعي الذي مارسه الاتحاد السوفيتي لا يختلف ببشاعته عن الاستبداد النازي في ألمانيا ، وكان شأنه شأن الأنظمة الاستبدادية عدوانيا في كل مظاهره. وكان السؤال المطروح حينها: كيف نواجه هذا الاستبداد؟ الولايات المتحدة كانت ذات قوة عسكرية جرارة لكنها شرعات بتسريح قواتها – ما أمكنها – منذ نهاية الحرب. وفي العام 1945 تجاوز عدد أفراد القوات المسلحة اثنا عشر مليونا. أما في العام 1947 فلم تزد تلك القوات على مليونين. كما استغنى عن آلاف السفن والطائرات أو بيعت لدول أخرى. وعلى الغرم من أن الولايات المتحدة حافظة على تفوقها بامتلاك القنبلة الذرية (لم يفجر السوفييت قنبلتهم الأولى إلا في سبتمبر 1949) ، فإنها لم تكن تمتلك إلا بضع قنابل ليس إلا.
وفي مطلع العام 1947 نقلت بريطانيا – التي ساعدت اليونان في وجه التمرد الشيوعي ، وتركيا أيضا – إلى الولايات المتحدة أنها ما عادت قادرة على تحمل العبء المالي لهذه المساعدات ، وأدرك ترومان أنه ليس أمام الولايات المتحدة من خيار إلا أن تضطلع بدور بريطانيا في هذه المنطقة ، وإلا سقطت تلك الدول من دون ريب في فلك الهيمنة السوفيتية.
وقررت الولايات المتحدة أن تخوص غمار المواجهة الثالثة بين القوى العظمى في القرن العشرين ، أو ما صار يعرف منذ ذلك الحين بالحرب الباردة ، ولكن بأسلوب مختلف بالمال بدل الرصاص. وستسعى إلى احتواء الاتحاد السوفيتي بمساعدة حلفائها بالقوات اللازمة لصد أي هجوم ، على أن تولي تركيزها إلى إعادة إحياء وتوسيع اقتصاديات الدول التي قد تقع ضحية للعدوان السوفيتي.
وفي 12 مارس تحدث ترومان أمام جلسة مشتركة للكونجرس فأعلن ما بات يعرف منذ ذلك الحين ب"مبدأ ترومان". فقد أبلغ الكونجرس أنه يعتقد "أنه لزاما على الولايات المتحدة أ، تنتهج سياسة دعم الشعوب الحرة المقاومة للاستعباد الذي تمارسه في حقها أقليات مسلحة أو ضغوط خارجية". وأشار إلى أن هذا الدعم سيأخذ "أساس شكل معونات اقتصادية ومالية".
ولم تكن ثمة معراضة كبيرة لذلك. إذ أن عضو مجلس الشيوخ أرثور فاندنبيرج ، من متشجان – الذي عرف عنه تأييده الشديد للحياد في العلاقات الدولية ، وكان يشغل حينها أيضا منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ – خاطب ترومان بعد أن استمع إلى خطبته المقتضبة قائلا: "أبلغ الكونجرس والأمه بذلك ، وسأشد على يدك. وأعتقد أن أكثر الاعضاء سيفعلون الشئ نفسه".
وفي يونيو ، وفي خطبته الاستهلالية في هارفارد قدم اللواء جورجي سي مارشال رئيس أركان الجيش زمن الحرب – وكان آنذاك وزيرا للخارجية – اقتراحا سيعرف فيما بعد ب"خطة مارشال" ، وهي واحدة من أروع وأبرع فنون السياسية في التاريخ. لقد حثت الأمم الاوروبية – ومنها الاتحاد السوفيتي – على التعاون في سبيل إعادة إعمار القارة ، على أن تقدم الولايات المتحدة رأس المال اللازم. ورفض ستالين الفكرة على الفور ، وكذلك فعلت بلدان اوربا الشرقية الواقعة تحت النفوذ السوفيتي ، لكنه ساعد من دون قصد منه على تسويق الفكرة بين بلدان أوروبا الأخرى بإقدامه على التخطيط لانقلاب عسكري في تشيكو سلوفاكيا في مطلع العام 1948.
وفي السنوات التالية قدمت خطة مارشال لاوروبا 13 مليار دولار ، وساعدت – تحديدا – على النهوض ثانية باقتصادات ألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا. وعلى الرغم من ذلك فإن مساعدات خطة مارشال لم تشكل سوى نسبة ضئيلة من المساعدات الأمريكية الخارجية في تلك السنوات . وبين العام 1946 ومطلع سبعينيات القرن ، عندما بدأ برنامج المساعدات الخارجية التراجع أنفقت الولايات المتحدة نحو 150 مليار دولار معونات اقتصادية للدول الأخرى. وذهب ثلث تلك المعونات تقريبا إلى أوروبا. وقدم الباقي إلى آسيا وأمريكا اللاتينية ودول أخرى.
وعلى غرار قانون "الإعارة – التأجير" ، كان هذا البرنامج سخيا جدا (لا بل أن تاريخ العالم لم يعرف أن تساعد قوة مهيمنة دولا أخرى ستنافسها اقتصاديا في المستقبل ، على بناء اقتصاداتها) ، وكان أيضا مثالا ساطعا عن المصلحة الذاتية الواعية ، ولكن على مستوى الدول. ولو كان آدم سميث قد شهد تلك الأعمال لاستحسن صنيع هذه الأمة التي انتهجت سبيل التجارة الحرة. لقد كانت الولايات المتحدة – ونصف الناتج العالمي الإجمالي من إنتاجها – تحقق فوائض تصديرية ضخمة. لكن الدول الأخرى ، وقد أنهكت اقتصادات كثير منها ، لم تكن قادرة على سداد ثمن وارداتها إلا بالتصدير إلى الولايات المتحدة.
وبمساعدة منظمات دولية ولدت من رحم الحرب العالمية الثانية كالبنك الدولي وصندوق البنك الدولي والاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (جات) ، سعت الولايات المتحدة إلى إرساء نظام تجاري عالمي جديد وتخفيض التعريفات الجمركية بين دول العالم لتعزيز التجارة الدولية لما فيه خير الجميع. وكانت النتيجة أيضا نجاحا باهرا. وارتفع حجم التجارة الدولية ستة أضعاف في السنوات الخمس عشرة التي أعقبت الحرب ، مما ساعد كثيرا على تقوية اقتصادات جميع الدول المشاركة. واستمرت تلك النزعة من دون هوادة ، فبلغ حجم التجارة العالمية الكي 125 ضعف ما كان عليه في العام 1950 ، اي ما يعادل 7.35 ترليون دولار ، ويشتمل ذلك على الانتاج والخدمات. وقد تبين أن التجارة الحرة أعظم محركات النمو الاقتصادي التي عرفها العالم على الإطلاق.
وقد اقر الكونجرس في العام 1946 قانون التوظيف. واسس هذا القانون مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية المشتركة التابعة للكونجرس. والأهم من هذا، أنه نص على أنه تركز سياسة الحكومة الفدرالية على زيادة فرص العمل والإنتاج والقدرة الشرائية. ومع أن هذا القانون صار طي النسيان اليوم – لأن ما يهدف إليه بات اليوم من المسلمات – فقد كان ثوريا في زمانه.
وكانت الحكومات ، حتى ثلاثينيات القرن العشرين ، ترى أنه ليس أمامها كثير من الفرص الاقتصادية. وكان ، من دون ريب ، من واجب الحكومة تحقيق متسوى من عرض النقد يحفظ قيمة العملة ويسهل انفاذ التعاقدات. لكن لم يكن ثمة من يرى أن الحكومة مسئولة عن تنظيم الدورة التجارية ، لأن ذلك خارج قدراتها تماما كحركة الطقس. لكن تلك النظرة تغيرت بعد الكساد الكبير وعلى يد أحد أعظم علماء الاقتصاد منذ آدم سميث.
ولد جون مينرد كينز (اللورد كينز بعد العام 1944) في كامبردج بانجلترا. وسيقى ملازما لجامعتها طوال حياته. وقد تتلمذ على يد ألفريد مارشال ، وهو عالم اقتصاد بارز من الجيل السابق ، الذي وضع كتابا صار من أبرز مراجع علم الاقتصاد "مبادئ علم الاقتصاد" ، ونشر أول مرة في العام 1890 ، لقد درس مارشال الرياضيات والفيزياء قبل أن يتحول إلى علم الاقتصاد. وكان مفهومه عن الاقتصاد الوطني يتخلص في مقولة كينز "نظام كوبرنيكي كامل ، تحفظ فيه كل عناصر البيئة الاقتصادية في مواضعها بأثقال موازنة وقوى تأثير متبادلة".
وارتقى كينز أولى مراتب الشهرة عندما حضر مؤتمر فرساي للسلام في العام 1919 مع وفد الخزانة البريطاين ، ووضع كتابا – بعد أن ساءته اتفاقية السلام الموقعة – بعنوان "العواقب الاقتصادية للسلام" ، ثيت أنه كتبه بنفاذ بصيرة. وفي العام 1936 نضشر عمله الخالد "النظرية العامة في العمالة والفائدة والنقود". لتفسير مسببات الكساد الكبيرة وعلة استمراره.
كان علماء الاقتصاد – قبل كينز – منكبين على ما يعرف اليوم بعلم الاقتصاد الجزئي Microeconomics ، أو التخصيص المتعدد للموارد الذي يرسي الأسعار ويؤثر في العرض والطلب في السوق. أما كينز فقد حصر اهتمامه في علم الاقتصاد الكلي Macroeconomics ، أو آلية تأثير العرض والطلب الكليين على الأجل الطويل ، لكننا كما لخص في مقولته الشهيرة "ميتون على الأجل الطويل". أما على الاجل القصير فيمكن أن يختل توزان العرض والطلب. فالزيادة الكبيرة في العرض تفضي إلى الكساد ، أما الارتفاع الكبير في الطلب فهو السبيل إلى التضخم.
لقد شعر كينز بأن الحكومة – إن تعمدت إحداث عجز في اوقات تراجع الطلب (أو خفض الضرائب) وزادت عرض النقد – يمكنها الحيلولوة دون وقوع الكساد. وبالمثل فإن انتهاج مسار معاكس – أي تحقيق فوائض تتزامن مع رفع أسعار الفائدة – يتيح للحكومات التحكم في فترات الطفرات الاقتصادية. وتقبل علماء الاقتصاد أفكار كينز من دون تردد. كانت هذه الأفكار – من ناحية – تنم عن نظرة ثاقبة مدهشة ، وتبدو كأداة فعالة في كبح تلك الكوارث الاقتصادية التي عايشها أولئك جميعا.
وبالطبع ، أكسبت الكينزية علماء الاقتصاد مكانة مرموقة لم يرتقوا إليها من قبل. إذ لم يكن السياسيون قبل كينز في حاجة إلى اقتصاديين يساعدونهم على إدارة شئون السيايسة ، بأكثر مما كانوا في حاجة إلى علماء الفلك. وبعد كينز صار لعلماء الاقتصاد منزلتهم الرفيعة ، ومن هنا جاء إنشاء مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس ، على الرغم من أن دقة وتجانس المشورة لم يكونا مؤكدين تماما . وقد روي عن ترومان – وهو أول رئيس يلجأ إلى هذه الاستشارات الاقتصادية – أنه طلب ، على سبيل الدعابة ، أن يعمل لديه اقتصادي بذراع واحدة ، لأن كل الاقتصاديين العاملين لديهم دأبوا على القوم "هذا من ناحية أولى .. أما من الناحية الثانية..".
لقد ولد أول رئيسين أمريكيين لفترة ما بعد الحرب – ترومان وايزنهاور – في القرن التاسع عشر ، وتتلمذا على علم الاقتصاد ما قبل الكينزي. لذلك ظلا ينزعان إلى الشك والارتياب. وقد عبر جورج همفري وزير الخزانة في إدارة ايزنهاور عن سلوك الجيل ما قب الكنزي بوصف رائع لخصه في الجملة التالية: "لا أعتقد أنك قادر على إنفاق ثروتك كلها". وبنيما عجز كل من الرئيسين عن تقليص الدين القومي إلى مستويات مقبولة – لا بل إن الدين القومي ارتفع في الواقع في أثناء فترتيهما الرئاسيتين – فإنهما حالا في المقابل دون ارتفاعه إلى مستويات كبيرة. وقد حققت نصف موازنات الدولة زمن ايزنهاور وترومان فوائض مالية ، ومنها موازنتان خلال الحرب الكورية. ولأن الاقتصاد أصاب نموا قويا في السنوات الخمس عشرة التالية للحرب ، فقد تناقص الدين كنسبة من الناتج القومي الإجمالي بمعدلات كبيرة. حيث بلغت هذه النسبة 130 في المائة في العام 1946 ، ولم تتجاوز 54.75 في العام 1960.
ولكن لما تولى كينيدي الرئاسة في العام 1961 ، انتهج مبادئ الكينزية كلها. وقد تحدث والتر هلير – أستاذ الاقتصاد ف يجامعة مينيسوتا ، قبل أن يتبوأ منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين – عن امتلاك القدرة على "التحكم التام" في الاقتصاد الوطني ، بكلمة أخرى ، أراد والتر أن تكون الحكومة "المهندس: الذي يشغل آلة ألفريد مارشال الاقتصادية. وقد اقترح موازنة ما أطلق عليه "ميزانية التشغيل الكامل". أي يجب على الحكومة – بتعبير آخر 0 أن تنفق ما تحصل عليه من إيرادات عند مستوى التشغيل الأمثل في الاقتصاد. فإذا بلغ الاقتصاد ذلك المستوى تكون الميزانية في الة توازن. وإذا كان دونه ، فإن العجز الناتج يحفز الاقتصاد تلقائيا ويدفعه ثانية نحو الوضع الأمثل.
إن المال لهو بالطبع "حليب الأم الذي تتغذى عليه السياسة". إذ عندما كانت لدى السياسيين أسباب مقنعة للإنفاق بالعجز بدأت الضغوط المادية بذلك ترتفع من دون هوادة. وبالنتيجة ، ارتفع الدين القومي بمقدار الثلث في عقد الستينيات ، وتلك أول مرة يحقق فيها الدين ارتفاعات حادة في أوقات السلم والازدهار الاقتصادي . وعلى الرغم من ذلك ، وبفضل ذلك الازدهار (والتضخم المتصاعد) ظلت نسبة الدين القومي إلى الناتج القومي الإجمالي تتراجع ، فهبطت من مستوى 40 في المائة بحلول العام 1969.
أما كينيدي – وكان يتسم بصبغة محافظة – فقد هب لتحفيز الاقتصاد عن طريق التخفيضات الضريبية بلاد من زيادة الانفاق ، خصوصا في أوساط الشرائح الضريبية المرتفعة ، حيث خفض الضرائب من 91 في المائة إلى 70 في المائة. وعندما أصدرت التشريعات الناظمة لهذه التخفيضات الضريبية بعد وفاته بفترة قصيرة ، أدت الدور المطلوب منها . وبين العام 1963 و1966 حقق الاقتصاد نموا تراوح بين 5 في المائة و6 في المائة سنويات ، بينما هبطت البطالة دون مستوى 4 في المائة ، من 5.7 في المائة.
وفي السنوات العشرين الفاصلة بين نهاية الحرب العالمية الثانية ومنتصف الستينيات تضاعف حجم الاقتصاد الأمريكي بالأرقام الحقيقية ، وارتفع الناتج القومي الإجمالي من 313 مليار دولار إلى 618 مليار دولار (كلا الرقمين محسوب بقيمة الدولار في العام 1958). بينما ظل التضخم منخفضا. وانطلقت تنبؤات عدة بامتداد فترة الازدهار وتحقيق المزيد من "الإيرادات المالية" للخزانة ، في وقت تواصل فيه الحكومة تخفيضاتها الضريبية (أو تزيد إنفاقها) مع ارتفاع حجم إيراداتها. وشهدت سوق الأسهم – التي ارتدت إلى ما دون مستوى العام 1929 طول ربع قرن – ارتفاعا مطردا بعد أن كسر ذلك الحاجز في آخر المطاف في العام 1954 ، واقترت من مستوى ألف نقطة على مؤشر داو جونز في منتصف السيتنيات. وبعد عقدين من الطفرة الاقتصادية المتواصلة (لم يتخللها إلا ثلاث فترات ركود قصيرة جدا ومحدودة الأثر. كان يمكن إغفالها في عصر لم يكسب فيه علم الاحصاء بعد الزخم الذي سيبلعه اليوم) فقد بدا حلم الازدهار المستدام – الذي بدده الكساد الكبير ذات مرة – قاب قوسين أو أدنى ، مرة أخرى.
الفصل التاسع عشر: أزمة البرنامج الجديد
أثبت ليندون جونسون – عندما تولى الرئاسة في أعقاب إغتيال جون إف كينيدي – أنه رئيس يختلف تماما عن سابقيه. إذ كان يكبر كينيدي بعشر سنين ، وكان ربيب البرنامج الجديد – بكل ما تحمل الكلمة من معنى. رجل يؤمن كثيرا بقدرة الحكومة على حلال المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. كما كان يتتمتع أيضا بمعرفة تشريعية لم تتوافر لغيره من الرؤساء. وقد جعلته هذه المعرفة أكثر قادة الأغلبيات في تاريخ مجلس الشيوخ إنجازا ، وكان مصمما على توظيفها في إتمام ما بدأه البرنامج الجدي الذي انتهجه مثله السياسية الأعلى فرانكلين روزفلت . وأخطر الحضور الذي احتشد في جامعة متشجان يوم الثاني من مايو 1964: "في زمانكم هذا ، لدينا الفرص ليس لأن نمضي نحو مجتمع الثراء والقوة فقط ، وإنما أن نرتقي أيضا إلى المجتمع العظيم".
وبفضل انتصار ساحق في انتخابات نوفمبر ذلك العام ، حيث جونسون الكونجرس على التصديق – من بين طائفة من مشاريع القوانين – على قانون المساواة بالفرص وقانون العبور (الترانزيت) الجماعي (1964) والرعاية الصحية والمعونة الطبية (1965) وقانون المسنين ()1965) وقانون تنمية منطقة أبالاتشيان (1965) وقانون التربية المبكرة (1965) وقانون تنمية المدن (1966) وقانون التعليم العالي (1967). وإلى جانب كثير من البرامج الصغيرة الأخرى ، التي انخرطت فيها الحكومة الفدرالية في مجال الحياة اليومية للمواطن ، ولم يسبق أن شغلت الحكومة نفسها بها، فقد سبب ذلك ارتفاعا خاطفا في النفقات الفدرالية . وقد ارتفعت النفقات الحكومية غير الدفاعية بمعدل الثلث في ثلاث سنوات فقط. من العام 1965 إلى العام 1968 ، ومن 75 مليار دولار إلى 100 مليار دولار. وفي غضون ذلك ، ازدادت حرب فيتنام سخونة. ففي العام 1965 كانت ميزانية الدفاع لا تزيد على 50 مليار دولار. وفي العام 1968 بلغت 82 مليار دولار.
ولو أن الاقتصاد كان في مرحلة تراجع في الأداء – كما كانت حاله في ثلاثينيات القرن – لكان هذا الانفاق الجديد ساعد على تحفيز الاقتصاد . لكن الاقتصاد في منتصف الستينيات كان عند مستوى 50 في المائة من التشغيل الكامل (العمالة الكاملة) ، لذلك كانت النتائج الحمية أن شرع التضخم في الارتفاع. ونشأت على الفور حلقة مفرغة. فقد أدى ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة لأن المقرضين إنما يلتمسون في الزيادة وقاية لهم من أثر التضخم. لكن الاحتياطي الفدرالي – وكان يسير على النموذج الكينزي – كان يخشى أن تشل زيادة أسعار الفائدة النمو الاقتصادي ، لذلك عمل على زيادة عرض النقد للجم أسعار الفائدة. ذلك أن الزيادة في عرض النقد – نسبة إلى السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بهذا النقد – قد أحدثيت ولا مفر من ذلك ، زيادة في التضخم.
وبدأ الاقتصاد الأمريكي يتقهقر سريعا. فإرتفعت البطالة – التي لم تتعد في العام 1968 نسبة 3.5 في المائة – إلى 4.9 في المائة في العام 1971. ووفق نظرية كينز فإن زيادة التضخم لا يمكن أن تتزامن مع ارتفاع نسبة البطالة. وهذكا اشتقت كلمة جديدة في العام 19870 لتوصف هذه الحالة التي لا سابق لها ، الكساد التضخمي Stagflation.
وقد تجاوزت سوق الأسهم - التي كانت في ارتفاع مطرد منذ مطلع الخمسينيات - عتبة 1000 نقطة على مؤشر داو جونز (التداول اليومي) لأول مرة في العام 1966. ليستقر عند ذلك المستوى. وتجاوز مؤشر داو جونز حاجز ألف نقطة في التداول اليومي أربع مرات قبل أن تغلق السوق في نهاية المطاف فوق مستوى ألف نقطة ، حيث وصل إلى 1051.70 نقطة في 11 يناير 1973. لكنه تراجع على الفور في أسوأ سوق هبوطية يعرفها الاقتصاد منذ مطلع الثلاثينيات. ومع نهاية العام 1974 هبط إلى 557.650 نقطة. وقد أخفى التضخم الجامح آنذاك شدة التراجع الفعلي في سوق الأسهم. وقد هبط مؤشر داو جونز الصناعي - مقيسا بالوحدة النقدية الثابتة - إلى ما دون المستوى الذي بلغه في ملطع الخمسينيات ، حينما بدأت ملامح سوق صعودية تشكل.
وصار سعر الدولار يتجاوز قيمته الفعلية مقابل العملات الأخرى بسبب التضخم غير المسبوق في تاريخ الاقتصاد الأمريكي زمن السلم ، وسياسة تخفيض سعر الفائدة (سياسة النقد الميسر) التي انتهجها الاحتياطي الفدرالي. وهذا ما جعل السلع الأمريكية تبدو أعلى سعرا من تلك المقومة بعملات أخرى. كما باتت السلع الأجنبية أقل ثمنا بالنسبة إلى الأمريكيين. وقد انكمش الميزان التجاري - وهذا أمر لا مفر منه - بعد تعافي الاقتصادات الأجنبية ، ولطالما كان الميزان التجاري الأمريكي رابحا جدا في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. وفي العام 1959 عانى الميزان التجاري عجزا طفيفا . لكنه بدأ بالتدهور سريعا في أواخر الستينيات ، وفي العام 1971 وقع مرة أخرى في العجز وظل في طور تراجع منذ ذلك الحين.
ولأن الدولار كان عملة التجارة العالمية ، وكان بموجب اتفاقية بريتون وودز قابلا للتحويل إلى ذهب بسعر ثابت قدره 35 دولار للأوقية ، فقد رتاكم الدولار في خزائن المصارف المركزية للدول الأجنبية ومؤسساتها المالية. وكان الدولار يخرج من الولايات المتحدة ولا يعود إليها إطلاقا. ومع ارتفاع مستوى التضخم في الولايات المتحدة ، بدت أرصدة "اليورو دولار" متذبذبة ، وبدأ الذهب بالتدفق إلى الخارج بكميات كبيرة لأول مرة منذ مطلع الثلاثينيات. وبدأت أعمال المضاربة على الدولار في سوق العملات الدولية الذي باتت قوة متنامية في الاقتصاد العالمي.
وفي 15 اغسطس 1971 حسم الرئيس نيكسون المسألة - وما جانب الحكمة في ذلك - لحل المشكلات الاقتصادية المتعاظمة التي واجهتها البلاد. إذ عمل أولا على إبطال اتفاقية بريتون وودز ، وقطع الارتباط بين الدولار والذهب. ومنذ ذلك الحين ستتحدد قيمة الدولار بالعرض والطلب، ,انقضى بذلك معيار الذهب - بعد 150 عاما - من دون رجعة. وجمد ثانيا الأجور وبدلات الإيجار والأسعار جميعا لمدة تسعين يوما تتبعهها ضوابط صارمة على الأجور والأسعار. إن لضوابط الأجوز والأسعار (أو أنظمة الرقابة عليها) تاريخا طويلا ، كلنه غير محمود في معظمة÷ ففي ظل سوق حرة ، تعكس الأسعار - ملايين الأسعار - الاحتياجات التي يجب أن توجه إليها الموارد الاقتصادية ومكامن الفرص الاقتصادية ، أي ما ندر من الموارد وما كان وفيرا ، مما يسمح للأفراد تعديل سلوكهم الاقتصادي وفقا لذلك. وعندما تثبت الأسعار - مع ذلك - تنشأ على الفور - وبصورة حتمية - حالات عجز وفائض. وهذا يفسر النقص الدائم في الوحدات السكنية حيثما وجدت الضوابط على بدل الإيجار. كما أن ضوابط السعر تحرم السوق الحرة (أي الأفراد) من مصدر قوتها وتجعلها رهنا بيد السياسييين. والسياسيون - بالطبع منساقون أبدا وراء إغراء توظيف هذه القوة لما فيه مصلحة الفئات المقربة ، أما غير المقربين فيواصلون السعي وراء مصالحهم الذاتية عبر آلية السوق السوداء.
لقد طبقت ضوابط السعر أول مرة - وعلى نطاق واسع - على يد ديوقليسيان إمبراطور روما في أواخر القرن الثالث للميلاد. فلقد سعى الأباطرة الأوائل جاهدين إلى إضافة المعادن الخسيسة إلى المصكوكات النقدية. وقد فتح هذا الباب واسعا أما التضخم الجامح. وأجرى ديوقليسيان إصلاحات جادة في نظام المصكوكات والنظام الضريبي ، لكن لم يتوافر له العرض الكافي من النقود ، ولذلك إضطر إلى ضرب النقود أيضا من معادن خسيسة لم يكن لها قيمة فعلية (وإنما قيمة مصنعة) وسعى إلى فرضة بقوة القانون.
لكن ذلك لم يأت طبعا بأي نتيجة. ذلك أن قانون جريشام يجزم بأن ذلك من ضروب المستحيل. لذلك فقد حاول ديوقليسيان - وكان عاجزا عن احتواء التضخم بتحديد سعر النقد - أن يحتويه بتحديد أسعار السلع كلها (كل السلع ما عدا النقد). ويعد الأمر الذي أصدره في سبيل ذلك - والذي كتب له البقاء - إضاءة تاريخية قيمة على واقع اقتصاد روما في العصر المتأخر ، حيث وضعت قوائم بالأسعار الرسمية لكل صنوف السلع والخدمات. لكن وكما كان شأن جميع المحاولات المتعاقبة لاتخاذ القانون ضابطا للأسعار بدلا من أن يترك تحديدها لملايين الأفراد في معرض سعيهم إلى تحقيق مصالحهم الذاتية ، فقد باءت تلك المحاولة بفشل ذريع ، على الرغم من التطبيق المتهاون لعقوبة الإعدام وسيلة لإنفاذ ذلك الأمر. فقد أخفيت البضائع وكان تبادلها يتم على أساس المقايضة أو خارج نطاق القانون من قبل جماعات لديها مصلحة ذاتية مشتركة في إخفاء الأمر عن السلطات.
ولم يكن مصير ضوابط الأسعار والأجور التي اعتمدها نيكسون بأحسن حالا من سابقتها. إذ علق العمل بعد عامين ، ولم يعرف التضخم تراجعا - ولم يعد آنذاك مرتباطا بالذهب على الإطلاق - في كل أنحاء العالم. وهكذا ارتفعت كثيرا أسعار الفائدة بعد أن سعى المقرضون إلى وقاية أنفسهم من التراجع السريع في قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى . وقد ورد عن وليام زيكندروف - وهو متعهد إنساءات عقارية في مدينة نيويورك اشتهر بحبه للمخاطرة - أنه قال: "أفضل أن أكون حيا عند سعر فائدة 20 في المائة بدلا من أن أكون ميتا عن سعر الفائدة الأساسي". وبعد سنوات أربع من وفاته في العام 1976 ، وصل سعر الفائدة الأساسي إلى 20 في المائة. كما بلغ التضخم في العام 1980 نحو 13.5 في المائة وهو أعلى مستويات التضخم زمن السلم في تاريخ الأمة.
في غضون ذلك واصل الميزان التجاري الأمريكي تدهوره ، فمع تعافي الدول الأخرى من آثار الحرب وإعادة إنشاء بنيتها الاقتصادية الأساسية ، تراجعت فيها تكلفة الإنتاج بفضل مصانعها الجديدة. كما أن إنخفاض نفقات النقل والتعريفات الجمركية في سنوات ما بعد الحرب زاد قدرة هذه الدول على المنافسة الفعالة في السوق الأمريكية مع الشركات الأمريكية.
وهذا كان أيضا شأن بعض المواد الخاص خصوصا النفط. لقد ظهرت صناعة النفط في الولايات المتحدة ، وظلت الولايات المتحدة مصدرا للنفط حتى الخمسينيات. لكن في السبعينيات ، ومع نضوب حقول النفط الغنية في الولايات المتحدة ، وارتفاع تكلفة استغلال الحقول الجديدة ، بدأت النفط الأجنبي الأقل تكلفة بالتدفق إلى البلاد بمعدلات متزايدة ، وبطبيعة الحال لم يمض وقت طويل حتى سعت الدول المصدرة للنفط إلى الاستفادة من هذا الواقع الجديد ، فشكلت "كارتل" تحت اسم أوبيك (منظمة الدول المصدرة للنفط) في سبيل رفع الأسعار.
ونتيجة لحرب يوم الغفران في العام 1973 بين إسرائيل وجيرانها العرب ، أحجمت كثير من الدول المصدرة للنفط عن التصدير إلى الولايات المتحدة. وهكذا تشكلت طوابير طويلة أمام محطات البترول في بلد كان دائما مثال "أرض الوفرة" ، وارتفعت اسعار المشتقات النفطية ارتفاعا حادا ، وقد شكل هذا صدمة كبيرة لمعظم الأمريكيين وللاقتصاد الأمريكي ذلك أن تكلفة النفط المستورد أثرت عموما في أسعار كل السلع والمنتجات الأخرى.
كما شكل ذلك صدمة أيضا لما كان عماد الاقتصاد الأمريكي طوال ستين عاما: صناعة السيارات . لقد استحوذت هذه الصناعة على السوق الأمريكي كلها منذ الحرب. وقد تطورت إلى ما يشبه "كارتل" غير رسمي يستمد قاعدته من قوانين محاربة الاحتكار التي حظرت على شركات السيارات الثلاث الكبرى - جنرال موتورز وفورد وكرايسلر - أن تسعى كل منها لاهثة إلى انتزاع الحصة السوقية من الآخرين.
ولأنها لم تكن مضطرة إلى أن تجشم نفسها عناء وتكاليف الابتكار ، فقد ألمت بهذه الصناعة حالة من الركود التكنولوجي. وكان آخر الفتوح الكبرى التي حققتها هذه الصناعة نظام النقل الآلي للحركة ، الذي ظهر أول مرة في العام 1948. ذلك أن شركات السيارات ركزت اهتمامها على التصميم والحجم والقدرة. وباتت السيارات الأمريكية في سنوات ما بعد الحرب تزداد حجما وترفا بمزايا بعدية عن القيمة العملية مثل زعانف المؤخرة وإضافة الكروم. إن الخط التطوري لصناعة السيارات الأمريكية في تلك السنوات يماثل على نحو عجيب نزعة الكائنات الحية المعزولة عن الاختلاط بالكائنات الأخرى في محيطات حيوية تكثر فيها أسباب الغذاء إلى اكتساف أجسام عملاقة. متنافرة شكلا أحيانا. إذ أن الأسوابق هي أنظمة حيوية ، تماما كما أن الانظمة الحيوية هي أسواق (أي مسرح للمنافسة).
وبحظر النفط في العام 1973 انتهت على الفور عزلة سوق السيارات الأمريكية . وفي ضوء قلة المعروض من البنزين ، ارتفع بشدة الطلب على السيارات الاوروبية الاقتصادية (الأقل استهلاكا للوقود). واضحت سيارة الخنفساء (بيتل) من شركة فولكس واجن - التي لم تكسب آنذاك إلا سوقا صغيرة أساسها طلاب الكليات والأسر ذات المركبتين - رمزا لجيل جديد من السيارات . وستنتج الشركة من هذا النموذج أكثر مما أنتجت فورد من نموذج "تي". وبدأت السيارات اليابانية أيضا تغزو الأسواق الأمريكية فكشفت عن حال الضعف التي لازمت أساليب تصنيع كثير من السيارات الأمريكية وحال انعدام الكفاءة التي بلغتها الصناعة الأمريكية.
ونظرا إلى طول الزمن اللازم لإعادة التصميم وإعادة تجهيز المصانع بالآلات والمعدات ، فإن صناعة السيارات الأمريكية ستعمل جاهدة طوال ما ينوف على عقد من الزمان لاستعادة مكانتها وقوتها. وعندما تحقق لها ذلك ، باتت صناعة السيارات واحدة من أوليات الصناعات الثقيلة التي اكتسبت بعدا عالميا ضاغيا. إن من النادر اليوم أن تصنع كل قطع السيارات في بلد واحد ، ولم تعد صفقات من قبيل "أمريكية" و"ألماينة" و"يابانية" توحي إلا بمقر المكتب الرئيسي للشركة ، وحيث يقيم معظم حملة أسهمها.
وأقفلت كثير من المصانع الأمريكية بسبب تقدمها التكنولوجي ، ودخل مصطلح "حزام الصدأ" القاموس الأمريكي . لكن بالمقابل ، افتتح عدد من المصانع الجديدة ، كثير منها على يد شركات أجنبية ، في عدد من المناطق الأخرى في الولايات المحدة ، خصوصوا الجنوب والغرب. كانت هذه المصانع الجديدة قادرة على إنتاج الكمية نفسها من السلع بأيد عاملة أقل بفضل الزيادة المحققة في الإنتاجية.
ولأن لدى وسائل الإعلام ميلا فطريا إلى الاهتمام بالخبر السيئ ، فقد اعتبر ذلك تراجعا في القوة الاقتصادية لأمريكا ، فكان حزام الصدأ رمزا في الواقع آذن ببدء عملية إعادة هيكلة جذرية. لقد كانت حصة التصنيع في الاقتصاد تتراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان نصف الوظائف في قطاعات الاقتصاد من نصيب قطاع التصنيع. وفي منتصف السبعينيات ذهب ثلثا الوظائف في الاقتصاد الأمريكي إلى قطاع الخدمات.
لكن إعادة الهيكلة تلك - التي لا تزال جارية بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن - أفضت إلى تغيير مرهق وسببت كثيرا من المعاناة للأفراد والاقتصادات المحلية. لقد ارتفع معدل الفقر الرسمي - الذي هبط من 22 في المائة في العام 1959 إلى 11 في المائة في العام 1973 - إلى 15 في المائة في العام 1983. وظلت كميات الفولاذ المنتجة في الولايات المتحدة ثابتة عند مستوى 100 مليون طن سنويا ، لكن عدد العمال في صناعة الفولاذ انخفض من 2.4 مليون في العام 1974 إلى اقل من مليون في العام 1998.
كما أدركت يد التغيير "المرهق" السياسات المالية والرقابية الحكومية. وهذه السياسات التي وضع معظمها قيد التطبيق منذ عهد البرنامج الجديد ، كانت تعتمد ضريبة دخل تصاعدية مع معدلات حدية مرتفعة على الدخول الكبيرة وتفرض كثيرا من الضوابط على القاطعات الرئيسية في الاقتصاد ، وذلك للحيلولة دون نشوء الاحتاكارت ، ولكبح "المنافسة المفرطة". وقد باتت هذه السياسات فلسفة مقبولة في إدارة الاقتصاد المعاصر. لكن تبين مع مرور الأيام أن السياسات التي طبقت في الثلاثينيات لم تكن ناجعة في الظروف الاقتصادية المختلفة التي شهدها عهد السبعينيات.
لقد رأى الآباء المؤسسون في السلطة التنفيذية - وليس في الكونجرس - خطرا كبيرا على سياسة الترشيد. وعلى الرغم من ذلك فقد أسس مجلس النواب لأول مرة في القرون الوسطى ليمارس دور الرقيب على بذخ الملوك وللحد من سلطة فرض الضريبة التي كانت بيد الملك. وقد ظلت تمارس دور الرقيب في أواخر القرن التاسع عشر ، مع انتقال هذه السلطة فقط إلى اصحاب الملاك - دافعي الضرائب. لقد اعتبر الآباء المؤسسون أن الكونجرس - الذي كان معظم أعضائه يعين من قبل "أصحاب الأملاك" في أول عهده - خير من يضطلع بهذه المهمة. لكن ظهور الديموقراطية الحقيقية في ظل هيمنة ذكورية على حقوق التصويت في عهد أندرو جاكسون قد أدى إلى تحول في موقف الكونجرس من الانفاق.
ومع أن الكونجرس بجميع أعضائه يضطلع بالتزام جماعي في الرقابة على الانفقا ، فإن لكل عضو فيه مصلحة ذاتية في الحصول على قسط كبير من الإنفاق الحكومي لمنطقته أو ولايته. لقد عرف مصطلح "برميل لحم الخنزير" في قاموس السياسة الأمريكية في العام 1904 . وببدء تطبيق البرنامج الجديد وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي نشأت ضغوط تطالب بالتصويت للمنافع الجديدة التي لاقت قبولا واستحسانا من المواطنين.
ولطالما كان الرؤساء الطرف الأضعف في مناقشات الموازنة مع الكونجرس ، الذي بيده السلطة الملطقة لتحديد المخصصات من أموال الخزانة. وعلى الرغم من أن بإمكان الرؤساء نقض مشروعات الغنفاق كغيرها من جملة مشروعات القوانين الأخرىز فإن النقض فعل يخلو من الكياسة في أفضل حالاته. ذلك أنه لابد من قبول المشروع كله أو رفضه كله ، وليس مجرد الاكتفاء برفض الفقرة المتصلة بالإنفاق المعترض عليه. ولم يكن أمام الرئيس - وهو الموظف الحكومي الوحدي في واشنطن الذي أجمعت الأمة على انتخابه ، باستثناء طبعا نائب الرئيس العاطل عن الصلاحيات - من وسيلة لكبح هذا الإنفاق سوى حبس الأموال عن الإنفاق (إيقاف الصرف) ، وأول من لجأ إلى ذلك كان توماس جيفرسون ومن جاء بعده من الرؤسء. إذ أتاح إيقاف الصرف للرئيس أن يرفض صرف مخصصات الأموال.
ومع تصاعد حدة التضخم في السنوات المتأخرة من فترة رئاسته ، سعى جونسون إلى كبح الإنفاق من خلال إيقاف صرف المزيد والمزيد من الأموال. ففي العام 1966 أوقف صرف مالا يقل عن 5.3 مليار دولار من أصل ميزانية قيمتها 134 مليار دولار ، بما فيها 1.86 مليار دولار في برامج الخدمات العامة ، كالطرقات الرئيسية والتعليم. وعلى الرغم من أن الكونجرس الذي هيمنت عليه أغلبية ديموقراطية عبر علنا عن تذمره ، فإن ذلك لم يلق تنازلا من رئيس من الحزب الديموقراطي. ولم يبل نيكسون بلاء حسنا. فبعد أن نقض قانون تلوث الميه في العام 1972 ، لأنه كان بنظره مكلفا جدا ، أجاز الكونجر مشروع القانون على الرغم من هذا النقض. ومن ثم أوقف نيكسون صرف مبلغ 6 مليارات دولار كان الكونجرس قد خصصها للمشروع. ورأى الكونجرس في ذلك - بطبيعة الحال - تجاوزا صريحا لصلاحياته الإنفاقية.
ولما بدأت قوة نيكسون السياسية تخبو عقب فضيحة ووتر جيت أقر الكونجرس قانون الرقابة على الموازنة للعام 1974 ولعله كان أبرز التشريعات التي أسيئت تسميتها في التاريخ الأمريكي . فقد ألغيت صلاحيات الرئيس في إيقاف الصرف ، والتي لم تكن لها أي سلطة قانونية ، وأنشئ مكتب الموازنة التابع للكونجرس الذي ألحق بالكونجرس جهاز الموازنة نفسه الذي ألحقه مكتب الإدارة والموازنة بالرئيس ، وبالتالي سلطة الاعتراض على تقديراته ، بالتقدم بتدقيرات أكثر استجابة لتطلعات الكونجرس.
وبإصدار قانون الرقابة على الموازنة ، خرجت الموازنة الفدرالية على السيطرة. وقد وصل عجز الموازنة في العام 1974 إلى 53 مليار دولار ، وهو أكبر عجز بالوحدات النقدية الثابتة منذ منتصف الحرب العالمية الثانية. ولقد أدى ذلك إلى زيادة الدين القومي بنسبة 10 في المائة تقريبا في عام واحد. وفي نهاية العقد ، تجاوز الدين القومي ما كان عليه في العام 1970 بمقدار ضعف ونصف ، مع أنه وبسبب التضخم المتسارع ظل يتراجع كنسبة من الناتج القومي الإجمالي.
أما ما لم يطرأ عليه أي إنخفاض فكانت نسبة الناتج القومي الإجمالي التي كانت تتدفق في قنوات الجهاز المالي الحكومي سنويا. ذلك أنه - في ظل ضريبة الدخل التصعدية - تخضع الدخول المرتفعة إلى معدلات ضريبية متزايدة ، وبالتالي يدفع التضخم بالمكلفين إلى شرائح ضيبية أعلى فأعلى. لذلك ارتفعت ضرائب الدخل بالارقام الحقيقية (مع مراعاة أثر التضخم) ، بينما بقيت الدخول بالأرقام الحقيقية على حالها. وبالنسبة إلى كثيرين في واشنطن كانت في تلك حالة مرضية تماما ، حيث ارتفعت الإيرادات الحكومية من دون أن يضطر الكونجرس إلى تكبد مضقة عرض زيادة الضرائب للتصويت.
وبدأ الحزب الديموقراطي - الذي تصدر المشهد السياسية في البلاد منذ العام 1932 - يفقد صلته بالناخبين وأخفق في استيعاب الإشارات الواضحة عن حال الإستياء الشعبي من جراء تقهقر الاقتصاد الأمريكي في السبعينيات. وفي العام 1978 بدأ مواطنوا كاليفورنيا "ثورة ضريبية" من خلال الاستفتاء على إجراء تخفيض حاد للزيادات المحتملة في الضرائب العقارية المحلية. وأشعل هذا ثورات ضريبية في مناطق أخرى ، ونودي بإصلاح النظام الضريبي الفدرالي المثير للجدل والمتزايد تشعبا وتعقيدا.
وللمساعدة على كبح الكساد التضخمي الذي عصف بالاقتصاد الأمريكي في السبعينيات ، اقترح عضو الكونجرس جاك كيمب وعضو مجلس الشيوخ ويليام روث تخفيض المعدلات الحدية (الهاشمية) على ضريبة الدخل الشخصي ، على غرار ما فعل الرئيس كيندي قبل أكثر من عقد خلا ، واصاب بذلك نجاحا عظيما ، وبربط معدلات الضريبة بالتضخم فلا يدفع المكلفون إلى شرائح ضريبية أعلى في وقت لا ترتفع فيه دخولهم بأرقام حقيقية.
واستهجن الديموقراطيين اقتراح كيمب وروث حول الضرائب. وحاول الرئيس جيمي كارتر - وكان يسعى إلى الترشح إلى فترة رئاسة جديدة - الربط بين منافسه في انتخابات العام 1980 - روالند ريجان - والاقتراح ، وذلك بأن أطلق عليه اسم "اقتراح ريجان - كيمب - روث" ، وهو ما رحب به منافسه بحركة تتم عن مكر ودهاء.
وعاد نقص البنزين إلى الواجهة في أواخر السبعينيات في وقت تعاظم فيه التضخم. وشرعت أسعار الأسهم - التي كانت قد تعافت من انخفاضها الكارثي في العام 1974 - بالتراجع ثانية . وكانت الصناعة الأمريكي تعاني مشكلات متزايدة في المنافسة مع الدول الأخرى. وانتهى الأمر بمدينة نيويورك إلى الافلاس - وهي التي طبقت نموذج إعادة توزيع ثمار الرفاهية الاجتماعية أكثر من أي مدينة أخرى ، والتي اعتمدت كثيرا على ضرائب الخدمات المالية . ومع عجز المدينة عن الاقتراض ، هبط مستوى العميئة فيها بصورة لافتة ، وشاعت صور الحدائق المهملة والأنفاق والحافلات المتهالكة المملوءة برسوم الجرافيت ، وارتفعت معدلات الجريمة ارتفاعا حادا.
أما الجيش الأمريكي - الذي كان يشكو من قلة الموارد المالية آنذاك بسبب من الديموقراطيين المناوئين الشكسين للحروب ، والذين هزتهم نتائج حرب فيتنام - فكان عاجزا عن الرد الحاسم على استباحة سفارتنا في إيران في العام 1979 واحتجاز أمثر من أربعمائة رهينة ممن كانوا فيها.
أما الاتحاد السوفيتي - الذي تم احتواء طموحاته في الهيمنة على العالم طوال عقود ثلاثة بفضل القوة العسكرية الأمريكية - فكان يستعرض قوته على نحو غير مسبوق. ففي العام 1979 غزا السوفييت أفغانستان لكي يضمنوا لنفسهم وجود نظام مهلهل يكون دمية بأيديهم. وبدا أن الولايات المتحدة لم يكن لديها الكثير لتأتيه ردا على هذا العمل. لقد بدت أقوى دولة في العالم كأنما امست عملاقا لا حول له ولا قوة. وكان ثمة من يعتقد أن القرن الأمريكي قد أزفت نهايته مبكرا.
وعلى ذلك ، ولأول مرة منذ أيام هربرت هوفر ، عزل رئيس منتخب وهو لما يزل في منصبه بإجماع الناخبين المطلق. فقد صوت الشعب الأمريكي بالإجماع على التغيير وكان له ما أراد. إذ سيثبت رونالد ريجان أن فترته الرئاسية ستكون الأبرز والأهم بين الفترات الرئاسية في القرن العشرين ، باستثناء فترة رئاسة فرانكلين روزفلت الذي كان ريجان ينظر إليه بعين الإعجاب الكبير ، كرجل ورئيس.
وصحيح أن الفضل يعود إلى رونالد ريجان في رفع الضوابط وتخفيض الضرائب ، لكن كان ذلك قيد الإنجاز عندما تبوأ منصب الرئاسة ، ولكنه مع هذا ألقى بكل ثقله لإستئناف وتعزيز أعمال إعادة هيكلة الاقتصاد السياسية الأمريكي. لقد تحول معظم الجهاز الرقابي الفدرالي الذي تأسس في العام 1887 - وقد أنشئت لجنة التجارة بين الولايات ، وتوسع هذا الجهاز كثيرا في عهد البرنامج الجديد = إلى اتحادات كارتلية اهتمت بحماية مصالح الصناعة التي كانت خاضعة لرقابتها أكثر مما سعت إلى حماية مصالح الاقتصاد بكليته.
إن مجلس الطيران المدني - وكان مسئولا عن الرقابة على خطوط الرحلات وأسعار تذاكر الطيران بين الولايات - قد أبقى على أسعار التذاكر على تلك الخطوط عند مستويات تتجاوز كثيرا أسعار الخطوط المماثلة غير العاملة بين الولايات. وفي العام 1978 نزع عنه الكونجرس صلاحية وضع أسعار التذاكر وتحديد خطوط سير الطائرات على لارغم من المعارضة القوية التي أبدتها شركات واتحادات الطيران (ذلك أن معارضة الإدارة والعمال لأي تعديل في نظام المراقبة هو دليل واضح على أن ثمة "كارتل" يعمل وراء الكواليس). لقد شهد قطاع الطيران - وهو خاضع منذ اول عهده للضوابط الرقابية - فترة تحول صعبة عندما دخلت شركات الطيارن في منافسة سعرية . وعلى الفور ظهر نظام المحور والفروع وتغيرت أجور النقل مرارا وتكرارا على خلفية الحروب السعرية بين شركات الطيران. وأفلست كثير من شركات الطيران من مثل بان أمريكان وإيسترن وبرانيف واقتحمت كثير من الشركات الجديدة - مثل ساوثويست إيرلاين - هذا القطاع. وهبط متوسط أسعار التذاكر بشدة ، وتزايدت حكرة السفر بالطائرة بمعدلات سريعة.
ولقد سمح قانون النقل بالمركبات للعام 1980 لقطاع الشحن بالمنافسة. كما أتاح قانوان الشركات المتعثرة في السنة نفسها للسكك الحديد أن تفعل الشئ نفسه. وهكذا بدا قطاع السكك الحديد = وكان في طور تراجع في معظم سنوات القرن العشرين - بالانتعاش من جديد ، ولم يمض وقت طويل حتى زالت من قطاع النقل كل مسببات القصور غير المبرر - كذلك التي كانت توجب على كل المقوطرات العودة إلى نقطة انطلاقها غير محملة. وفي العام 1980 وصلت نسبة مساهمة قطاع النقل في النتاج المحلي الإجمالي إلى 15 في المئة. وهبطت في عقد التسعينيات إلى 10 في المائة. ولأن النقل - في رأي علماء الاقتصاد - يعد من تكاليف "الصفقات" - أي النفقات الضرورية التي لا تضيف قيمة ضمنية إلى المنتج مثل مصروفعات الإعلان والتغليف - فقد عاد ذلك على الاقتصاد بمكاسب خالصة.
أما أهم الموارد جولات إزالة الضوابط في فترة السبعينيات فكان مسرحها وول ستريت. ذلك أن بورصة نيويورك إنما نشأت كاتفاقية بني السماسرة الذين تواضعوا بموجبها على اعتماد حد أدنى لأسعار تداول الأسهم. وهكذا ثبتت العمولات منذ ذلك الحين. لكن في 1 مايو 1975 وبناء على طلب لجنة البورصة والأوراق المالية ، فقد أجيز أن تحدد العملات على أساس المنافسة وذلك للمرة الأولى منذ 183 سنة.
أما العمولات الثابتة - التي كانت تحسب كنسبة من سعر السهم - فكانت عرضة للضغوط طوال سنوات بسبب الإرتفاع الهائل في عدد صفقات التداول الكبرى. إذ لم يتجاوز عدد الصفقات اليومية - بالمتوسط - 35 صفقة محلها أكثر من عشرة ألاف سهم في العام 1965. وفي العام 1975 بلغ متوسط عدد الصفقات 135 في اليوم (أما حاليا فيتجاوز 5 آلاف صفقة). هذه الصفقات تقل تكلفة إنجازها كثيرا عن تكلفة إنجاز صفقات تداول مائة سهم ، ومن هنا فقد سعت المؤسسات الكبرى - كصناديق الاستثمار ، والتي كانت تتداول بكميات كبيرة - إلى تغيير ذلك الواقع. وقد عارضت ذلك بيوتات السمسمرة الصغيرة التي كانت عاجزة عن الوصول إلى درجة الكفاءة التي تحققت لبيوتات السمسرة الكبيرة.
ومع تعليق العمل بالعمولات الثابتة انخفضت تكلفة تداول الأسهم بنسبة 40 في المائة بين ليلة وضحاها. وظلت تلك التكلفة تتراجع منذ ذلك الحين. ونتيجة لذلك ، شهدت وول ستريت موجة كبيرة من عمليات الاندماج حيث اندمجت الشركات الصغيرة - غير القادرة على المنافسة - مع الشكرات الكبيرة. وفي غضون ذلك ، ظهرت شركات جديدة - كسماسرة الخصم - تقدم خدمات بطسية وتتقاضى أسعارا رمزية أيضا. إن أهم نتائج يوم مايو - كما أطلق عليه - ارتفاع حجم المتداول. ففي السنوات السبع عشرة التالية ازداد التداول بنسبة 800 في المائة وظل يتزايد بمعدلات كبيرة جدا منذ ذلك الحين. إن حجم التداول في وول ستريت بلغ مليار سهم سنويات في العام 1929 ن وم نهاية القرن باتتدوال مليار سهم يويما المعيار الشائع. وبالانخفاض الكبير في تكلفة ملكية الأسهم ، ارتفعت نسبة ملاك الأسهم الأمريكيين مباشرة وبأعداد متزايدة باطراد ، وصارت تمارس دور "الرأسمالي" شريحة من السكان متزايدة عددا ، واقترن ذلك بآثار متعاظمة في السياسة الأمريكية.
كما بدأت التغيير يشمل النظام الضريبي أيضا ، ففي العام 1969 أدلى وزير الخارجية المنصرف في إدارة جونسون بشهادته أمام الكونجرس ، فأفاد أنه في العام 1967 كان ثمة 155 إقرارا ضريبيا ينم عن دخول تتجاوز عتبة 200 ألف دولار و21 إقرارا ضريبيا تنم عن دخول تتجاوز عتبة مليون دولار ، ومع ذلم فلم يقع عليها أي عبئ ضريبي ، وذلك بسبب بعض الأحكام في النظام الضريبي كتلك التي تمنح إعفاءات ضريبية على السندات البلدية. وتحرك الكونجرس فأجاز قوانين تعين حدا أدنى للعبء الضضريبي ، ووضع نظاما ضريبيا ملحقا مستقلا بذاته عرف باسم الضريبة الدنيا البديلة . وكان لهذا القانون أثر في رفع معدلات الضريبة على الدخول المرتفعة ويزادة الضريبة على الأرباح الرأسمالية بما لا يقل عن 50 في المائة.
وقد أثر ذلك سلبا على الاقبال على المخاطرة لأنه قلص العائد المحتمل من دون أن يحد من مستوى المخاطرة المترتبة عليه. كما أن الاستثمار في الفرص التكنولوجية الجديدة يشتمل على مخاطرة كبيرة دائما ، ذلك أن عدد المشاريع التي ينتهي مصيرها إلى الفضل يفوق عدد المشاريع الناجحة. إن من قوانين علم الاقتصاد المسلم بها أن الناس يحجمون عن تجريب الأفكار الجديدة عندما لا تكون عوائد النجاح على قدر مخاطر الإنفاق.
كما قلص ذلك المتحصلات الكلية من ضرائب الأرباح الرأسمالية ، وهذا دليل على أن معدلات الضريبة المرتفعة جدا تؤدي إلى تناقص المتحصلات الضريبية لا إلى إرتفاعها - وهذا ما بات يعرف بمنحنى لافر نسبة إلى واضعه عالم الاقتصاد آرثر لافر. وفي العام 1968 ، في وقت لم تتجاوز فيه الأرباح الرأسمالية 25 في المائة وصلت إيرادات الضريبة إلى 33 مليار دولار. وفي العام 1977 ترجعت هذه الإيرادات - بمراعاة أثر التضخم - إلى 24 مليار دولار. ومع أن عدد الشركات التكنولوجية الناشئة كان في العام 1968 أربعمائة شركة ، فإن العام 1967 لم يعرف أيا منها على الإطلاق. وبالنسبة إلى اقتصاد تبوأ مركز الصدارة التكنولوجية لما يزيد عن قرن خلا ، كان ذلك تحولا ينذر بسوء.
وقرر عضو الكونجرس ويليام ستيجر - وهو جمهوري من ويسكونسن - أن يخوض معركة التغيير. كان ثمة كثير ممن يعتقدون - في أواخر السبعينيات - أن الحزب الجمهوري ينحدر إلى مجاهل النسيان. فبعد أن هزت صورته في فضيحة نيكسون في ووترجيت ، وبعد غياب عن السلطة دام أكثر من أربعة عقود فقد عد هذا الحزب شيئا من الماضي. وفي انتخابات العام 1976 لم يكسب الجمهوريين إلا 158 مقعدا في مجلس النواب مقابل هينمة الديموقراطيين ب277 مقعدا.
كان الحزب الجمهوري - في الواقع - بمور بالأفكار الجديدة الهادفة إلى التصدي للواقع الاقتصادي الجديد. أما الديموقراطيين فكانوا يولون اهتمامهم للتشبث بنموذج البرنامج الجديد الذين خدم أ÷دافهم على مدى أربعين عاما ، لكن ما كان والتر ليبمان منشغلا به في العام 1964 لم يعد مناسب الظرف الراهن. وبالنتيجة - فقد كسب مرشح ديمقراطي واحد منصب الرئاسة منذ ذلك العام - وهو جيمي كارتر في العام 1976 - أغلبية الأصوات (ولم يكن كارتر قد حقق أكثر من 50.46 في المائة من الأصوات). وفي العام 1994 سيهيمن الجمهورييون كلية على الكونجرس لأول مرة منذ عقود أربعة وسيحافظون على تفوقهم منذ ذلك الحين.
إن ستيجر - الذي كان عضوا في بلجنة "السبل والوسائل" (اللجنة المالية الأساسية) المعنية بتقرير الضرائب - قد أثبت أنه سياسي يتحلى بالقدرة على الإقناع ، إذ نجح في خشد دعم زملائه الجمهورييين لتخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية. كما نجح في تحول كثير من الديموقراطيين إلى جمهوريين ، مما أعطاه أغلبية (2 إلى 1) في اللجنة. وقد قاوم الديموقراطيون الاقتراح بشدة. وهدد الرئيس جيمي كارتر بنقض قانون الإصلاح الضريبي للعام 1978 ودعت صحيفة نيويورك تايمز إلى إلغاء التمييز بين الأرباح الرأسمالية والدخل الدائم. ولولا ذلك لرفع هذا القانون ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 77 في المائة.
ومع ذلك ، فقد أقر الكونجرس مشروع القانون ، ووقعه الرئيس كارتر على الرغم من تهديده ووعيده. وكان الأثر فوريا. ففي العام 1977 لم يتحقق من قطاع مشاريع رأسمال المخاطرة سوى 39 مليون دولار. أما في العام 1981 فوصل هذا الرقم إلى 1.3 مليار دولار. وسيمضي ريجان قدما في غصلاحاته الضريبية ، وذلك بإقناع الحدية على الدخول المرتفعة - وهي مصدر معظم رؤوس الأموار الجديدة في العام 1981. وفي العام 1986 عقد ريجان اتفاقا شهيرا مع عضو الكونجرس دان روستين كويسكي - وهو ديموقراطي من إلينوي ورئيس لجنة السبل والوسائل التابعة للكونجرس. فقد اتفقا على إحداث تخفيضات إضافية منذ العشرينات. وبالمقابل ، ألغيت آلاف الاقتطاعات الضريبية وسدت الثغرات القائمة على النظام الضريبي، مما ساهم في تبسيط هذا النظام وساعد على تحسين المناخ الاستثماري.
وعندماتولى رونالد ريجان الرئاسة ، ثم أيضا كبح التضخم في نهاية المطاف ، ويعود الفضل في ذلك إلى الاحتياطي الفدرالي ورئيسه الجديد بول فولكر. لقد غير فلورك - الذي عينه جيمي كارتر في صيف العام 1979 - سياسة الاحتياطي الفدرالي في الرقابة على الفائدة إلى السيطرة على عرض النقد الذي كان يشهد نموا سريعا جدا ويذكي معدلات التضخم. وبالنتيجة ، وصلت أسعار الفائدة غلى أعلى مستوياتها في التاريخ الأمريكي في السنوات القليلة التالية ، وكان لزاما على الحكومة الفدرالية ذاتها - وهي تتمتع بأقل مستويات مخاطر الائتمان في البلاد - أن تدفع 15.8 في المائة لبيع سندات أجلها عشرون عاما.
أما النتيجة الحتمية لسياسة فولكر - والتي رحبت بشجاعة إدارة ريجان الجديدة بها - فكانت ركودا شديدا هو الأسوأ منذ الثلاثينيات. ولأول مرة منذ الكساد الكبير تخطى معدل البطالة مستوى 10 ف يالمائة وهبطت سوق الأسهم إلى ما دون مستوى 800 نقطة على مؤشر داو جونز. كان العلاج "القنديط مرا كالعلقم ، ومع ذلك فقد حفف من أثر الضائقة وجود شبكة شمان إجتماعي واسعة - خصوصا برنامج التأمين على البطالة - والانتشار الكبير لإعانات التسريح من العمل في عقود الاتحادات العمالية.
لكن الآثارا الايجابية لم تتأخر كثيرا. فقد بدأت التضخم بالانحسار. وبعد أن وصل في العام 1980 إلى أشده عند مستوى 13.5 في المائة انخفض في العام التالي إلى 10 في المائة. ثم تراجع إلى 6.2 في المائة في العام 1982 وهو أدنى مستوى له منذ مطلع السبعينيات. وتراجع في العام 1983 إلى 4.1 في المائة. أما في المتوسط فقد بقيت دون هذه النسبة فيما تبقى من ذلك العقد.
وبكبح جماح التضخم بدأت أسعار الفائدة تتراجع.وإن لم يكن على نحو فوري ، خصوصا أن المقرضين كانوا يسعون إلى حماية أنفسهم من عدوة التضخم الجاغمح. وبانخفاض أسعار الفائدة ، نشطت حركة الاقتراض والاستثمار ، وبلغ الركود نهايته. وقد توجت هذه النهاية بطبيعة الحال بانتعاش سوق الأسهم التي بدأت تتعافى وسط موجة طبيعبية من الذعر في صفوف البائعين في أغسطس 1982. ومع نهاية ذلك العام تخطة مؤشر داو جونز عتبة ألف نقطة ولم ينحسر عنها. وآذنت أعظم سوق صعودية في تاريخ العالم ببدايتها.
ويعود الفضل في نشوء هذه السوق الصعويدة إلى موجة الاندماجات والاستحواذات وهي رابع موجة يشهدها الاقتصاد الأمريكي ، وتماثل في بعض وجوهها كثيرا أول موجة عرفتها تسعينات القرن التاسع عشر. وأذكى هذه الموجة تراجع أسعار الأسعار بالقيمة السوقية لأصول الشركات وتراجع أسعار الفائدة وظهور تقنيات جديدة في تجميع رؤوس الأموال كالسندات الرديئة - وهي السندات ذات معدلات الفائدة المرتفعة والمخاطر المالية المرتفعة ايضا - إضافة إلى ولادة أفكار لم تعهد من قبل - كقناة سي إن إن ، وهي أولى شبكات الأخبار الشاملة الكابلية. وفي نهاية القعد سيتعرض أكثر من ثلث عدد الشركات الخمسمائة المدرجة على قائمة مجلسة "فورتشن" إلى عمليات إندماج وإستحواذ. وكما كان شأتها في تسعينيات القرن التاسع عشر ، حققت بعض تلك الاندماجات نتائح اقتصادية وتولدت عنها مؤسسات أكثر ديناميكية وأقل ترهلا. وتقوضت بالمقابل مؤسسات أخرى وانتهى بها مصيرها إلى الفشل. كما شاب البعض حالات احتيال وتدليس وتعاملات مريبة. ولا شك مع هذا في أن الاقتصاد الأمريكي بات بعد انتهاء موجة الاندماجات تلك أقوى كثيرا مما كان قبلها.
وفي العام 1987 وصل مؤشر داو جونز الصناعي إلى 2500 نقطة ، أي ثلاثة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل سنوات خمس فقط ، كما باتت مقومات الاقتصاد الضمنية راسخة ومتكاملة. ومع ذلك فقد شهدت السوق في اكتوبر من ذلك العام أسوأ انهيار منذ العام 1929 وأكبر تراجع مئوي في يوم واحد 22.8 في المائة - في التاريخ. كان حجم التداول آنذاك غير مسبوق على الإطلاق ، حيث بلغ 604 ملايين سهم ، اي ضعف أعلى مستويات التداول المحققة سابقا.
لقد اعتقد كثيرون أن ذلك إنما كان يؤدب ببداية كساد كبير آخر. لكن السوق استردت 104 نقطة في اليوم التالي (وحققت حجم تداول أعلى من سابقه: 6.8 ملايين سهم). وبلغ مستوى جديدا على مؤشر داو جونز في خمسة عشرة شهرا. ويعود ذلك أساسا إلى أن الاحتياطي الفدرالي تحرك بسرعة وإصرار لكبح موجة الهلع وحماية المؤسسات الاقتصادية في البلاد من الاضرار المحتملة. وعلى حد تعبير بنجامين يترونج فإن الاحتياطي الفدرالي "أغرق الشوارع بالمال" ، وذلك عندما ضخ سيولة هائلة في النظام الاقتصادي.
ولأول مرة منذ أن تصدى ألكساندر هاملتون لموجة الهلع التي ضربت البلاد في العام 1792 ، فإن السلطات النقدية أدت ما هو مطلوب مها في وقت الأزمة المالية. وبالنتيجة ، لم يصب النظام برمته إلا بأضرار طفيفة على الأجل الطويل ، وما عاد أحد يذكر اليوم انهيار السوق في العام 1987 على الإطلاق. ويبدو أن شبح مقت توماس جيفرسون لجمع الصروة وإنفاقها قد تبدد أخيرا. ولسوء الطالع ، سيعاود هذا الشبح ظهوره على مسرح الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى.
لقد رفض فرانكلين روزفلت فكرة تأمين الإيداعات ، خشية من "المخاطر الأخلاقية" التي لابد أن تظهر. وورد عنه قوله "لا نرغب في تحميل حكومة الولايات المتحدة مسئولية أخطاء وحماقات المصارف ، كما لا نرغب في تشجيع العمل المصرفي المريب في المستقبل". لكن السياسة عادة هي المفاضلة بين الوسائل القاصرة لتحقيق الغايات المنشودة ، وقد أبلت مؤسسة تأمين الإيداعات الفدرالية بلاء حسنا في ظل الكارتل المصرفي الذي تشكل بفضل البرنامج الجديد.
لقد تقاسمت المصارف التجارية ومصارف ومؤسسات الادخار والتسليف أعمال الإيداع المصرفي في الولايات المتحدة فميا بينها. وبدأت المصارف التجارية تقد خدمات مصرفية كاملة ، وذلك بتقديم خدمة حساب الإدخار والحسابات الجارية للأفراد من جهة والتركيز كثيرا على القروض التجارية من جهة أخرى. وقدمت مصارف الادخار ومؤسسات الإدخار والتسليف حسابات إدخار بمعدلات فائدة تزيد قليلا على معدلات المصارف التجارية (علما بأن معدلات الفائدة كانت تحدد رسميا) وركزت أيضا على تقديم القروض العقارية. كما أن هذه السوق كانت مقسمة بين المصارف ، فتخصصت مصارف الادار في العقارات التجارية بينما قدمت مؤسسات الادخار والتسليف قروضا سكنية اقتصرت تقريبا على المساكن العائلية. وقد حصر ترخيص المصارف الجديدة للحيلولة دون اندلاع "منافسة مفرطة". وبينما ظل عدد مؤسسات الادخار والتسليف ثابتا عند ستة آلاف بعد انهيار السوق في الثلاثينيات ن فقد ارتفعت قمية موجوداتها الإجمالية من 8.7 مليار دولار إلى 110.4 مليار دولار بين عامي 145 و1965.
كان هذا العمل المصرفيخلوا من أي ضغوط أو منغصات تذكر ، فكان يطلق عليه اسم "الصيرفة 3-6-3" ، ذلك أن مؤسسات الادخار والتسليف كانت تفدع 3 في المائة على الإيداعات وتأخذ 6 في المائة على القروض ، وكان إداريوها يمضون إلى مجاز الجولف في الساعة الثالثة بعد الظهر. ومع ذلك ، وبعد أن فتحت الخمسينيات والستينيات الطريق أمام التضخم المتصاعد الذي عرفه عقد السيتينات والسبعينيات بدأ نموذج العمل الذي انتهجته مؤسسات الإدخار والتسليف يتداعي. وارتفعت معدلات الفائدة غير الخاضعة لضوابط الحكومة إلى مستويات كبيرة ، بينما ظلت معدلات الفائدة الخاضعة لضوابط للرقابة ثابتة من دون تغيير. وبدأت بيوت السمسرة وصناديقا الاستثمار في وول ستريت بتوفير صناديق سوق النقد التي تجاوزت معدلات الفائدة فيها كثيرا معدلات الفائدة على حسابات الادخار.
وأقبل الناس على سحب أموالهم من مصارف الادخار ومؤسسات الادخار والتسليف في صناديق سوق النقد - التي ظهرت للتو - وهو تحول يشار إليه باصطلاح اقتصادي رنان هو "هجرة الودائع". وقد استطاعت المصارف التجارية - ومعظم قاعدة ايداعاتها من الحسابات الجارية غير المدرة للفائدة - أن تتأقلم مع الوضع الجديد. أما المصارف الأخرى فعجزت عن ذلك ، وسعت إلى الحصول على معونة الحكومة الفدرالية في ظل الهبوط السريع لقاعدة الايداعات وتراجع فائدة القروض العقارية طويلة الأجل.
كان الكونجرس قلقا حيال تقديم المعونة. وعلى حد تعبير عضو الكونجرس ديفيد بريور" يجب ألا ننسى أن لكل فئة في المجتمع مؤسسة القرض والتسليف الخاصة بها ، وبعضها لديها اثنتان والأخرى أرع ، وفي كل منها سبعة أو ثمانية أعضاء هي مجلس الإدارة ، إنهم يملكون سيارة شيفروليه ومتجر الأجذية". كان أولاء - بكلمة أخرى - هم أنفسهم الأفراد الذين يحتاج الكونجرس إلى دعهم ومساندتهم. وكما كان شأن كل دولة ديموقراطية في الأجل القصير ، فقد تغافلت السياسة عن الواقع الاقتصادي ، وكانت النتيجة خير مثال على ضرورة الاستجابة لمقتضيات الواقع وعدم التواني في تنظيم العمل في أي قطاع اقتصادي ووضع الضوابط الخاصة به.
كان من الأجدى أن تجبر مؤسسات الادخار والتسليف على الاندماج بمؤسسات أشد قوة منها أو أن تحول إلى مصارف تجارية ، في ظل متطلبات رأس المال والاحتياطي نفسها. لكن بدلا من ذلك ، رفع سقف معدلات الفائدة مما سمح للمصارف بدفع فوائد على الايداعات تتناسب ومعدلات السوق ، ورفع الضمانة الفدرالية على الايداعات المصرفية من 40 ألف دولار إلى 100 ألف دولار.
لكن وول ستريت نجحت في التحايل على هذا الحد السخي بأداة عرفت باسم "الايداعات غير المباشرة" (ايداعات الوساطة) ، وهي ايداعات مجمعة (مركبة) تعادل تماما قيمة الضمانة الفدرالية. كان ذلك أسلوبا بسيطا لتمكين أصحاب الأصول السائلة عالية القيمة (الموجودات النقدية الكبيرة) من الحصول على ضمانات فدرالية على أموالهم بالقدر الذي يشاءون. وقد بات هذا يعرف باسم "الأموال الساخنة" أي الأموال التي تطارد أسعار الفائدة الأعلى حيثما كانت.
وبرفع مؤسسات الادخار والتسليف لمعدلات الفائدة على الايداعات - في وقت لم تجد فيه مهربا من قروضها العقارية ذات الفائدة المنخفضة - سار قطاع الادخار والتسليف سريعا نحو الإفلاس. وقد بلغت موجودات مؤسسات الادخار والتسليف الإجمالية 32.2 مليار دولار في العام 1980. وهبطت بعد عامين إلى 3.7 مليار دولار ، وخرجت سلطات الرقابة المصرفية - بضغط من الكونجرس - بحلول سريعة. كان لهذه الحلو أثر جعل تحسين صورة الدفاتر المحاسبية من دون حل المشكلة ، كان ذلك أشبه بحال طبيب يقول إن درجة حرارة قدرها 102 لا تخرج على الحدود الطبيعة ، ليتسنى له القول إن المريض في وضع صحي سليم.
كما عدلت تلك السلطات الرقابية قواعد ملكية مؤسسات الادخار والتسليف ، إذ إلى جانب السكان المحليين ، أتيح لعامة الناس إنشاء مؤسسات ادخار والافادة من الموجودات غير النقدية - كالأراضي ، وهي أقل الموجودات سيولة على الإطلاق - في تشكيل احتياطياتها. وهكذا فإن ويلي ستونز - وقد لمس الفرصة السانحة بفطنته التي اشتهر بها - تحول إلى العمل في هذا القطاع.
وفي العام 1983 أجاز الكونجرس لمؤسسات الادخار والتسليف تقديم قروض غير سكنية وقروض استهلاكية - تماما كشأن المصارف التجارية - لكن من دون أن تخضع للمستوى نفسه من متطلبات رأس المال والاحتياطي أو الضوابط المحاسبية المفروضة على المصارف التجارية.
وباتت الكارثة وشيكة الحدوث ، فقد سمح الكونجرس وسلطات الرقابة المصرفية بنشوء حالة تناقض اقتصادي تمثلت في استثمارات عالية العائد معدومة المخاطرة عرفت باسم ايداعات الوساطة. وفي السماح لأفراد ذوي الخبرة المصرفية الضحلة والمشكوك في نزاهتهم واحترامهم لحكم القانون بمحاولة انتشال تلك المؤسسات من مهاوي الإفلاص. لكن أولئك سببوا سريعا تدمير قطاع الادخار . وبعد أن انقشعت سحب الدمار ، اضطرت الحكومة الفدرالية إلى تعويض مودعي مؤسسات الادخار المفلسة بمبلغ 200 مليار دولار.
كانت تلك أعظم فضيحة مالية في التاريخ الأمريكي. ولكن وكشأن الفضائح جيمعا ، فقد شقت الطريق نحو الإصلاح بإسكات الأصوات المعارضة بشدة لهذا الإصلاح. وفي العام 1994 خلص قانون الإصلاح المصرفي أخيرا الصناعة المصرفية من آخر معوقاتها التي تعود إلى عهد جيفرسون. فقد سمح للمصارف بفتح فروع لها في الولايات الأخرى والتوسع ، مما وفر لها إمكانات بالتنويع وأطلق موجة من اندماجات المصارف لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وهكذا انتهى عهد التمييز بين مصارف الاستثمار ومصارف الإيداع - الذي اعتمد في الثلاثينيات بموجب قانون جلاس ستيجال - كما انتهى قدر كبير من التمييز بين بيوت السمسرة والمصارف وشركات التأمين.وفي نهاية المطاف صار للولايات المتحدة نظام مصرفي يليق بمستوى الاقتصاد الأمريكي ، حجما ونطاقا.
وبسبب عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي في الثمانينيات ، قوى الدولار مركزه مقابل العملات الأخرى . إذ بلغ سعره مقابل المارك الألماني 1.8 في العام 1980. ووصل في العام 1985 إلى 3 ماركات. وارتفعت قيمته مقابل الفرنك الفرنسي بمقدار الضعف. وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة بمعدلات هائلة. وتجاوزت أملاك الأجانب في الولايات المتحدة في أواخر الثمانينيات أملاك المواطنين الأمريكيين في الخارج بنحو 400 مليار دولار ، وهكذا انقلبت الحال السائدة منذ الحرب العالمية الأولى.
وبينما يرى بعض المراقبين في ذلك علامة على ضعف الولايات المتحدة - كانت في واقت الأمر - على العكس من ذلك تماما. فقد تدفق راس المال الأجنبي إلى الولايات المتحدة تحديدا لأن الاقتصاد الأمريكي صار يعد اقتصاد الفرص العظيمة من جديد. وتزايدت الهجرات الأجنبية أيضا بأعداد كبيرة في الثمانينيات مع سعي الفقراء - كما الأغنياء - إلى قطف ثمار الازدهار في "إمبراطورية الثروة".
لقد جاءت الاصلاحات الضريبية والضوابط - التي أذنت بالنهاية الفعلية لما أطلق عليه أرثر شلنجر "عصر روزفلت" قبل عقدين - في توقيت مناسب جدا ، إذ كان الاقتصاد العالمي يشهد عملية تحول جذري منذ الثورة الصناعية قبل قرنين ، وربما منذ نشوء الزراعة قبل عشرة آلاف عام خلت، ولأن الولايات المتحدة كانت أول بلد يمر بتحولات "مؤلمة" لابد منها لأي اقتصاد سياسي يقوم في شطر منه على إعادة توزيع الثروة ، فإنها كانت مهيأة في المقام الأول للإفادة من الفرص غير المحدودة لاقتصاد سياسي جديد أساسه الفرص.
الفصل العشرون: اقتصاد جديد .. عالم جديد.. حرب جديدة
تعتبر الحروب - عموما محركات التطوير التكنولوجي ، خصوصا تلك الحروب الأعظم في التاريخ ، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية . صحيح أن التطور التقني كان آتيا لا محالة . وبغض النظر عن ذلك ، لكن الحرب بفضل الإنفاق الهائل على البحوث والحاجة الماسة إلى تحقيق نتائج ملموسة ، تسرع عملية التطوير كثيرا ، وتتجاوز بها الحاضر بعشرات السنين أحيانا . ومع التمويل الاضافي استجابة لمتطلبات الحرب الباردة ، فإن هذه التقنيات الجديدة غيرت وجه الاقتصاد العالمي في مدة لم تتعد جيلا واحدا.
إن الحاجة إلى القاذفات القادرة على حمل القذائف الثقيلة لمسافات طويلة قد أحدثت قفزة كمية في تصاميم هياكل الطائرات وتقنيات صناعتها. وبعد الحرب طبقت ذلك سريعا في مجال الاستخدامات المدنية وانخفضت أسعار النقل الجوي إلى مستويات أدت إلى ارتفاع الطلب عليه بمعدلات هائلة. وبعد دمج هيكل الطائرات الكبيرة بالمحرك النفاث الذي ساعد على بلوغ سرعة الصوت ، والرادار الذي أتاح التحديد الدقيق لمواقع الطائرات قرب المطارات من خلال الرقابة على الحركة الجوية ، أصبحت الطائرة الوسيلة المهيمنة لنقل الركاب لمسافات بعيدة.
وفي غضون عقد من ظهور طائرة بوينج 707 في العام 1958 ، شارفت باخرة الركاب الأطلسية وقطار المسافات البعيدة على الزوال وصار العالم قرية صغيرة. فالرحلة التي كانت تستغرق ثلاثة أيام بين نيويورك ولوس أنجلوس صارت تقطع الآن بخمس ساعات. ولم تعد الرحلة بين نيويورك ولندن تستغرق سوى سبع ساعات بعد أنت كانت تحتاج إلى أسبوع تقريبا.
لقد طور الألمان الصاروخ العملاق - القادر على حمل شحنات كبيرة لمئات الأميال - وأتم هذا الصاروخ بالصاروخ الموجه "في تو" بزنة أربعين طنا ، وكان قادرا على ايصال رأس حربي يزن طنا واحدا إلى هدف على بعد مائتي ميل. وبدأت صواريخ "في تو" تضرب بريطانيا في أواخر القام 1944 ، لكن استعمالاتها في الحرب جاءت متأخرة جدا فلم تغير من نتيجة الحرب. كانت الغاية من تلك الصواريخ أن تكون سلاح ردع ووسيلة للإفادة من الإمكانات التي يتيحها الفضاء الخارجي ، وهذا ما أشعل نار المنافسة في نهاية الحرب بين القوات الغربية والقوات السوفيتية لحماية ما تبقى من ترسانة الصواريخ وفرق العلماء الذين طوروا تلك الصواريخ.
وقد أنفق كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة موارد هائلة على بحوث الصواريخ لتطوير أسلحة أكبر حجما وأبعد مدى وأكثر دقة. وفي نهاية الخمسينيات غير الصاروح المزود بالقنبلة الهيدروجينية - وهي تقنية ظهرت زمن الحرب العالمية الثانية - من طبيعة الحرب . إن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات - القادرة على تدمير مدن بأكملها آنيا - قد جعلت الحرب بين القوى العظمى خيارا طائشا لأن الكل خاسر لا محالة في هذه الحرب. لذلك كان على الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي - وقد علقا في شرك صراع جيوسياسي مستحكم - اللجوء إلى أساليب بديلة في الصراع.
وأثارت الصواريخ الباليستية العابرة للقارة أيضا مخاوف عظيمة من فرص خورج الأحداث على السيطرة ، كما حصل عشية الحرب العالمية الأولى ، وتحويل العالم إلى أثر بعد عين في "محرقة نووية". وقد أوشك ذلك على الوقوع في حادثتين: أزمة الصواريخ الكوبية العام 1962 وحرب يوم الغفران في العام 1973.
ومن الخيارات التي كانت مطروحة أمام الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في صراع التفوق والهيمنة (الحروب بالوكالة) كتلك التي اندلعت في كوريا وفيتنام وأفغانستان. وثمة خيار آخر تمثل في استخدام الصواريخ في ريادة الفضاء الخارجي. وقد أذهل الاتحاد السوفيتي العالم في 4 اكتوبر 1957 بإطلاق أول قمر يدور حول الأرض (سبوتنيك) (كان الغرض منه دعائيا صرفا ، ذلك أن إشارته اللاسلكية ، التي كانت مسموعة في جميع أنحاء العالم ، ولم تنقل أي معلومات ، وإنما عملت كدليل لاسلكي للطائرات . ومع ذلك فقد كانت دعاية سياسية ناجعة جدا أدت الغرض المطلوب منها). وأطلقت الولايات المتحدة - على الفور - قمرها الصناعي ، ثم ألحقت به مئات الأقمار الصناعية الأخرى. وهكذا اندلع "سباقتسلح" كسبته الولايات المتحدة في العام 1969 بهبوط رجالها على سطح القمر.
ووظف كثير من هذه الأقمار الصناعية لأغراض عسكرية - كالتجسس - لكن عددا منها أيضا خصص لغايات مدنية وعسكرية معا - كالاتصالات وجمع المعلومات عن حالة الطقس. لقد أصبحت الأقمار الصناعية "الجغرافية المتزامنة" في عقد الستينيات قادرة على بث الصور التلفزية التي يمكن لكل الناس ، حيثما كنوا ، التقاطها لحظة بثها إذا توافرت لديهم الأجهزة اللازمة. وهكذا أصبحت القرية العالمية - وأول من استخدم لفظها الفيلسوف مارشال ماكلوهان في العام 1960 - حلما واقعا ، وكانت قد بدأت تتجسد على أرض الواقع بعد مد الكيبل الأطلسي قبل مائة عام تقريبا.
ولم تكن تحصى التطبيقات الاقتصادية لتكنولوجيا الفضاء ، خصوصا منذ نهاية الحرب الباردة عندما رفع عن عدد منها غطاء التكتم والسرية ، كما لم تكن تلك التطبيقات إلا في ازدياد يوما بعد يوم. وليست الزراعة النقل ورسم الخرائط والملاحة والاتصالات إلا غيضا من فيض. لقد أتاحت أقمار تحديد المواقع الجغرافية التعرف على المواقع في قطر لا يتجاوز بضع أقدام بفضل أداة بسيطة باتت تستخدم اليوم في كثير من السيارات في تحديد الاتجاهات باستخدام الأصوات المركبة، وهي تقنية كانت ترى بعين الإعجاز الخارق قبل نحو عقدين من الزمان.
لقد ساعدت كثيرا أقمار الاتصالات - إلى جانت العدد المتنامي أبدا من الكيبلات تحت البحر - على تخفيض تكلفة الاتصالات الهاتفية البعدية ، مما أحدث طفرة عجيبة في الإقبال عليها . ففي العام 150 أجريت نحو مليون مكالمة هاتفية عبر الكيبلات البحرية في الولايات المتحدة . وفي العام 1970 ارتفع عدد المكالمات إلى ثلاثة وعشرين مليونا وفي العام 1980 بلغ مائتي مليون. أما في العام 2001 وبفضل التراجع الحاد في أسعارها ، فقد وصل عدد تلك المكالمات إلى 6.3 مليار ولايزال العدد يتنامى بمعدلات سريعة.
إن الهبوط الكبير في تكلفة الاتصالات الدولية قد أتاح للأسواق المالية في العالم تحقيق المزيد من إمكانات التكامل والعمل كسوق واحدة تنساب عبرها المعلومات بيسر وسلاسة ، سوق مشرعة الأبواب 24 ساعة في اليوم. وكما ربط السعاة الصغار ذات يوم سوق نيويورك المالية مندفعين جيئة وذهابا بين البورصة والمصارف وبيتوتات السمسرة لإخطارها جميعا بآخر الأسعار ، فقد ربطت شبكة الكيبلات تحت الأرض ووصلات الأقمار الصناعية الأسواق المالية الجديدة.
لقد جلب ذلك أثارا سياسية واقتصادية عميقة. ففي العام 1980 كانت ثمة سوق موحدة لتداول عملات العالم الرئيسية ، وقد بلغ حجم هذه التجارة آنذاك تريليوم دولار في اليوم بالمتوسط. وفي العام 1981 انتخب الفرنسيون حكومة اشتراكية برئاسة فرانسوا ميتران الذي سعى إلى تطبيق برنامج اشتراكي تقليدي (سيرا على سابقاته) ، برفع الضرائب على الدخول الكبيرة وتأميم بعض قطاعات الاقتصاد الفرنسي ومنها قطاع المصارف . ولم يمض وقت طويل حتى هبط سعر الفرنج الفرنسي في أسواق العملات ، وظل يتراجع إلى أن اضطرت الحكومة الفرنسية إلى تعديل منهجها. كانت لحظة حاسة في تاريخ العالم. فلأول مرة يتسنى للسوق الحرة إملاء سياستها على قوة عظمة. وكما كانت الحال حين أصبحت الصحف وسيلة إعلام جماهيرية في منتصف القرن التاسع عشر ، فقد ظهر على المسرح لاعب جديد مؤثر في لعبة السياسة المحلية والعالمية. وقد أدركت حكومات العالم أن معيار الذهب القديم - الذي طبقته مؤسسة شبه حكومية هي مصرف إنجلترا - قد أبدل بمعيار جديد: معيار سوق العملات الدولية. كان هذا المعيار أكثر مرونة ودقة و"ديموقراطية" من المعيار السابق. وهكذا لم يعد التضخم - وكان الهم الاقتصادي الأول في السنوات الخمس والعشرين السابقة - مطروحات على قائمة المشاغل المالية التي تورق العالم.
ليست ثمة تقنية انبثقت عن الحرب العالمية الثانية تضاهي الحاسب الآلي في خلق هوة بين الماضي والحاضر. ولقد استخدماتت كلمة "الحاسب" في اللغة الانجليزية منذ منتصف القرن السابع عشر. كلنها ظلت تعني حتى منتصف القرن العشرين "ممتهن عملية الحساب" ، الذي يجمع البيانات من قبيل جداول التأمين الاكتواري وجدوال الملاحة (كان معظم أولئك من النسوة ، وقد اعتبرن أفضل من يؤدي هذه الأعمال). ومع ذلك يظل البشر قاصرين في عملية الحساب من ناحيتين ، إذ لا يمكن للإنسان إجارء أكثر من عملية حسابية واحدة كل مرة ، كما أنه يرتكب أخطاء حسابية . لقد حسب عالم رياضيات يدعى ويليام شانكس في منتصف القرن التاسع عشر العدد الأصم (باي) بدقة بلغ بها 707 أرقام بعد الفاصلة ، وكان ذلك مأثرة فكرية خارقة. ولن ينتبه أحد إلى أن علام الرياضيات هذا قد ارتكب خطأ عند العدد رقم 527 بعد الفاصلة - وأن الرقم المائة والثمانين من حسابه كانت غير صحيحة - إلا بعد مرور أكثر من مائة عام.
إن فكرة الحساب بالآلة قديمة جدا. ذلك أن انجليزيا اسمه تشارلز بابدج - وقد أحبط من تصحيح الجداول الفلكية في عشرينيات القرن العشرين - كان "يتمنى من الله لو أن هذه الحسابات قد أنجزت بالإفادة من قوة البخار". ومن ثم شرع في صناعة آلة حاسبة تعمل بحركة اليد ، مكونة من أجزاء نحاسية دقيقة الصنعة ، لكنه لم ينته من صنعها. كما صمم آلة تحليلة كانت النواة الميكانيكية لحاسب حقيقي ، ذلك أنها كانت قابلة للبرمجة . هذه الآلة أيضا لم تر النور.
ومع توسع الحكومات والمشاريع وتحولها إلى الاعتماد كثيرا على الاحصاءات والأرقام ، صارت الحاجة إلى تسريع معالجة البيانات ماسة جدا . لقد استغرق تعداد سكان الولايات المتحدة الام 1880 - وقد فرغ يديوا - سبع سنوات من العمل الفكري المرهق . ولتسهيل إجراء التعداد السكاني اللاحق ، ابتكر مهندس منجمي وإحصائي شاب اسمه هيرمان هوليرث طريقة تعتمد على نول جاكارد الذي ظهر في القرن الثامن عشر ، والذي أتاح للألة حياكة تطاريز بالغة التعقيد. وقد استخدمت آلة هوليرث بطاقات تثقيب ذات تجاويف. فعندما تمر الإبرة في التجويف ، كانت تصل دارة إلكتروينة بانغماسها في دورق بالغ الصغر مملوء بالزئبه ، وكان ثمة عداد يدور إلى الأعملى مسجلة الحركة.
كانت آلة هوليرث قادرة على تبويب البيانات على بطاقات التثقيب بمعدل ألف بطاقة في الساعة ، وجرت معالجة البطاقات الاثنتين والستين مليونات - التي جمعت في إحصاء العام 1890 - في ستة أشهر فقط (ومن سوء الطالع أن حريقا شب في العام 1921 دمر قاعدة بيانات إحصاء العام 1890 ، وعلى الرغم من أن الأرقام الإجمالية ظلت معروفة ، فإن البيانات التفصيلية لم يعد لها أثر). وأسس هيوليرث شركة اندمجت في عدد من الشركات الأخرى ، وفي العام 1924 غيرت إسمها إلى شركة إنترناشيونال بيزنس ماشين IBM.
ولأن ثمة حاجة إلى حساب مسارات قذائف المدفعية - بسرعة - وفك الشيفرات ، فقد أنفقت الحكومتان الأمريكية والبريطانية كثيرا على تطوير حاسب إلتكروني حقيقي في زمن الحرب العالمية الثانية. وقد أطلق على أول حاسب عام - أصاب نجاحا - اسم إينياك (اختصار لتسمية المكامل والحاسب الرقمي الإلكتروني) حيث فرغ من بنائه بريسبر إيكيرت وجون موشلي من جامعة بنسلفانيا في العام 1946 ، بعد جهود دامت ثلاث سنوات.
لقد كان هذا الحاسب جهازا عملاقات ، بحجم حافلة. وقد شغل حيزا يكفي لأربعين خزانة أضابير كل منها بارتفاع تسع أقدام ، مزودا بثمانية عشر ألف صمام مفرغ وأسلاك بطول آلاف الأميال. لقد استهلكت الصمامات المفرغة ونظام التبريد كهرباء تعادل ما تحتاج إليه بلدة صغيرة ، وكانت - بمعايير هذه الأيام - بطيئة جدا. كانت البرمجة تتم من خلال ربط الأسلاك يدويا في شبكات تشبه لوحة المفاتيح الكهربائية. وكان لابد من أن يشرف عليها دائما مراقبون لاستبدال الصمامات المفرغة عند إنفجارها وإزالة الحشرات الزائغة التي كانت تعلق بها (ومن هنا جاءت كملة معالجة الأخطاء ومعناها الحرف "إزالة الحشرات).
وبدأت تتقلص أحكام الحواسب وتراجعت كلفتها سريعا ، خصوصا بعد العام 147 عندما طورت شركة ويسترن إلكتريك - الذراع التصنيعية في شركة الهاتف والبرق الأمريكي اي تي أند تي - الترانزيستور (المحور). ويؤدي المحور عمل الصمامات المفرغة بحذافيره ، لكنه أصغر حجما وأطول عمرا. وأقل تكلفة سواء في التصنيع أو التشغيل.وفي عقد الستنيات لجأت المصارف وشركات التأمين والهيئات الحكومية ولاشركات الكبرى إلى الاعتماد على الحواسب في إنجاز أعمال كانت تستدعي مئات آلاف الموظفين ، وبجزء بسيط من التكفة. وهيمنت "أي بي إم" على هذه السوق بعد أن طرحت آلات من قبيل حواسب 7090 في العام 1957.
إن قدرة الحاسب لا تحدد فقط بعدد المحورات ، وإنما بعدد الروابط بينها أيضا. فإذا كان لدينا محوران فإن ثمة حاجة إلى رابطة واحدة. وتتطلب ثلاثة محورات ثلاث روابط لوصلها بالكامل. أما أربعة محورات فتستدعي ست روابط. ويحتاج خمسة عشر محورا إلى عشر روابط. أما ستة محورات فتتطلب خمسة عشر رابطة ، وعلم جرا. وفي وقت كان لابد فيه من إنجاز هذه الروابط يدويا فإن تكلفة بناء حواسب أكثر قدرة تصاعدت بمعدلات تجاوزت معدلات الزيادة في القدرة الحاسبية.
وكان حل هذه المشكلة يتمثل في الدائرة المتكاملة التي ابتكرها جاك كيلبي في العام 1959 من شركة تكساس إنسترومنت وروبرت نويس من شركة فيرتشايلد سميكوندكتر. والدائرة المتكاملة ما هي إلا سلسلة من المحورات المترابطة بينيا والمثبة آليا على صفيحة رقيقة من السليكون. بتعبير آخر ، تصنع المحورات وتنجز الروابط الواصلة بينها في الوقت نفسه. وفي العام 1971 أنتجت شركة إنتل أول معالج صغري وطرحته في الأسواق ، وهو ليس سوى حاسب بالغ الصغر مثبت على رقاقة سليكونية.
وهكذا تحطم إستبداد الأرقام ، صحيح أن تكلفة تصميم المعالج الصغري وصناعة الأجهزة اللازمة لإنتاجه مرتفعة جدا ، لكنه وبمجرد الاستثمار فيه يمكن إنتاج المعالجات الصغرية نفسها على غرار ما تنج كثير من السلع الإلكترونية عالية التقنية. مما يقلل التكلفة الحدية للمعالج مع زيادة الإنتاج. وحققت تلك المعالجات مستويات مطردة من التعقيد وارتفعت قدرتها الحاسبية وسرعتها.
لقد تنبأ جوردون مور مؤسس شركة إنتل في الأيام الأولى للشركة أن عدد المحورات المثبته على الرقاقة الإلكترونية - وبالتالي القدرة الحاسبية للرقاقة - سيتضاعف كل ثمانية عشر شهرا. وبالتالي القدرة الحاسبية للرقاقة - سيتضاعف كل ثمانية عشر شهرا أيضا. وقد ثبت صواب نظريته. وسيظل قانون مور - كما بات يسمى - ساريا في المستقبل المنظور. كان أول معالج صغري أنتجته إنتل مكونا من 2300 محور. وفي بنتيوم فور - وهو المعيار الحالي للحواسب الشخصية - ثمة 24 مليونا. ومع ارتفاع قدرة الحاسب ، تراجعت تكلفة القدرة الحاسبية. فالقدرة الحاسبية التي كانت تكلف ألف دولار في الخمسينيات بات تكلفتها لا تتجاوز جزءا من سنت في يومنا هذا. وهكذا بدأت استخدامها في الانتشار مع ارتفاع قدرتها الحاسبية ، ولم يبد هذا التعاظم في القدرة الحاسبية إلى الآن ما يشير إلى تراجعه.
لقد فجر الحاسب - كما فعل المحرك البخاري - ثورة اقتصادية وللسبب ذاته تماا . فقد حطم أسعار المدخلات الأساسية في النظام الاقتصادي حيث أتاح استخدام تلك المدخلات في عدد لا حصر له من الأعمال التي كانت في الماضي باهظة التكلفة أو متعذرة الأداء. وقد خفض المحرك البخاري سعر الطاقة اللازمة للتشغيل ، أما الحاسب فقد حد من تكلفة تخزين المعلومات واسترجاعها معالجتها.
كان أداء هذا الشكل من الأعمال - في السابق - محصورا في البشر ، أما الآن فيمكن الاعتماد على الآلة في إنجازه بزمن أقل ودقة أكبر وتكلفة لا تذكر. وكما تسنى في المحرك البخاري توظيف طاقة هائلة في أداء عمل بعينه ، فقد أمكن بفضل الحاسب حشد طاقة لا نهائية - إذا جاز القول - لتنفيذ العمليات الحسابية ومعالجة المعلومات. وثمة تقدير يرى أن نموذج الحاسب في أول عهده - في الثمانينيات - أجرى عمليات حسابية فاقت ما أجراه الجنس البشري على مر التاريخ إنتهاء بالعام 1940.
وبدأت الحواسب تغزو الحياة اليومية بوقع عجيب . فقد استغرق ظهور مصطلح "الثورة الصناعية" أكثر من ستين عاما منذ ظهور المحرك البخاري الدوار الذي ابتكره واط. لكن بالمقابل كان جليا أن ثورة الحاسب كانت على أشدها بعد أقل من عقد واحد من إنتاج أول معالج صغري. وكانت أول المنتجات التجارية تلك الآلات الحاسبة الكفية التي دفع ظهورها بآلة الجمع ومسطرة الحساب إلى زوايا النسيان. وبدأت برامج معالجة النصوص تحتل مكان الآلة الكاتبة في منتصف السبعينيات. كما بدأت استخدام المعالجات الصغيرة - غير المرئية - في السيارات وأجهزة الطبخ والتلفاز وساعات اليد والمئات من أصناف الأجهزة المنزلية. كما أنها باتت لا غنى عنها في كثير من المنتجات الأخرى - كالهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية وأجهزة الدي في دي وقارئات الأقراص المضغوطة ومسجلات الفيديو والمصورات (الكاميرات) الرقمية والمساعدات الرقمية الشخصية. وفي التسعينيات دخلت كل مفاصل الحياة اليومية. فالعالم المعاصر يتوقف عن الحركة في ثوان لو أن المعالجات الصغرية جميعا توقفت عن العمل.
لكن - في وقت باتت فيه الحواسب أصغر حجما وأرخص ثمنا إلى درجة كبيرة - لا يزال استخدام المرء لها أمرا عسيرا من دون التدرب عليها. وفي مطلع السبعينيات طورت شركة زيروكس - في مركز بحوثها بباولو ألتو - وسائل عدة لتسهيل إستخدام غير المتخصصين للحاسب ، وكان منها فأرة الحاسب وواجهة الاستخدام الرسومية. لكن زيروكس عجزت عن تحويل هذه الأفكار الجديدة إلى منتج قابل للتسويق. ومع ذلك فإن ستيفن جوبز وستيفن وزنياك - وهما مؤسسا شركة أبل للحاسب - نجحا في ذلك. فعندما دخلت شركة أي بي إم سوق الحاسب في العام 1981 باستخدام نظام تشغيل أنتجته ميكروسوفت بدأت سوق الحواسب الشخصية بالرواج وظلت تتوسع بمعدلات هائلة منذ ذلك الحين بفضل التراجع العظيم في الأسعار.
واليوم لدى عشرات الملايين من الأطفال والكبار على مكاتبهم وطاولاتهم "قدرة حاسبية" - لا يكفون عن استخدامها - لم تكن في متناول أحد سوى الحكومات الوطنية قبل ثلاثين عاما خلت. لقد جبلت أدمغتهم المتكيفة مع استعمال الحاسب في رفد ملكاتهم الفكرية الخاصة . كما بات في طوع بنانهم أعظم آلة على الإطلاق انتجها كائن ذو ميل فطري دائم إلى استخدام الآلة.
وللحاسب الشخصي أيضا القدرة على لعب الشطرنج - أو أي لعبة أخرى - والتفوق على البشر فيها ، باستثناء أستاذة اللعبة الكبار طبعا ، وإمساك الدفاتر وتخزين كميات هائلة من البيانات واسترجاعها وتحرير الصور وإنتاج الأقراض المضغوطة وعرض الأفلام وإنتاج الأعمال الفنية ، وآلاف الأعمال الأخرى. إن كل من عاصر السنوات السابقة للثلث الأخير من القرن العشرين لن يرى في الحاسب الشخصي - الذي لاتتجاوز تكلفته 5 في المائة من الدخل السنوي الوسطي - إلا ضربا من السحر أو "حيلة استعراضية".
لكن الحواسب الشخصية لا تزال قادرة على أداء المزيد. فهي قادرة على الاتصال. ذلك أنها باتت نقطة انطلاق إلى زاوية جديدة كلية - لكنها تشغل حيزا كبيرا - من عالم الإنسان آلا وهي الشبكة الدولية (الانترنت). فكما تبين أن السكة الحديد كانت أبرز التقنيات التي انبثقت عن تقنية المحرك البخاري ، كذلك كانت الشبكة الدولية بالنسبة إلى الحاسب. ومرة أخرى ، فإن الحرب أو إحتمال نشوبها هما سببب ظهور الشبكة الدولية إلى حيز الوجود والإمكان.
فبعد إطلاق قمر سبوتنيك في العام 1957 أنشأت وزارة الدفاع وكالة مشاريع البحوث المتقدمة ARPA
لتنظيم المشاريع العلمية والتقنية ذات التطبيقات العسكرية وتنسيق عملها. وفي العام 162 طلب إلى بول باران من شركة راند إقتراح وسائل يمكن من خلالها الحفاظ على أنظمة التحكم والسيطرة بعد التعرض لهجوم نووي. كانت شبكات الإتصال حتى ذلك الحين تتبع أحد شكلين: الشبكات المركزية التي تجري الإتصالات فيها عبر مفرع مركزي ، والشبكات غير المركزية التي تضم عددا من المفرعات عبر شبكات فرعية. لقد أسست شبكات البرق والهاتف على هذا المنوال ، فكانت لوحات المفاتيح الكهربائية تؤدي دور المفرعات.
ولم تكن هاتان الشبكاتان قادرتين إطلاقا على مقاومة الهجوم النووي. ولم يزد هذا فقط من فرص فشل النظام ، بل زاد من احتمال لجوء أحد أطراق النزاع إلى المبادرة بالهجوم خوفا من ألا يكون قادرا على الرد بعد تعرضه للهجوم.
واقترح باران إنشاء "شبكة موزعة" من دون مفرعات مركزية ، على أن يكون لها عدد غير محدود من العقد المشابهة لتقاطعات الطرق في شبكة الشوارع. فإن حدذ أن دمرت عقدة أو أكثر ، يظل الاتصال قائمة عبر الطرق الأخرى. لقد أست شبكة حاسبية باتت تعرف باربانيت ARPANET
في العام 1968. وذلك بربطها بأربعة حواسب عبر خطوط الهاتف ، ثلاثة منها في كاليفورنيا وواحد في جامعة أوتاه.
وفي العام 1972 وضع أول نموذج لبرنامج البريد الالكتروني . وفي العام التالي وضع بروتوكول حمل اسم "بروتوكول التحكم بالإرسال/بروتوكول الانترنت" لمساعدة شتى أنظمة الحاسب - حتلى تلك التي تعمل بلغات مختلفة - على الاتصال بسهولة عبر الشبكة - التي كانت تضم آنذاك 23 حاسبا متصلة بها. أحد مصممي هذا البروتوكول واسمه فينتوت سيرف ابتكر مصطلح الانترنت في العام التالي. ذلك أن هذه الشبكة لم تعد تربط الحواسب الشخصية إنما الشبكات الفرعية التي تعمل عليها الحواسب أيضا. وفي العام 1983 - وكان ثمة حينها 562 حاسب على الشبكة - طورت جامعة ويسكونسن نظام اسم النطاق
Domain Name system
- الذي سهل كثيرا على الحواسيب التعارف عبر الشبكة. وكان عددها يزداد بمعدل الضعف سنويا.
لكن تلك الشبكة ظلت تستخدم أساس لربط الوكالات الحكومية والجامعات ومؤسسات بحوث الشركات. ومن ثم - وفي العام 1992 - حرر تيم بيرنيرز لي - وهو انجليزي يعمل لدى المجلس الاوروبي للبحوث النووية "سيرن" - "ونشر من دون مطالبة بحقوق ملكية أول متصفح للإنترنت ، وهو برنامج أتاح الوصول إلى كثير من المواقع المصمة لذلك والاتصال بها ، وهكذا ولدت الشبكة العنكبوتية الدولية WWW . وأدرك الناس والمؤسسات على الفور الفرص الكامنة وراء هذه الوسيلة الجديدة في الاتصال والاعلان عن المنتجات وبيعها. وفي عام 1994 عندما كان عدد مستخدمي الانترنت لا يتجاوز أربعة ملايين بدأت بيت البيتزا Pizza hut بيع البيتزا عبر موقعه على الانرنت.
وارتفع استخدام الانترنت كثيرا في منتصف التسعينيات واليوم بعد قرابة عقد من الزمان يربط هذا النظام ملايين الحواسب حول العالم. إنه أقوى وسائل الاتصال التي عرفها العالم على الاطلاق. وهكذا أطلقت الشبكة الدولية عمليات إعادة هيكلة شاملة في كثير من مشاريع الأعمال.
لقد بدأت كل المشاريع التي تزاول أعمال الوساطة - أي الجمع بين المشتري والبائع والحصول على نسبة بسيطة من صفقات البيع والشراء المبرمة - مثل المكاتب العقارية ووكالات السفر وسماسرة الأسهم والتأمين وصالات المزاد. تلمس تغيرا في طبيعة عملها ، وبعضها راح يرى زوال أعماله كلية. إن الانترنت - خصوصا بعد ظهور محركات البحث من مثل جوجل - تسهل كثيرا على المشترين والبائعين الاوصل بعضهم إلى بعض دون وسيط.
وبدأت شركات تجارة التجزئة أيضا تزيد مبيعاتها عبر الانترنت إذ باتت تسلم الطلبيات إلى كل أنحاء العالم وإلى الدول الأخرى. وكان التسليم يتم غالبا في اليوم الثاني بفضل خدمات البريد السريع مثل فيديكس ويو بي اس. لقد حققت مبيعات التجزئة عبر الشبكة الدولية - بسبب رخصها بفضل انخفاض تكاليفها غير المباشرة وانعدام ضريبة المبيعات - نموا بمعدل يتجاوز 20 في المائة سنويات على مدى السنوات السبع الماضية. إن موقع أمازون دوت كوم ، وهو رائد متاجر التجزئة على الشبكة الدولية ، يحوز حصة قدرها 10 في المائة من سوق تجارة الكتب بالتجزئة في الولايات المتحدة ، وهو يتوسع سريعا إلى مناطق أخرى.
كما أن وسائل الإعلام الجديدة تشهد تحولات جذرية بسبب الانترنت. لقد ارتفعت تكاليف دخول قطاع الإعلام كثيرا بعد ظهور وسائل الإعلام الجماهيري في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. فقد أسس جيمس جوردون بينيت صحيفة "هيرالد نيويورك" برأسمال لم تتعد 500 دولار فقط. أما صحيفة "نيويورك تايمز" التي أسست بعد ستة عشر عاما تلت فقد احتاج تأسيسها إلى 85 ألف دولار من رأس المال. كما أن محطات الإذاعة والتلفاز كانت تتطلب رؤوس أموال ضخمة (ورخصة حكومية) لكي تصل إلى الجمهور.
لكن الإنترنت أتاح لكل من يملك حاسبا شخصيا وموقعا عليه ولوج قطاع الإعلام. وهذا ما فعله الآلاف من الناس. وفي العام 1998 حقق مات دردج سبقا صحفيا في نشر واحدة من أ÷م الروايات الاخبارية في عقد التسعينيات وهي فضيحة مونيكا لوينسكي.وانتشرت مدونات الشبكة - وتعرف بالمدونات اختصارا. أما محرروها فيسمون بالمدونين - بعشرات الآلاف حينما شرع الناس يدلون بآرائهم من خلال هذه الوسيلة الإعلامية الجديدة. واستقطبت المدونات الناجحة أعدادا كبيرة من القراء وراحت تكتسب سريعا نفوذا فعليا. لقد كان أثر الانترنت يتجسد في تحقيق ديموقراطية وسائل الإعلام عبر إتاح الفرصة لسماع المزيد من الآراء والأصوات.
ولأن الانترنت لا تحتاج نظريا إلى بنية تحتية غير تلك القائمة أصلا ، فقد طورت نفسها ذاتيا من دون مساعدة حكومية تذكر ودونما حاجة إلى تدخل الحكومة أو توجيهها. وحالما وقف هذا الكيان الأقدر تواصلا واتصالا مع العالم على وسيلة الاتصال الفعالة والرخيصة حديثة النشأة انكبالناس باختلاف أعراقهم وأجناسهم على الإفادة بها. إن الدول ذات النخب الحاكمة التي عولت كثيرا على الرقابة اللصيقة للجماهير وآلية وصلها إلى المعلومات - في سبيل الحفاظ على سلطتها - رأت سلطتها تذوى أحيانا وتتلاشى أحيانا كلها.
لقد أصبح الحاسب وأهم نتاجاته - الإنترنت - أقوى الأسلحة في مقارعة الاستبداد منذ ولادة مفهموم الحرية الإنسانية.
صحيح أن الحرب كانت الرحم الذي أنجب الحاسب ، لكن الحاسب غير جذريا من طبيعة الحروب. ففي العصر الصناعي كان كسب الحرب يتوقف - أكثر من أي شيء آخر - على الطرف الذي ينجح في حشد اكبر عدد من المقاتلين المزودين بأكبر عدد من البنادق والسفن والطائرات. لقد تغلبت الكثرة على الشجاعة أو الكم على الكيف آنذاك. إذ اعتمد الاتحاد السوفيتي - وكان عاجزا عن مجاراة الغرب في التطور التكنولوجي - على هذه الحقيقة وعلى قدرات أجهزة استخباراته الواسعة في سرقة التكنولوجيا الغربية ، للحفاظ على مكانته كقوة عظمى وعلى قدرته على مواصلة الحرب الباردة.
لكن ، وبفضل التوجيه بالحاسب ، صارت القنابل أكثر قدرة على بلوغ الهدف ، مما زاد كثيرا من دقتها وقلل كثيرا من فتكها بالمدنيين حتى في الأحياء الحضرية المكتظة بالسكان . وقد غيرت الرادرات المتطورة بفضل المعلاجات الصغرية من طبيعة المعارك الجوية. ففي العام 1982 استطاع الطيران الاسرائيلي إرسال طائرة من دون طيار تحاكي الطائرات المقاتلة للهجوم على مواقع الرادرات السورية في سهل البقاع اللبناني. وعندما شغلت الرادرات لتعثب الطائرة ، زحفت الطائرات الحربية الحقيقية فحددت بدقة مصدر إشارة الرادرات ودمرتها. وبعد أن حيدت رادرات إدارة المعركة التي أمدها السوفييت بها ، خسرت القوة الجوية السورية موجهها فأسقط الإسرائيليون 96 طائرة سورية - سوفيتية الصنع أيضا - من دون أن يخسروا طائرة واحدة.
ومع التطور السريع في علم الالكترونيات لم تستطع الدولة السوفيتية مواكبة واقع التطور أو حتى - سرقة أفكار الغرب بالسرعة الكافية لمجاراته . وكانت الاأفضلية العسكرية التي أكسبها إياها جيشها العرعرم والأساطيل الجرارة من السفن والدبابات والطائرات تتراجع سريعا. وعندما بدأت الولايات المتحدة تزود الأفغان بصواريخ ستينتجر المضادة للطائرات والمحمولة باليد انتهى تفوق السوفييت الجوي والعسكري في أراضي أفغانستان الوعرة ، وصار كسب الحرب هناك متعذرا. وتحولت حرب أفغانستان إلى ما يشبه فيتنام الاتحاد السوفيتي ، ووجدت الحكومة السوفيتية نفسها عاجزة عن إخفاء الحقيقة عن شعبها.
واقتنيص رونالد ريجان الفرصة ودفع عبر الكونجرس ببرنامج إعادة تسلح هائل ، يقضي بزيادة نفقات الدفاع بنسبة 50 في المائة بالأرقام الحقيقية في السنوات لاست الأولى من فترة رئاسته. كما أعلن أيضا تطوير نظام دفاع صاروخي فضائي عرف باسم "حرب النجوم". وسيكلف هذا البرنامج مليارات الدولارات لكنه كان أيضا سيحيد القوة النووية الروسية لو تم اللجوء إليها. وقامر ريجان - وكان محقا - بأن السوفييت لن يستطيعوا المجازفة بعمل يكون مصيره الفشل.
لقد قرر الرئيس بحزم استخدام أقوى أسلحة الأمة - وهو الاقتصاد الأمريكي - لكسب الحرب الباردة ، كما استخدمه من قبله روزفلت لكسب الحرب العالمية الثانية . واستطاعت الولايات المتحدة تأمين متطلبات هذه النفقات الباهظة ، أما الاتحاد السوفيتي فقد ثبت عجزه عن ذلك. إذ كان اقتصاده - الذي دبت فيه الديموقراطية وغاب عنه مفهوم السوق ، واستشرى فيه الفساد - في وضع أسوأ كثيرا مما قدرت الاستخبارات الأمريكية.
لقد شلت الحكومة السوفيتية هرمية السلطة في مطلع الثمانينيات بوفاة ثلاثة أمناء عامين للحزب الشيوعي في فترة وجيزة. لكن ميخائيل جورباتشوف ، عندما تبوأ السلطة في العام 1985 ، حاول التفاوض مع الولايات المتحدة تقليص إنفاق الاتحاد السوفيتي العسكري ، وتخفيف الضوابط ولاقيود عن كاهل الاقتصاد السوفيتي والمجتمع بما يضمن زيادة انتاجية البلاد ويسمح باستخدام الطاقات الجديدة التي توافرت بفضل المعالج الصغري.
لكن ما إن شعر الشعب بزوال قبضة الاستبداد حتى فقدت الحكومة السوفيتية سريعا السيطرة على مجريات الأمور. إذ إنهارت أولاالحكومات الدائرة في الفلك السوفيتي في اوروبا الشرقية ، ثم تداعي الاتحاد السوفيتي نفسه إلى الإنهيار. وأعلنت الجمهوريات غير السوفيتية استقلالها وانتهى الاتحاد السوفيتي في العام 1991 عندما تكسرت "الطرقة والمنجل" المرفوعة على الكرملين وارتفع مكانها علم روسيا القديمة.
لقد تبين أن الاتحاد السوفيتي - الذي قدم نفسه للعالم بكيانه الكامل على أنه نموذج المستقبل ، وهو ادعاء آمن به ، ولنقل اليوم بمعيانة رجعية للأحداث ، كثير من المفكرين الغربيين (الأنتلجنسيا) - لم يكن إلا تلك الإمبراطورية الروسية التليدة ، آخر إمبراطورية على سطح المعمورة كان قوامها القوة العسكرية. وهكذا انطوى فصل آخر صراعات القوى العظمى في القرن العشرين ، وكان صراعات عالميا كالحربين العالميتين الأولى والثانية ، بعد ما يقرب من خمسين عاما.
وظهرت الولايات المتحدة الآن وحدها أقوى بلدان العالم من دون منازاع ، ومن دونت منافس في الأجل المنظور. لكن الولايات المتحدة وحلفائها لم يكونوا المنتصر الأوحد في الحرب الباردة. لقد انتصرت الرأسمالية والديموقراطية أيضا ، وثبت في المقابل فشل الاشتراكية - بكل أشكالها وصورها - بوصفها نظاما اقتصاديا . إذ عجزت عن مجرد إنتاج السلع والخدمات التي توافرت للولايات المتحدة والدول الرأسمالية الأخرى والتي راحت وسائل الاتصال الجديدة تعرضها على مرأة العالم.
وهكذا زال ما كان يعرف بالعالم الثاني - أو الكتلة الشيوعية - مع نهاية الحرب الباردة مخلفا عالما من الدول العصرية المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان، والدول التي كانت تحقق قفزات سريعة في طريق التقدم والحداثة ونموا سريعا أيضا مثل كوريا الجنوبية وتايوان والصين الام والهند والبرزايل. أو ما جرت العادة على تسميته بالعالم الثالث أو الدول التي كانت لا تزال في حاجة إلى أن تلقي عنها الأساليب القديمة من مركزية لاسلطة ، والاقتصادات التي تحكمها الأقليات كشأن العالم العربي وكثير من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا ، ودول مثل رواندا وهاييتي وليبريا التي كانت بؤرا للفقر والاضطرابات.
ومع أن الكونجرس كان يؤيد تمويل بناء الترسانة العسكرية بناء على اقتراح ريجان ، لكنه لم يحبذ إقرار التخفيضات المقترحة في برامج الضمان الاجتماعي المحلية. وبالتالي: تصاعد العجز الفدرالية السنوي إلى مستويات مرتفعة. وقد تزياد - كما كانت الحال في فترة السبيعينات - بأكثر من ثلاثة أضعاف بالأسعار الجارية من 900 مليارات دولار في العام 1980 إلى 2.2 تريليون دولار في العام 1990. ولأن التضخم الجامح الذي عرفته السبعينيات قد تم كبحه فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي - وهو بالمقياس الحقيقي للدين القومي - قد ارتفعت بسعرة. ومع أنه لم يتجاوز 34.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 1980 فقد بلغ 58.15 في العام 1990 وكان يرتفع بمعدلات سريعة. ولأول مرة في التاريخ الأمريكي يرتفع الدين القومي في زمن السلم بهذه المعدلات.
إن الاقتصاد الأمريكي - الذي حقق نموا قويا في الثمانينيات بحيث أضاف طاقة انتاجية تعادل الطاقة الانتجاية لاقتصاد ألمانيا الغربية كله - وكان أكبر اقتصادات اوروبا - إلى طاقته الحالية ، قد بدأ يتراجع مباشرة عقب نهاية رئاسة ريجان في العام 1989. لكن الدين القومي المتصاعد لم يتراجع مع ذلك. فبلغ في العام 1994 مستوى 4.6 ترليون دولار ، أي ما يعادل 68.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع العولمة والقوة العظمى الوحيدة: ع1990-أواخر ع2000
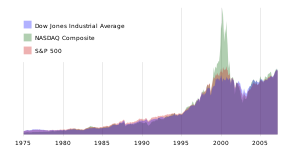
كان ركود العام 1990 - 1991 الاخف وطأة في القرن العشرين ، وبدأت الاقتصاد ينمو مجددا - ون كان على نحو متقطع في بادئ الأمر - ومن ثم بلغ مستويات مرتفعة مع ظهور ثمار الانترنت والتطبيقات غير المحدودة للمعالك الصغري. وارتفع الدين القومي - الذي لم يشهد أي تراجع - بمعدلات بطيئة جدا ، ويعود ذلك - من جملة الأسباب - إلى مبيعات موجودات مؤسسات الإدخار والتسليف المفلسة التي استحوذت الإيرادات الضريبية التي تجاوزت معدلاتها ميل الكونجرس الكبير نحو الإنفاق . وفي العام 1988 حققت الميزانية التشغيلية الفدرالية فائضا للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما وظلت كذلك على مدى السنوات الثلاث اللاحقة.
كان وجه القصور الوحيد في الاقتصاد الأمريكي هو الميزان التجاري الخاسر، الذي تفاقهم عجزه بشدة خلال تلك الفترة. لكن ذلك ان يعزى أساسا ليس إلى ضعف الاقتصاد الامريكي ، بل إلى ذعف الاقتصادات الاجنبية. لقد بلغ اقتصاد اليابان - الذي كان ذات يوم ضربا للمثل - ذروةه في العام 1989. ثم غرق في ركود مزمن سيخرج منه كرة أخرى بعد حين ، كما هبط مؤشر سوق الأسهم الرئيسي فيها إلى ثلاثة أرباع أعلى مستوى وصل إليه. كما أن اوروبا - وهي المركز الاقتصادي الرئيسي الثاني في العالم - لم تكن تحقق نموا يقارب على الإطلاق ذاك الذي حققته الولايات المتحدة ، كما ظلت معدلات البطالة في كثير من دولها فوق مستوى 10 في المائة من دون أن تبدو في الأفق أي نزعة للإنخفاض.
وحقق وول ستريت رواجا غير مسبوق. إذ بينما ارتفع مؤئر داو جونز الصناعي ثلاثة أضعاف في الثمانينيات ، فقد حقق ارتفاعا قارب ثمانية أضعاف في التسعينيات ، فبلغ 11 نقطة مع نهاية العقد. أما مؤشر نازداك - الذي تغلب عليه أسهم الشركات التقنية - فحقق أداء أفضل.
فبعد أن كان دون 500 نقطة في العام 1990 فإنه ارتفع إلى 5700 نقطة في مطلع العام 2000 ، وكانت أواخر التسعينيات في الولايات المتحدة أعظم فترات بناء الثروات في التاريخ الامريكي. فالأرقام تفوق الخيال . إذ إنه في العام 1988 كان أغنى رجل في الولايات المتحدة هو سام والتون ، وله من العمر سبعون عاما ، وهو مؤسس شركة وال خمارت سلسلة متاجر التجزئرة التي كانت آنذاك ثالثة كبرى الشركات في الولايات المتحدة . كان سر نجاحه يكمن في استخدمان الحاسب في حساب المخزون والرقابة عليه وخفض تكاليف التشغيل. وقدرت ثروته في ذلك العام بنحو 6.7 مليارات دولار.
أما ثروة بيل جيتس - مؤسس شركة مايكروسوفت وله من العمر 33 عاما - فلم تتجاوز 1.1 مليار دولار ، وكان واحدة من أربعة وأربعين ثريا أمريكيا ممن تجازوت ثروة كل منهم مليار دولار. في ذلك العام كانت ثروة بقيمة 225 مليون دولار كفيلة بإظهار صاحبها على قائمة فوربس 400 (أما في 1982 ، أول عام نشرت فيه هذه القائمة ، فكانت 92 مليون دولار كافية لذلك).
وفي العام 2000 كان حد الثروة الأدنى الذي يكفل أن يدرج إسم صاحبها في قائمة فوربس 725 مليون دولار ، أما الثروة الوسطية في هذه القائمة فكانت 3 مليارات دولار ، حيث تجوزت ثروة ثلاثة أرباع المدرجين في القائمة مليون دولار للشخص الواحد ، أما اليوم فبات بيل جيتس أغنى الأغنياء بثروة تقدر بنحو 63 مليار دولار ، أي عشرة أضعاف أغنى الأمريكيين قبل اثنتي عشرة عاما. أما ثروة والتون التي آلت إلى ورثة سام والتون فقد وصلت إلى فقد وصلت إلى 85 مليار دولار . وأصبحت "والت مارت" كبرى سلاسل التجزئة في العام ، حيث تمتلك أربعة آلاف متجر وتحقق مبيعات سنوية تصل إلى 165 مليار دولار ، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لبولندا ، التي يبلغ تعداد سكانها نحو أربعين مليونا.
وكما كان شأن الاقتصاد الأمريكي دائما ، كان معظم الإنياء من العصاميين ، وأن 263 من أصل 400 من أغنى أغنياء أمريكا في العام 2000 - أي ثلثي القائمة - إنما صنعوا ثرواتهم الشخصية من الصفر. لقد ورث 19 في المائة من الشخصيات المدرجة في قائمة فوربس لعام 2000 ثروات كانوا أهلا لها.
إن الارتفاع الهائل في أسواق الأسهم في أواخر التسعينيات كان ولاريب سينتهي بعملية تصحيح ، وبدأت الفقاعة تنفجر في مارس 2000 ، لكن ذلك لم يترافق مع إنيهار السوق ، بل على العكس ، فقد تراجعت المؤشرات - أحيانا بحدة ، وأحيانا بإعتدال - مع أن كثيرا من الأسهم خصوصا تلك التي طرت للتداول مع نهاية سوق الصعود الكبير فقدت كثيرا من قيمتها. ولم يكن ثمة داع للاعتقاد أن شيئا خارجا على المألوف سيقع عندما يجرى تصحيح كبير في سوق الأسهم بالتزامن مع فترة ركود طبيعية جدا.
وهكذا وفي صباح الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، وكان يوما شاعريا جميلا من أيام أواخر الخريف ، ضربت طائرة مخطوفة البرج الشمالي لمركز التجارة الاعالمي في نيويورك . وبعد دقائق معدودات ارتطمت طائرة أخرى بالبرج الجنوبي. وانهار المبنيات في أقل من ساعتين ، وقتل بذلك آلاف الأبرياء. لقتد انتشرتس سحابة كثيفة من الدخان والغبار في شوارع كبرى مدن البلاد وقطاعها المالي ، حيث القلب النابض للرأسمالية العالمية على مدى أجيال ثلاثة. لقد شكل ذلك هجوما مباشرا على العاصمة المالية لإمبراطورية الثروة.
طائرة ثالثة ضربة البنتاجون رمز القوة العسكرية الأمريكية وتحطمت الرابعة في حقل في بنسلفانيا ، حينما ضحى ركابها بأراوحهم ليحولوا دون سقوطها في مكان آخر. وللمرة الأولى منذ واقعة بيرل هاربور هوجمت الولايات المتحدة في عقر دارها. ولأول مرة منذ أن نزلت القوات البريطانية في لويزيانا في ديسمبر 1814 تتعرض الأرض الأمريكية للهجوم.
وللمرة الرابعة في أقل من قرن أعلنت الولايات المتحدة الحرب على قوى رأت فيها عائقا أمام مدها العصري ، المتمثل أساسا في الديموقراطية والرأسمالية. لكن هذا الهجوم لم يأت هذه المرة من "أمة - دول" وإنما من زمرة من المهووسين الذين بيتوا مكيدتهم في الخفاء . كان هذا العدو أضعف كثيرا بكل المقاييس الجيوسياسية المعروفة من أعداء الحروب السابقة ، لكنها كان أيضا عدوا لابد - إذا ما أريد تدميره وشل قدرته على الهجوم - من حشد مزيد من الجهود. ولم يدر بخلد أحد أن الحرب ستكون محدودة أو خاطفة أو قليلة التكلفة.
لكن الجميع - باستثناء ربما بعض أعدائها الذين أعمت الأيدولوجية أبصارهم - كانوا يؤمنون بأن الولايات المتحدة ستخرج منتصرة من صراعها الجديد. وكما ورد عن سيسيرو في آخر أيام الجمهورية الرومانية قبل ألفي عام: "إن عصب الحرب مال لا ينفد" ، كان الاقتصاد الأمريكي مع بزوع فجر القرن الحادي والعشرين قد بات أكثر قدرة على إمتلاك "عصب الحرب" ، لا يضاهيه في ذلك أي اقتصاد عرفه العالم من قبل.
الكساد الكبير

إحصائيات تاريخية
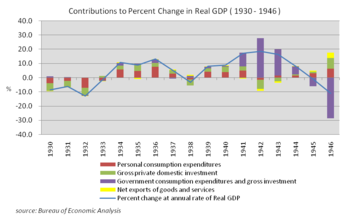
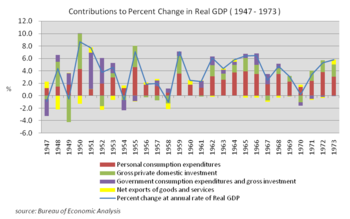
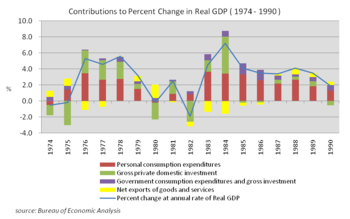
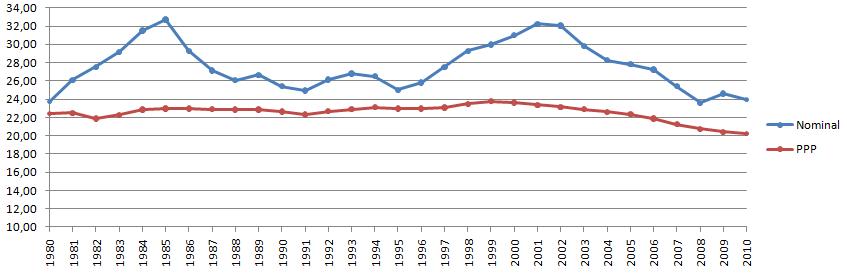
US share of world GDP (nominal) peaked in 1985 with 32.74% of global GDP (nominal). The second highest share was 32.24% in 2001.
US share of world GDP (PPP) peaked in 1999 with 23.78% of global GDP (PPP). The share has been declining each year since then.
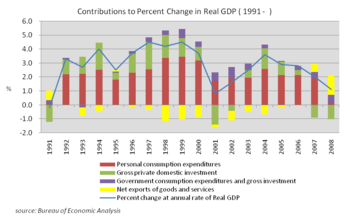
|
United States Annual Economic Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انظر أيضاً
- Great Depression in the United States
- Labor unions in the United States
- List of regions by past GDP (PPP)
- Productivity improving technologies (historical)
- Second industrial revolution
الهامش
- ^ based on data in Susan Carter, ed. Historical Statistics of the US: Millennial Edition (2006) series Ca9
- ^ Source GNP: U.S. Dept of Commerce, National Income and Product Accounts [1]; Mitchell 446, 449, 451; Money supply M2 [2]
- ^ GDP (nominal and adjusted) figures from 1929 to present are from the
Bureau of Economic Analysis.
Figures for before 1929 have been reconstructed by Johnston and Williamson based on various sources and are less reliable. See http://www.measuringworth.org/usgdp/ for more information about sources and methods.
Current-dollar and real GDP. United States Bureau of Economic Analysis. Dec 20, 2007
Louis D. Johnston and Samuel H. Williamson, "The Annual Real and Nominal GDP for the United States, 1790 – present." Economic History Services, July 27, 2007, URL : http://eh.net/hmit/gdp/
Inflation-adjusted figures are for base year 2000